
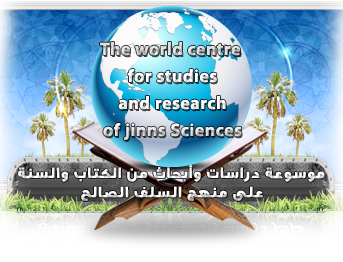

| المكتــــــبة العــــــــــــــامة ( Public Library ) للكتب والأبحاث العلمية |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |

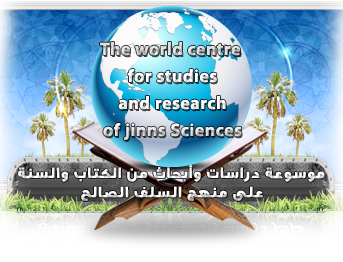

| المكتــــــبة العــــــــــــــامة ( Public Library ) للكتب والأبحاث العلمية |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#41 |
|
وسام الشرف
       |
القـرآن )وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهاً وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) (البقرة:25) التفسير:.{ 25 } مناسبة الآية لما قبلها أن الله لما ذكر وعيد الكافرين المكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم ذكر وعد المؤمنين به، فقال تعالى: { وبشر... } الآية؛ و "البشارة" هي الإخبار بما يسر؛ وسميت بذلك لتغير بَشَرة المخاطَب بالسرور؛ لأن الإنسان إذا أُخبر بما يُسِرُّه استنار وجهه، وطابت نفسه، وانشرح صدره؛ وقد تستعمل "البشارة" في الإخبار بما يسوء، كقوله تعالى: { فبشرهم بعذاب أليم } [آل عمران: 21] : إمَّا تهكماً بهم؛ وإما لأنهم يحصل لهم من الإخبار بهذا ما تتغير به بشرتهم، وتَسودَّ به وجوههم، وتُظلِم، كقوله تعالى في عذابهم يوم القيامة: {ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم * ذق إنك أنت العزيز الكريم} [الدخان: 48، 49] .. والخطاب في قوله تعالى: { بشِّر } إما للرسول صلى الله عليه وسلم؛ أو لكل من يتوجه إليه الخطاب . يعني بشِّر أيها النبي؛ أو بشِّر أيها المخاطَب من اتصفوا بهذه الصفات بأن لهم جنات.. قوله تعالى: { الذين آمنوا } أي بما يجب الإيمان به مما أخبر الله به، ورسوله؛ وقد بيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم أصول الإيمان بأنها الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، والقدر خيره وشره؛ لكن ليس الإيمان بهذه الأشياء مجرد التصديق بها؛ بل لا بد من قبول، وإذعان؛ وإلا لما صح الإيمان.. قوله تعالى: { وعملوا الصالحات } أي عملوا الأعمال الصالحات . وهي الصادرة عن محبة، وتعظيم لله عزّ وجلّ المتضمنة للإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله؛ فما لا إخلاص فيه فهو فاسد؛ لقول الله تعالى في الحديث القدسي: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه"(71) ؛ وما لم يكن على الاتِّباع فهو مردود لا يقبل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم (: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد(72)" .. قوله تعالى: { أن لهم جنات }: هذا المبشر به: أن لهم عند الله عزّ وجلّ { جنات... }: جمع "جنَّة"؛ وهي في اللغة: البستان كثير الأشجار بحيث تغطي الأشجار أرضه، فتجتن بها؛ والمراد بها شرعاً: الدار التي أعدها الله للمتقين، فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.. قوله تعالى: { تجري من تحتها الأنهار } أي تسيح من تحتها الأنهار؛ و{ الأنهار } فاعل { تجري }؛ و{ من تحتها } قال العلماء: من تحت أشجارها، وقصورها؛ وليس من تحت سطحها؛ لأن جريانها من تحت سطحها لا فائدة منه؛ وما أحسن جري هذه الأنهار إذا كانت من تحت الأشجار، والقصور! يجد الإنسان فيها لذة في المنظر قبل أن يتناولها.. وقد بيّن الله تعالى أنها أربعة أنواع، كما قال تعالى: {مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفَّى} (محمد: 15) . قوله تعالى: { كلما رزقوا } أي أعطوا؛ { منها} أي من الجنات؛ {من ثمرة} أي من أيّ ثمرة؛ { قالوا هذا الذي رزقنا من قبل } لأنه يشبه ما سبقه في حجمه، ولونه، وملمسه، وغير ذلك من صفاته؛ فيظنون أنه هو الأول؛ ولكنه يختلف عنه في الطعم والمذاق اختلافاً عظيماً؛ ولهذا قال تعالى: { وأتوا به متشابهاً }؛ وما أجمل وألذّ للإنسان إذا رأى هذه الفاكهة يراها وكأنها شيء واحد؛ فإذا ذاقها وإذا الطعم يختلف اختلافاً عظيماً! تجده يجد في نفسه حركةً لهذا الفاكهة، ولذةً، وتعجباً؛ كيف يكون هذا الاختلاف المتباين العظيم والشكل واحد! ولهذا لو قُدم لك فاكهة ألوانها سواء، وأحجامها سواء، وملمسها سواء، ثم إذا ذقتها وإذا هذه حلو خالص، وهذه مُز . أي حلو مقرون بالحموضة . وهذه حامضة؛ تجد لذة أكثر مما لو كانت على حد سواء، أو كانت مختلفة.. قوله تعالى: { وأتوا به متشابهاً }؛ { أتوا } من "أتى" التي بمعنى جاء؛ فالمعنى: جيء إليهم به متشابهاً يشبه بعضه بعضاً . كما سبق.. قوله تعالى: { ولهم فيها أزواج }؛ لما ذكر الله الفاكهة ذكر الأزواج؛ لأن في كل منهما تفكهاً، لكن كل واحد من نوع غير الآخر: هذا تفكه في المذاق، والمطعم؛ وهذا تفكه آخر من نوع ثان؛ لأن بذلك يتم النعيم؛ و{ أزواج } جمع زوج؛ وهو شامل للأزواج من الحور، ومن نساء الدنيا؛ ويطلق "الزوج" على الذكر، والأنثى؛ ولهذا يقال للرجل: "زوج"، وللمرأة: "زوج"؛ لكن في اصطلاح الفرضيين صاروا يلحقون التاء للأنثى فرقاً بينها وبين الرجل عند قسمة الميراث.. قوله تعالى: { مطهرة } يشمل طهارة الظاهر، والباطن؛ فهي مطهرة من الأذى القذر: لا بول، ولا غائط، ولا حيض، ولا نفاس، ولا استحاضة، ولا عرق، ولا بخر، مطهرة من كل شيء ظاهر حسي؛ مطهرة أيضاً من الأقذار الباطنة، كالغل، والحقد، والكراهية، والبغضاء، وغير ذلك..
|


|
|
|
#42 |
|
وسام الشرف
       |
قوله تعالى: { هم فيها خالدون } أي ماكثون لا يخرجون منها..
الفوائد: .1 من فوائد الآية: مشروعية تبشير الإنسان بما يسر؛ لقوله تعالى: {وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات}؛ ولقول الله تبارك وتعالى: {وبشرناه بإسحاق نبيًّا من الصالحين} [الصافات: 112] ، وقوله تعالى: {وبشروه بغلام عليم} [الذاريات: 28] ، وقوله تعالى: {فبشرناه بغلام حليم} [الصافات: 101] ؛ فالبشارة بما يسر الإنسان من سنن المرسلين . عليهم الصلاة والسلام؛ وهل من ذلك أن تبشره بمواسم العبادة، كما لو أدرك رمضان، فقلت: هنّاك الله بهذا الشهر؟ الجواب: نعم؛ وكذلك أيضاً لو أتم الصوم، فقلت: هنّأك الله بهذا العيد، وتقبل منك عبادتك وما أشبه ذلك؛ فإنه لا بأس به، وقد كان من عادة السلف.. .2 ومن فوائد الآية: أن الجنات لا تكون إلا لمن جمع هذين: الإيمان، والعمل الصالح.. فإن قال قائل: في القرآن الكريم ما يدل على أن الأوصاف أربعة: الإيمان؛ والعمل الصالح؛ والتواصي بالحق؛ والتواصي بالصبر؟ فالجواب: أن التواصي بالحق، والتواصي بالصبر من العمل الصالح، لكن أحياناً يُذكر بعض أفراد العام لعلة من العلل، وسبب من الأسباب.. .3 ومنها: أن جزاء المؤمنين العاملين للصالحات أكبر بكثير مما عملوا، وأعظم؛ لأنهم مهما آمنوا، وعملوا فالعمر محدود، وينتهي؛ لكن الجزاء لا ينتهي أبداً؛ هم مخلدون فيه أبد الآباد؛ كذلك أيضاً الأعمال التي يقدمونها قد يشوبها كسل؛ قد يشوبها تعب؛ قد يشوبها أشياء تنقصها، لكن إذا منّ الله عليه، فدخل الجنة فالنعيم كامل.. .4 ومنها: أن الجنات أنواع؛ لقوله تعالى: { جنات }؛ وقد دل على ذلك القرآن، والسنة؛ فقال الله تعالى: {ولمن خاف مقام ربه جنتان} [الرحمن: 46] ، ثم قال تعالى: {ومن دونهما جنتان} [الرحمن: 62] ؛ وقال النبي صلى الله عليه وسلم "جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما؛ وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما(73)" .. .5 ومنها: تمام قدرة الله عزّ وجلّ بخلق هذه الأنهار بغير سبب معلوم، بخلاف أنهار الدنيا؛ لأن أنهار الماء في الدنيا معروفة أسبابها؛ وليس في الدنيا أنهار من لبن، ولا من عسل، ولا من خمر؛ وقد جاء في الأثر(74) أنها أنهار تجري من غير أخدود . يعني لم يحفر لها حفر، ولا يقام لها أعضاد تمنعها؛ بل النهر يجري، ويتصرف فيه الإنسان بما شاء . يوجهه حيث شاء؛ قال ابن القيم رحمه الله في النونية:. (أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان) 6 . ومن فوائد الآية: أن من تمام نعيم أهل الجنة أنهم يؤتون بالرزق متشابهاً؛ وكلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا: هذا الذي رُزقنا من قبل؛ وهذا من تمام النعيم، والتلذذ بما يأكلون.. .7 ومنها: إثبات الأزواج في الآخرة، وأنه من كمال النعيم؛ وعلى هذا يكون جماع، ولكن بدون الأذى الذي يحصل بجماع نساء الدنيا؛ ولهذا ليس في الجنة مَنِيّ، ولا مَنِيَّة؛ والمنيّ الذي خلق في الدنيا إنما خُلق لبقاء النسل؛ لأن هذا المنيّ مشتمل على المادة التي يتكون منها الجنين، فيخرج بإذن الله تعالى ولداً؛ لكن في الآخرة لا يحتاجون إلى ذلك؛ لأنه لا حاجة لبقاء النسل؛ إذ إن الموجودين سوف يبقون أبد الآبدين لا يفنى منهم أحد؛ ثم هم ليسوا بحاجة إلى أحد يعينهم، ويخدمهم؛ الوِلدان تطوف عليهم بأكواب، وأباريق، وكأس من معين؛ ثم هم لا يحتاجون إلى أحد يصعد الشجرة ليجني ثمارها؛ بل الأمر فيها كما قال الله تعالى: {وجنى الجنتين دان} [الرحمن: 54] ، وقال تعالى: {قطوفها دانية} [الحاقة: 23] ؛ حتى ذكر العلماء أن الرجل ينظر إلى الثمرة في الشجرة، فيحسّ أنه يشتهيها، فيدنو منه الغصن حتى يأخذها؛ ولا تستغرب هذا؛ فنحن في الدنيا نشاهد أن الشيء يدنو من الشيء بغير سلطة محسوسة؛ وما في الآخرة أبلغ، وأبلغ.. .8 ومن فوائد الآية: أن أهل الجنة خالدون فيها أبد الآباد؛ لا يمكن أن تفنى، ولا يمكن أن يفنى من فيها؛ وقد أجمع على ذلك أهل السنة والجماعة.. |


|
|
|
#43 |
|
وسام الشرف
       |
القـرآن )إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَاسِقِينَ) (البقرة:26) .{ 26 } قوله تعالى: { إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما } أي لا يمنعه الحياء من أن يضرب مثلاً ولو كان مثلاً حقيراً ما دام يثبت به الحق؛ فالعبرة بالغاية؛ و{ ما } يقولون: إنها نكرة واصفة . أي: مثلاً أيَّ مثل..التفسير: قوله تعالى: { بعوضة }: عطف بيان لـ{ ما } أي: مثلاً بعوضة؛ والبعوضة معروفة؛ ويضرب بها المثل في الحقارة؛ وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية أن المشركين اعترضوا: كيف يضرب الله المثل بالذباب في قوله تبارك وتعالى: {يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له} [الحج: 73] : قالوا: الذباب يذكره الله في مقام المحاجة! فبيَّن الله عزّ وجلّ أنه لا يستحيي من الحق حتى وإن ضرب المثل بالبعوضة، فما فوقها.. قوله تعالى: { فما فوقها }: هل المراد بما فوق . أي فما فوقها في الحقارة، فيكون المعنى أدنى من البعوضة؛ أو فما فوقها في الارتفاع، فيكون المراد ما هو أعلى من البعوضة؟ فأيهما أعلى خلقة: الذباب، أو البعوضة؟ الجواب: الذباب أكبر، وأقوى . لا شك؛ لكن مع ذلك يمكن أن يكون معنى الآية: { فما فوقها } أي فما دونها؛ لأن الفوقية تكون للأدنى، وللأعلى، كما أن الوراء تكون للأمام، وللخلف، كما في قوله تعالى: {وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباً} [الكهف: 79] أي كان أمامهم.. قوله تعالى: { فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه } أي المثل الذي ضربه الله { الحق من ربهم }، ويؤمنون به، ويرون أن فيه آيات بينات.. قوله تعالى: { وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً } لأنه لم يتبين لهم الحق لإعراضهم عنه، وقد قال الله تعالى: {إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين * كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون} (المطففين: 13، 14 ).. وقوله تعالى: { ماذا }: "ما" هنا اسم استفهام مبتدأ؛ و "ذا" اسم موصول بمعنى "الذي" خبر المبتدأ . أي: ما الذي أراد الله بهذا مثلاً، كما قال ابن مالك:. (ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو مَن إذا لم تلغ في الكلام) قوله تعالى: { يضل به كثيراً }: الجملة استئنافية لبيان الحكمة من ضرب المثل بالشيء الحقير؛ ولهذا ينبغي الوقوف على قوله تعالى: { ماذا أراد الله بهذا مثلاً }؛ و{ يضل به } أي بالمثل؛ { كثيراً } أي من الناس؛ { ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين } أي الخارجين عن طاعة الله؛ والمراد هنا الخروج المطلق الذي هو الكفر؛ لأن الفسق قد يراد به الكفر؛ وقد يراد به ما دونه؛ ففي قوله تبارك وتعالى: { وأما الذين فسقوا فمأواهم النار } [السجدة: 20] : المراد به في هذه الآية الكفر؛ وكذلك هنا.. الفوائد: .1 من فوائد الآية: إثبات الحياء لله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ( إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلاً ما ). ووجه الدلالة: أن نفي الاستحياء عن الله في هذه الحال دليل على ثبوته فيما يقابلها؛ وقد جاء ذلك صريحاً في السنة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن ربكم حييّ كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صِفراً"(75) ؛ والحياء الثابت لله ليس كحياء المخلوق؛ لأن حياء المخلوق انكسار لما يَدْهَمُ الإنسان ويعجز عن مقاومته؛ فتجده ينكسر، ولا يتكلم، أو لا يفعل الشيء الذي يُستحيا منه؛ وهو صفة ضعف ونقص إذا حصل في غير محله.. .2 ومن فوائد الآية: أن الله تعالى يضرب الأمثال؛ لأن الأمثال أمور محسوسة يستدل بها على الأمور المعقولة؛ انظر إلى قوله تعالى: {مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً} [العنكبوت: 41] ؛ وهذا البيت لا يقيها من حَرّ، ولا برد، ولا مطر، ولا رياح {وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت} [العنكبوت: 41] ؛ وقال تعالى: {والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه} [الرعد: 14] : إنسان بسط كفيه إلى غدير مثلاً، أو نهر يريد أن يصل الماء إلى فمه! هذا لا يمكن؛ هؤلاء الذين يمدون أيديهم إلى الأصنام كالذي يمد يديه إلى النهر ليبلغ فاه؛ فالأمثال لا شك أنها تقرب المعاني إلى الإنسان إما لفهم المعنى؛ وإما لحكمتها، وبيان وجه هذا المثل.. .3 ومن فوائد الآية: أن البعوضة من أحقر المخلوقات؛ لقوله تعالى: { بعوضة فما فوقها }؛ ومع كونها من أحقر المخلوقات فإنها تقض مضاجع الجبابرة؛ وربما تهلك: لو سُلطت على الإنسان لأهلكته وهي هذه الحشرة الصغيرة المهينة.. .4 ومنها: رحمة الله تعالى بعباده حيث يقرر لهم المعاني المعقولة بضرب الأمثال المحسوسة لتتقرر المعاني في عقولهم.. .5 ومنها: أن القياس حجة؛ لأن كل مثل ضربه الله في القرآن، فهو دليل على ثبوت القياس.. |


|
|
|
#44 |
|
وسام الشرف
       |
6 . ومنها: فضيلة الإيمان، وأن المؤمن لا يمكن أن يعارض ما أنزل الله عزّ وجلّ بعقله؛ لقوله تعالى: {فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم}، ولا يعترضون، ولا يقولون: لِم؟، ولا: كيف؟؛ يقولون: سمعنا، وأطعنا، وصدقنا؛ لأنهم يؤمنون بأن الله عزّ وجلّ له الحكمة البالغة فيما شرع، وفيما قدر..
.7 ومنها: إثبات الربوبية الخاصة؛ لقوله تعالى: { من ربهم }؛ واعلم أن ربوبية الله تعالى تنقسم إلى قسمين: عامة؛ وخاصة؛ فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، وتقتضي التصرف المطلق في العباد؛ والخاصة هي التي تختص بمن أضيفت له، وتقتضي عناية خاصة؛ وقد اجتمعتا في قوله تعالى: {قالوا آمنا برب العالمين * رب موسى وهارون} [الأعراف: 121، 122] : فالأولى ربوبية عامة؛ والثانية خاصة بموسى، وهارون؛ كما أن مقابل ذلك "العبودية" تنقسم إلى عبودية عامة، كما في قوله تبارك وتعالى: {إن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً} [مريم: 93] ؛ وخاصة كما في قوله تعالى: {تبارك الذي نزل الفرقان على عبده} [الفرقان: 1] ؛ والفرق بينهما أن العامة هي الخضوع للأمر الكوني؛ والخاصة هي الخضوع للأمر الشرعي؛ وعلى هذا فالكافر عبد لله بالعبودية العامة؛ والمؤمن عبد لله بالعبودية العامة، والخاصة.. .8ومن فوائد الآية: أن ديدن الكافرين الاعتراض على حكم الله، وعلى حكمة الله؛ لقوله تعالى: { وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلًا }؛ وكل من اعترض ولو على جزء من الشريعة ففيه شبه بالكفار؛ فمثلاً لو قال قائل: لماذا ينتقض الوضوء بأكل لحم الإبل، ولا ينتقض بأكل لحم الخنزير إذا جاز أكله للضرورة مع أن الخنزير خبيث نجس؟ فالجواب: أن هذا اعتراض على حكم الله عزّ وجلّ؛ وهو دليل على نقص الإيمان؛ لأن لازم الإيمان التام التسليم التام لحكم الله عزّ وجلّ . إلا أن يقول ذلك على سبيل الاسترشاد، والاطلاع على الحكمة؛ فهذا لا بأس به.. .9 ومن فوائد الآية: أن لفظ الكثير لا يدل على الأكثر؛ لقوله تعالى: { يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً }؛ فلو أخذنا بظاهر الآية لكان الضالون، والمهتدون سواءً؛ وليس كذلك؛ لأن بني آدم تسعمائة وتسعة وتسعون من الألف ضالون؛ وواحد من الألف مهتدٍ؛ فكلمة: { كثيراً } لا تعني الأكثر؛ وعلى هذا لو قال إنسان: عندي لك دراهم كثيرة، وأعطاه ثلاثة لم يلزمه غيرها؛ لأن "كثير" يطلق على القليل، وعلى الأكثر.. .10 ومن فوائد الآية: أن إضلال من ضل ليس لمجرد المشيئة؛ بل لوجود العلة التي كانت سبباً في إضلال الله العبد؛ لقوله تعالى: { وما يضل به إلا الفاسقين }؛ وهذا كقوله تعالى: {فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين} (الصف: 5) .. .11 ومنها: الرد على القدرية الذين قالوا: إن العبد مستقل بعمله . لا علاقة لإرادة الله تعالى به؛ لقوله تعالى: ( وما يضل به إلا الفاسقين ).. |


|
|
|
#45 |
|
وسام الشرف
       |
القـرآن )الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) (البقرة:27) التفسير:.{ 27 } قوله تعالى: { الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه } أي العهد الذي بينهم وبين الله عزّ وجلّ؛ وهو الإيمان به، وبرسله؛ فإن هذا مأخوذ على كل إنسان؛ إذا جاء رسول بالآيات فإن الواجب على كل إنسان أن يؤمن به؛ فهؤلاء نقضوا عهد الله، ولم يؤمنوا به، وبرسله؛ والنقض حَلّ الشيء بعد إبرامه؛ وقد بين الله عزّ وجلّ هذا العهد في قوله تعالى: {ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل} [المائدة: 12] .. قوله تعالى: { ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل } أي يقطعون كل ما أمر الله به أن يوصل، كالأرحام، ونصرة الرسل، ونصرة الحق، والدفاع عن الحق.. قوله تعالى: { ويفسدون في الأرض } أي يسعون لما به فساد الأرض فساداً معنوياً كالمعاصي؛ وفساداً حسياً كتخريب الديار، وقتل الأنفس.. قوله تعالى: { أولئك هم الخاسرون }: جملة اسمية مؤكَّدة بضمير الفصل: { هم }؛ لأن ضمير الفصل له ثلاث فوائد؛ الفائدة الأولى: التوكيد؛ والفائدة الثانية : الحصر؛ والفائدة الثالثة: إزالة اللبس بين الصفة، والخبر؛ مثال ذلك: تقول: "زيد الفاضل": كلمة "الفاضل" يحتمل أن تكون خبراً؛ ويحتمل أن تكون وصفاً، فتقول: "زيد الفاضل محبوب"؛ إذا قلت: "زيد الفاضل محبوب" تعين أن تكون صفة؛ وإذا قلت: "زيد الفاضل" يحتمل أن تكون صفة، والخبر لم يأت بعد؛ ويحتمل أن تكون خبراً؛ فإذا قلت: "زيد هو الفاضل" تعين أن تكون خبراً لوجود ضمير الفصل؛ ولهذا سُمي ضمير فصل . لفصله بين الوصف والخبر؛ الفائدة الثانية: التوكيد ؛ إذا قلت: "زيد هو الفاضل" كان أبلغ من قولك: "زيد الفاضل"؛ و الفائدة الثالثة: الحصر ؛ فإنك إذا قلت: "زيد هو الفاضل" فقد حصرت هذا الوصف فيه دون غيره؛ وضمير الفصل ليس له محل من الإعراب، كما في قوله تعالى: {لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين} [الشعراء: 40] ؛ ولو كان له محل من الإعراب لكانت: "هم الغالبون"؛ وربما يضاف إليه اللام، كما في قوله تعالى: {إن هذا لهو القصص الحق} [آل عمران: 62] ؛ فيكون في إضافة اللام إليه زيادة توكيد.. وقوله تعالى: { الخاسرون }؛ "الخاسر" هو الذي فاته الربح؛ وذلك؛ لأن هؤلاء فاتهم الربح الذي ربحه من لم ينقض عهد الله من بعد ميثاقه، ولم يقطع ما أمر الله به أن يوصل.. الفوائد: .1 من فوائد الآية: أن نقض عهد الله من الفسق؛ لقوله تعالى: { الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه } فكلما رأيت شخصاً قد فرط في واجب، أو فعل محرماً فإن هذا نقض للعهد من بعد الميثاق.. .2 ومنها: التحذير من نقض عهد الله من بعد ميثاقه؛ لأن ذلك يكون سبباً للفسق.. .3 ومنها: التحذير من قطع ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام . أي الأقارب . وغيرهم؛ لأن الله ذكر ذلك في مقام الذم؛ وقطع الأرحام من كبائر الذنوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع"(76)، يعني قاطع رحم.. .4 ومنها: أن المعاصي والفسوق سبب للفساد في الأرض، كما قال تعالى: {ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون} [الروم: 41] ؛ ولهذا إذا قحط المطر، وأجدبت الأرض، ورجع الناس إلى ربهم، وأقاموا صلاة الاستسقاء، وتضرعوا إليه سبحانه وتعالى، وتابوا إليه، أغاثهم الله عزّ وجلّ؛ وقد قال نوح عليه السلام لقومه: {فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لهم أنهاراً} [نوح: 10 . 12] .. فإن قال قائل: أليس يوجد في الأرض من هم صلحاء قائمون بأمر الله مؤدون لحقوق عباد الله ومع ذلك نجد الفساد في الأرض؟ فالجواب: أن هذا الإيراد أوردته أم المؤمنين زينب رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: "ويل للعرب من شر قد اقترب" ؛ قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟! قال صلى الله عليه وسلم: "نعم، إذا كثر الخبث"(77) ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم "إذا كثر الخبث" يشمل معنيين:. أحدهما: أن يكثر الخبث في العاملين بحيث يكون عامة الناس على هذا الوصف.. و الثاني: أن يكثر فعل الخبث بأنواعه من فئة قليلة، لكن لا تقوم الفئة الصالحة بإنكاره؛ فمثلاً إذا كثر الكفار في أرض كان ذلك سبباً للشر، والبلاء؛ لأن الكفار نجس؛ فكثرتهم كثرة خبث؛ وإذا كثرت أفعال المعاصي كان ذلك سبباً أيضاً للشر، والبلاء؛ لأن المعاصي خبث.. .5ومن فوائد الآية: أن هؤلاء الذين اعترضوا على الله فيما ضرب من الأمثال، ونقضوا عهده، وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، وأفسدوا في الأرض هم الخاسرون . وإن ظنوا أنهم يحسنون صنعاً.. |


|
|
|
#46 |
|
وسام الشرف
       |
القـرآن )كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (البقرة:28) .{ 28 } قوله تعالى: { كيف تكفرون بالله... }: الاستفهام هنا للإنكار، والتعجيب؛ والكفر بالله هو الإنكار، والتكذيب مأخوذ من: كَفَر الشيء: إذا ستره؛ ومنه الكُفُرّى: لغلاف طلع النخل؛ والمعنى: كيف تجحدونه، وتكذبون به، وتستكبرون عن عبادته، وتنكرون البعث مع أنكم تعلمون نشأتكم؟!..التفسير: قوله تعالى: { وكنتم أمواتاً }: وذلك: قبل نفخ الروح في الإنسان هو ميت؛ جماد؛ { فأحياكم } أي بنفخ الروح؛ { ثم يميتكم } ثانية؛ وذلك بعد أن يخرج إلى الدنيا؛ { ثم يحييكم } الحياة الآخرة التي لا موت بعدها؛ { ثم إليه ترجعون }: بعد الإحياء الثاني ترجعون إلى الله، فينبئكم بأعمالكم، ويجازيكم عليها.. الفوائد: .1 من فوائد الآية: شدة الإنكار حتى يصل إلى حد التعجب ممن يكفر وهو يعلم حاله، ومآله.. .2 ومنها: أن الموت يطلق على ما لا روح فيه . وإن لم تسبقه حياة .؛ يعني: لا يشترط للوصف بالموت تقدم الحياة؛ لقوله تعالى: { كنتم أمواتاً فأحياكم }؛ أما ظن بعض الناس أنه لا يقال: "ميت" إلا لمن سبقت حياته؛ فهذا ليس بصحيح؛ بل إن الله تعالى أطلق وصف الموت على الجمادات؛ قال تعالى في الأصنام: {أموات غير أحياء} [النحل: 21] .. .3 ومنها: أن الجنين لو خرج قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه لا يثبت له حكم الحي؛ ولهذا لا يُغَسَّل، ولا يكفن، ولا يصلي عليه، ولا يرث، ولا يورث؛ لأنه ميت جماد لا يستحق شيئاً مما يستحقه الأحياء؛ وإنما يدفن في أيّ مكان في المقبرة، أو غيرها.. .4 ومنها: تمام قدرة الله عزّ وجلّ؛ فإن هذا الجسد الميت ينفخ الله فيه الروح، فيحيى، ويكون إنساناً يتحرك، ويتكلم، ويقوم، ويقعد، ويفعل ما أراد الله عزّ وجلّ.. .5 ومنها: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: { ثم يحييكم ثم إليه ترجعون }؛ والبعث أنكره من أنكره من الناس، واستبعده، وقال: {من يحيي العظام وهي رميم} [يس: 78] ؛ فأقام الله . تبارك وتعالى . على إمكان ذلك ثمانية أدلة في آخر سورة "يس":. الدليل الأول: قوله تعالى: {قل يحييها الذي أنشأها أول مرة} [يس: 79] : هذا دليل على أنه يمكن أن يحيي العظام وهي رميم؛ وقوله تعالى: {أنشأها أول مرة} دليل قاطع، وبرهان جليّ على إمكان إعادته كما قال الله تعالى: {وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه} [الروم: 27] .. الدليل الثاني: قوله تعالى: {وهو بكل خلق عليم} [يس: 79] يعني: كيف يعجز عن إعادتها وهو سبحانه وتعالى بكل خلق عليم: يعلم كيف يخلق الأشياء، وكيف يكونها؛ فلا يعجز عن إعادة الخلق.. الدليل الثالث: قوله تعالى: {الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً فإذا أنتم منه توقدون } [يس: 80] : الشجر الأخضر فيه البرودة، وفيه الرطوبة؛ والنار فيها الحرارة، واليبوسة؛ هذه النار الحارة اليابسة تخرج من شجر بارد رطب؛ وكان الناس فيما سبق يضربون أغصاناً من أشجار معينة بالزند؛ فإذا ضربوها انقدحت النار، ويكون عندهم شيء قابل للاشتعال بسرعة؛ ولهذا قال تعالى: {فإذا أنتم منه توقدون} [يس: 80] تحقيقاً لذلك.. ووجه الدلالة: أن القادر على إخراج النار الحارة اليابسة من الشجر الأخضر مع ما بينهما من تضاد قادر على إحياء العظام وهي رميم.. الدليل الرابع: قوله تعالى: {أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى} (يس: 81) ووجه الدلالة: أن خلْق السموات والأرض أكبر من خلق الناس؛ والقادر على الأكبر قادر على ما دونه.. الدليل الخامس: قوله تعالى: {وهو الخلَّاق العليم} [يس: 81] ؛ فـ {الخلاق } صفته، ووصفه الدائم؛ وإذا كان خلَّاقاً، ووصفه الدائم هو الخلق فلن يعجز عن إحياء العظام وهي رميم.. الدليل السادس: قوله تعالى: {إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون} [يس: 82] : إذا أراد شيئاً مهما كان؛ و {شيئاً} : نكرة في سياق الشرط، فتكون للعموم؛ {أمره} أي شأنه في ذلك أن يقول له كن فيكون؛ أو {أمره} الذي هو واحد "أوامر"؛ ويكون المعنى: إنما أمره أن يقول: "كن"، فيعيده مرة أخرى.. ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى لا يستعصي عليه شيء أراده.. الدليل السابع: قوله تعالى: {فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء} : كل شيء فهو مملوك لله عزّ وجلّ: الموجود يعدمه؛ والمعدوم يوجده؛ لأنه رب كل شيء.. ووجه الدلالة: أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه؛ وهذا يشمل تنزيهه عن العجز عن إحياء العظام وهي رميم الدليل الثامن: قوله تعالى: ( وإليه ترجعون ).. ووجه الدلالة: أنه ليس من الحكمة أن يخلق الله هذه الخليقة، ويأمرها، وينهاها، ويرسل إليها الرسل، ويحصل ما يحصل من القتال بين المؤمن، والكافر، ثم يكون الأمر هكذا يذهب سدًى؛ بل لابد من الرجوع؛ وهذا دليل عقلي.. فهذه ثمانية أدلة على قدرة الله على إحياء العظام وهي رميم جمعها الله عزّ وجلّ في موضع واحد؛ وهناك أدلة أخرى في مواضع كثيرة في القرآن؛ وكذلك في السنة.. .6ومن فوائد الآية: أن الخلق مآلهم، ورجوعهم إلى الله عزّ وجلّ.. |


|
|
|
#47 |
|
وسام الشرف
       |
القـرآن )هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (البقرة:29) التفسير:لما ذكر جلّ وعلا أنه قادر على الإحياء والإماتة، بيَّن منَّته على العباد بأنه خلق لهم ما في الأرض جميعاً .{ 29 } قوله تعالى: { هو الذي خلق لكم } أي أوجد عن علم وتقدير على ما اقتضته حكمته جلّ وعلا، وعلمه؛ و{ لكم }: اللام هنا لها معنيان؛ المعنى الأول: الإباحة، كما تقول: "أبحت لك"؛ والمعنى الثاني: التعليل: أي خلق لأجلكم.. قوله تعالى: { ما في الأرض جميعاً }؛ { ما } اسم موصول تعُمّ: كل ما في الأرض فهو مخلوق لنا من الأشجار، والزروع، والأنهار، والجبال... كل شيء.. قوله تعالى: { ثم } أي بعد أن خلق لنا ما في الأرض جميعاً { استوى إلى السماء } أي علا إلى السماء؛ هذا ما فسرها به ابن جرير . رحمه الله؛ وقيل: أي قصد إليها؛ وهذا ما اختاره ابن كثير . رحمه الله؛ فللعلماء في تفسير { استوى إلى } قولان: الأول: أن الاستواء هنا بمعنى القصد؛ وإذا كان القصد تاماً قيل: استوى؛ لأن الاستواء كله يدل على الكمال، كما قال تعالى: {ولما بلغ أشده واستوى} [القصص: 14] أي كمل؛ فمن نظر إلى أن هذا الفعل عُدّي بـ { إلى } قال: إن { استوى } هنا ضُمِّن معنى قصد؛ ومن نظر إلى أن الاستواء لا يكون إلا في علوّ جعل { إلى } بمعنى "على"؛ لكن هذا ضعيف؛ لأن الله تعالى لم يستوِ على السماء أبداً؛ وإنما استوى على العرش؛ فالصواب ما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله وهو أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، والإرادة الجازمة؛ و{ السماء } أي العلوّ؛ وكانت السماء دخاناً . أي مثل الدخان؛ { فسواهن سبع سموات } أي جعلها سوية طباقاً غير متناثرة قوية متينة.. قوله تعالى: { وهو بكل شيء عليم }؛ ومن علمه عزّ وجلّ أنه علم كيف يخلق هذه السماء.. الفوائد: .1 من فوائد الآية: منّة الله تعالى على عباده بأن خلق لهم ما في الأرض جميعاً؛ فكل شيء في الأرض فإنه لنا . والحمد لله . والعجب أن من الناس من سخر نفسه لما سخره الله له؛ فخدم الدنيا، ولم تخدمه؛ وصار أكبر همه الدنيا: جمع المال، وتحصيل الجاه، وما أشبه ذلك.. .2 ومنها: أن الأصل في كل ما في الأرض الحلّ . من أشجار، ومياه، وثمار، وحيوان، وغير ذلك؛ وهذه قاعدة عظيمة؛ وبناءً على هذا لو أن إنساناً أكل شيئاً من الأشجار، فقال له بعض الناس: "هذا حرام"؛ فالمحرِّم يطالَب بالدليل؛ ولو أن إنساناً وجد طائراً يطير، فرماه، وأصابه، ومات، وأكله، فقال له الآخر: "هذا حرام"؛ فالمحرِّم يطالب بالدليل؛ ولهذا لا يَحْرم شيء في الأرض إلا ما قام عليه الدليل.. .3 ومن فوائد الآية: تأكيد هذا العموم بقوله تعالى: { جميعاً } مع أن { ما } موصولة تفيد العموم؛ لكنه سبحانه وتعالى أكده حتى لا يتوهم واهم بأن شيئاً من أفراد هذا العموم قد خرج من الأصل.. .4 ومنها: إثبات الأفعال لله عزّ وجلّ . أي أنه يفعل ما يشاء؛ لقوله تعالى: { ثم استوى إلى السماء }: و{ استوى } فعل؛ فهو جلّ وعلا يفعل ما يشاء، ويقوم به من الأفعال ما لا يحصيه إلا الله، كما أنه يقوم به من الأقوال ما لا يحصيه إلا الله.. .5 ومنها: أن السموات سبع؛ لقوله تعالى: ( سبع سموات ) .6 ومنها: كمال خلق السموات؛ لقوله تعالى: ( فسواهن ).. .7ومنها: إثبات عموم علم الله؛ لقوله تعالى: ( وهو بكل شيء عليم ) .8ومنها: أن نشكر الله على هذه النعمة . وهي أنه تعالى خلق لنا ما في الأرض جميعاً؛ لأن الله لم يبينها لنا لمجرد الخبر؛ ولكن لنعرف نعمته بذلك، فنشكره عليها.. .9 ومنها: أن نخشى، ونخاف؛ لأن الله تعالى بكل شيء عليم؛ فإذا كان الله عليماً بكل شيء . حتى ما نخفي في صدورنا . أوجب لنا ذلك أن نحترس مما يغضب الله عزّ وجلّ سواء في أفعالنا، أو في أقوالنا، أو في ضمائر قلوبنا.. |


|
|
|
#48 |
|
وسام الشرف
       |
القـرآن )وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ) (البقرة:30) .{ 30 } قوله تعالى: { وإذ قال ربك }: قال المعربون: { إذ } مفعول لفعل محذوف؛ والتقدير: اذكر إذ قال؛ والخطاب في قوله تعالى: { ربك } للنبي صلى الله عليه وسلم؛ ولما كان الخطاب له صارت الربوبية هنا من أقسام الربوبية الخاصة.. قوله تعالى: { للملائكة }: اللام للتعدية . أي تعدية القول للمقول له؛ و "الملائكة" جمع "مَلْئَك"، وأصله "مألك"؛ لأنه مشتق من الأَلُوكة . وهي الرسالة؛ لكن صار فيها إعلال بالنقل . أي نقل حرف مكان حرف آخر؛ مثل أشياء أصلها: "شيئاء"؛ و "الملائكة" عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، وجعل لهم وظائف، وأعمالاً مختلفة؛ فمنهم الموكل بالوحي كجبريل؛ وبالقطر، والنبات كميكائيل؛ وبالنفخ في الصور كإسرافيل؛ وبأرواح بني أدم كملَك الموت... إلى غير ذلك من الوظائف، والأعمال.. قوله تعالى: { إني جاعل في الأرض خليفة }؛ خليفة يخلف الله؛ أو يخلف من سبقه؛ أو يخلف بعضهم بعضاً يتناسلون . على أقوال:. أما الأول: فيحتمل أن الله أراد من هذه الخليقة . آدم، وبنيه . أن يجعل منهم الخلفاء يخلفون الله تعالى في عباده بإبلاغ شريعته، والدعوة إليها، والحكم بين عباده؛ لا عن جهل بالله سبحانه وتعالى . وحاشاه من ذلك، ولا عن عجز؛ ولكنه يمنّ على من يشاء من عباده، كما قال تعالى: {يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس} [ص: 26] : هو خليفة يخلف الله عزّ وجلّ في الحكم بين عباده.. والثاني: أنهم يخلفون من سبقهم؛ لأن الأرض كانت معمورة قبل آدم؛ وعلى هذا الاحتمال تكون { خليفة } هنا بمعنى الفاعل؛ وعلى الأول بمعنى المفعول.. والثالث: أنه يخلف بعضهم بعضاً؛ بمعنى: أنهم يتناسلون: هذا يموت، وهذا يحيى؛ وعلى هذا التفسير تكون { خليفة } صالحة لاسم الفاعل، واسم المفعول.. كل هذا محتمل؛ وكل هذا واقع؛ لكن قول الملائكة: { أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء } يرجح أنهم خليفة لمن سبقهم، وأنه كان على الأرض مخلوقات قبل ذلك تسفك الدماء، وتفسد فيها، فسألت الملائكة ربها عزّ وجلّ: { أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء } كما فعل من قبلهم . واستفهام الملائكة للاستطلاع، والاستعلام، وليس للاعتراض؛ قال تعالى: { إني أعلم ما لا تعلمون } يعني: وستتغير الحال؛ ولا تكون كالتي سبقت.. قوله تعالى: { ونحن نسبح } أي نُنَزِّه؛ والذي يُنَزَّه الله عنه شيئان؛ أولاً: النقص؛ والثاني: النقص في كماله؛ وزد ثالثاً إن شئت: مماثلة المخلوقين؛ كل هذا يُنَزَّه الله عنه؛ النقص: مطلقاً؛ يعني أن كل صفة نقص لا يمكن أن يوصف الله بها أبداً . لا وصفاً دائماً، ولا خبراً؛ والنقص في كماله: فلا يمكن أن يكون في كماله نقص؛ قدرته: لا يمكن أن يعتريها عجز؛ قوته: لا يمكن أن يعتريها ضعف؛ علمه: لا يمكن أن يعتريه نسيان... وهلم جراً؛ ولهذا قال عزّ وجلّ: {ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب} [ق: 38] أي تعب، وإعياء؛ فهو عزّ وجلّ كامل الصفات لا يمكن أن يعتري كماله نقص؛ ومماثلة المخلوقين: هذه إن شئنا أفردناها بالذكر؛ لأن الله تعالى أفردها بالذكر، فقال: {ليس كمثله شيء} [الشورى: 11] . وقال تعالى: {وله المثل الأعلى} ، وقال تعالى: { فلا تضربوا لله الأمثال } [النحل: 74] ؛ وإن شئنا جعلناها داخلة في القسم الأول . النقص . لأن تمثيل الخالق بالمخلوق يعني النقص؛ بل المفاضلة بين الكامل والناقص تجعل الكامل ناقصاً، كما قال القائل:. (ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا) لو قلت: فلان عنده سيف أمضى من العصا تبين أن السيف هذا رديء، وليس بشيء؛ فربما نفرد هذا القسم الثالث، وربما ندخله في القسم الأول؛ على كل حال التسبيح ينبغي لنا . عندما نقول: "سبحان الله"، أو: "أسبح الله"، أو ما أشبه ذلك . أن نستحضر هذه المعاني.. قوله تعالى: و{ بحمدك }: قال العلماء: الباء هنا للمصاحبة . أي تسبيحاً مصحوباً بالحمد مقروناً به؛ فتكون الجملة متضمنة لتنزيه الله عن النقص، وإثبات الكمال لله بالحمد؛ لأن الحمد: وصف المحمود بالكمال محبة، وتعظيماً؛ فإن وصفتَ مرة أخرى بكمال فسَمِّه ثناءً؛ والدليل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: "قَسَمْتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ فإذ قال: {الحمد لله رب العالمين} قال تعالى: حمدني عبدي؛ وإذا قال: {الرحمن الرحيم} قال تعالى: أثنى عليّ عبدي"(78) ؛ لأن نفي النقص يكون قبل إثبات الكمال من أجل أن يَرِد الكمال على محل خالٍ من النقص.. |


|
|
|
#49 |
|
وسام الشرف
       |
قوله تعالى: { ونقدس }: "التقديس" معناه التطهير؛ وهو أمر زائد على "التنْزيه"؛ لأن "التنزيه" تبرئة، وتخلية؛ و"التطهير" أمر زائد؛ ولهذا نقول في دعاء الاستفتاح: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب؛ اللهم نقني من خطاياي كما ينقَّى الثوب الأبيض من الدنس؛ اللهم اغسلني من خطاياي بالماء، والثلج، والبَرد"(79) : فالأول: طلبُ المباعدة؛ والثاني: طلب التنقية . يعني: التخلية بعد المباعدة؛ والثالث: طلب الغسل بعد التنقية حتى يزول الأثر بالكلية؛ فيجمع الإنسان بين تنْزيه الله عزّ وجلّ عن كل عيب ونقص، وتطهيره . أنه لا أثر إطلاقاً لما يمكن أن يعلق بالذهن من نقص..
قوله تعالى: { لك } اللام هنا للاختصاص؛ فتفيد الإخلاص؛ وهي أيضاً للاستحقاق؛ لأن الله . جلّ وعلا . أهل لأن يقدس.. أجابهم الله تعالى: { قال إني أعلم ما لا تعلمون } أي من أمر هذه الخليفة التي سيكون منها النبيون، والصدِّيقون، والشهداء، والصالحون.. الفوائد: .1 من فوائد الآية: إثبات القول لله عزّ وجلّ، وأنه بحرف، وصوت؛ وهذا مذهب السلف الصالح من الصحابة، والتابعين، وأئمة الهدى من بعدهم؛ يؤخذ كونه بحرف من قوله تعالى: { إني جاعل في الأرض خليفة }؛ لأن هذه حروف؛ ويؤخذ كونه بصوت من أنه خاطب الملائكة بما يسمعونه؛ وإثبات القول لله على هذا الوجه من كماله سبحانه وتعالى؛ بل هو من أعظم صفات الكمال: أن يكون عزّ وجلّ متكلماً بما شاء كوناً، وشرعاً؛ متى شاء؛ وكيف شاء؛ فكل ما يحدث في الكون فهو كائن بكلمة { كن }؛ لقوله تعالى: {إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون} [يس: 82] ؛ وكل الكون مراد له قدراً؛ وأما قوله الشرعي: فهو وحيه الذي أوحاه إلى رسله، وأنبيائه.. .2 ومن فوائد الآية: أن الملائكة ذوو عقول؛ ووجهه أن الله تعالى وجه إليهم الخطاب، وأجابوا؛ ولا يمكن أن يوجه الخطاب إلا إلى من يعقله؛ ولا يمكن أن يجيبه إلا من يعقل الكلامَ، والجوابَ عليه؛ وإنما نبَّهْنا على ذلك؛ لأن بعض أهل الزيغ قالوا: إن الملائكة ليسوا عقلاء.. .3 ومنها: إثبات الأفعال لله عزّ وجلّ أي أنه تعالى يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء؛ ومن أهل البدع من ينكر ذلك زعماً منه أن الأفعال حوادث؛ والحوادث لا تقوم إلا بحادث فلا يجيء، ولا يستوي على العرش، ولا ينْزل، ولا يتكلم، ولا يضحك، ولا يفرح، ولا يعجب؛ وهذه دعوى فاسدة من وجوه:. الأول: أنها في مقابلة نص؛ وما كان في مقابلة نص فهو مردود على صاحبه.. الثاني: أنها دعوى غير مسلَّمة؛ فإن الحوادث قد تقوم بالأول الذي ليس قبله شيء.. الثالث: أن كونه تعالى فعالاً لما يريد من كماله، وتمام صفاته؛ لأن من لا يفعل إما أن يكون غير عالم، ولا مريد؛ وإما أن يكون عاجزاً؛ وكلاهما وصفان ممتنعان عن الله سبحانه وتعالى.. فتَعَجَّبْ كيف أُتي هؤلاء من حيث ظنوا أنه تنزيه لله عن النقص؛ وهو في الحقيقة غاية النقص!!! فاحمد ربك على العافية، واسأله أن يعافي هؤلاء مما ابتلاهم به من سفه في العقول، وتحريف للمنقول.. .4 ومن فوائد الآية: أن بني آدم يخلف بعضهم بعضاً . على أحد الأقوال في معنى { خليفة }؛ وهذا هو الواقع؛ فتجد من له مائة مع من له سنة واحدة، وما بينهما؛ وهذا من حكمة الله عزّ وجلّ؛ لأن الناس لو من وُلِد بقي لضاقت الأرض بما رحبت، ولما استقامت الأحوال، ولا حصلت الرحمة للصغار، ولا الولاية عليهم إلى غير ذلك من المصالح العظيمة.. .5 ومنها: قيام الملائكة بعبادة الله عزّ وجلّ؛ لقوله تعالى: ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) .6 ومنها: كراهة الملائكة للإفساد في الأرض؛ لقولهم: ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) .7 ومنها: أن وصف الإنسان نفسه بما فيه من الخير لا بأس به إذا كان المقصود مجرد الخبر دون الفخر؛ لقولهم: { ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك }؛ ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر"(80) ؛ وأما إذا كان المقصود الفخر، وتزكية النفس بهذا فلا يجوز؛ لقوله تعالى: { فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى } [النجم: 32] .. .8 ومنها: شدة تعظيم الملائكة لله عزّ وجلّ، حيث قالوا: (ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك) |


|
|
|
#50 |
|
وسام الشرف
       |
القـرآن )قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) (البقرة:32) التفسير: .{ 31 } قوله تعالى: { وعلم آدم }: الفاعل هو الله عزّ وجلّ؛ و{ آدم } هو أبو البشر؛ و{ الأسماء } جمع "اسم"؛ و "أل" فيها للعموم بدليل قوله تعالى: { كلها }؛ وهل هذه الأسماء أسماء لمسميات حاضرة؛ أو لكل الأسماء؟ للعلماء في ذلك قولان؛ والأظهر أنها أسماء لمسميات حاضرة بدليل قوله تعالى: { ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء }؛ وهذه الأسماء . والله أعلم . ما يحتاج إليها آدم، وبنوه في ذلك الوقت.. قوله تعالى: { ثم عرضهم } أي عرض المسميات؛ بدليل قوله تعالى: { أنبئوني بأسماء هؤلاء }، ولأن الميم علامة جمع العاقل؛ فلم تعلم الملائكة أسماء تلك المسميات؛ بل كان جوابهم: { سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا }، ثم قال تعالى: { يا آدم أنبئهم بأسمائهم }: وأراد عزّ وجلّ بذلك أن يعرف الملائكة أنهم ليسوا محيطين بكل شيء علماً، وأنهم يفوتهم أشياء يفضلهم آدم فيها.. قوله تعالى: { أنبئوني }: هل هو فعل أمر يراد به قيام المأمور بما وُجّه إليه، أو هو تحَدٍّ؟ الجواب: الظاهر الثاني: أنه تحدٍّ؛ بدليل قوله تعالى: { إن كنتم صادقين } أن لديكم علماً بالأشياء فأنبئوني بأسماء هؤلاء؛ لأن الملائكة قالت فيما سبق: {أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك} [البقرة: 30] ، فقال تعالى: { إني أعلم ما لا تعلمون }، ثم امتحنهم الله بهذا.. .{ 32 } قوله تعالى: { سبحانك } أي تنزيهاً لك عما لا يليق بجلالك؛ فأنت يا ربنا لم تفعل هذا إلا لحكمة بالغة.. قوله تعالى: { لا علم لنا إلا ما علمتنا }: اعتراف من الملائكة أنهم ليسوا يعلمون إلا ما علمهم الله، هذا مع أنهم ملائكة مقرَّبون إلى الله عزّ وجلّ.. قوله تعالى: { إنك أنت العليم الحكيم }: هذه الجملة مؤكدة بـ "إن" ، وضمير الفصل: { أنت }؛ والمعنى: إنك ذو العلم الواسع الشامل المحيط بالماضي والحاضر، والمستقبل؛ و{ الحكيم } يعني ذا الحكمة، والحكم؛ لأن الحكيم مشتقة من الحكم، والحكمة؛ فهذان اسمان من أسماء الله عزّ وجلّ: { العليم }، و(الحكيم) الفوائد: .1 من فوائد الآيتين: بيان أن الله تعالى قد يمنّ على بعض عباده بعلم لا يعلمه الآخرون؛ وجهه: أن الله علم آدم أسماء مسميات كانت حاضرة، والملائكة تجهل ذلك.. .2 ومنها: أن اللغات توقيفية . وليست تجريبية؛ "توقيفية" بمعنى أن الله هو الذي علم الناس إياها؛ ولولا تعليم الله الناسَ إياها ما فهموها؛ وقيل: إنها "تجريبية" بمعنى أن الناس كوَّنوا هذه الحروف والأصوات من التجارب، فصار الإنسان أولاً أبكم لا يدري ماذا يتكلم، لكن يسمع صوت الرعد، يسمع حفيف الأشجار، يسمع صوت الماء وهو يسيح على الأرض، وما أشبه ذلك؛ فاتخذ مما يسمع أصواتاً تدل على مراده؛ ولكن هذا غير صحيح؛ والصواب أن اللغات مبدؤها توقيفي؛ وكثير منها كسبي تجريبي يعرفه الناس من مجريات الأحداث؛ ولذلك تجد أن أشياء تحدث ليس لها أسماء من قبل، ثم يحدث الناس لها أسماء؛ إما من التجارب، أو غير ذلك من الأشياء.. .3 ومن فوائد الآيتين: جواز امتحان الإنسان بما يدعي أنه مُجيد فيه.. .4 ومنها: جواز التحدي بالعبارات التي يكون فيها شيء من الشدة؛ لقوله تعالى: { أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين.. .5 ومنها: أن الملائكة تتكلم؛ لقوله تعالى: ( أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين * قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ).. .6 ومنها: اعتراف الملائكة . عليهم الصلاة والسلام . بأنهم لا علم لهم إلا ما علمهم الله عزّ وجلّ.. ويتفرع على ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يعرف قدر نفسه، فلا يدَّعي علم ما لم يعلم.. .7 ومنها: شدة تعظيم الملائكة لله عزّ وجلّ، حيث اعترفوا بكماله، وتنزيهه عن الجهل بقولهم: {سبحانك}؛ واعترفوا لأنفسهم بأنهم لا علم عندهم؛ واعترفوا لله بالفضل في قولهم: { إلا ما علمتنا }.. .8 ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما { العليم }، و{ الحكيم }؛ فـ { العليم }: ذو العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً لما كان، وما يكون من أفعاله، وأفعال خلقه.. و{ الحكيم }: ذو الحكمة البالغة التي تعجز عن إدراكها عقول العقلاء وإن كانت قد تدرك شيئاً منها؛ و "الحكمة" هي وضع الشيء في موضعه اللائق به؛ وتكون في شرع الله، وفي قدر الله؛ أما الحكمة في شرعه فإن جميع الشرائع مطابقة للحكمة في زمانها، ومكانها، وأحوال أممها؛ فما أمر الله بشيء، فقال العقل الصريح: "ليته لم يأمر به"؛ وما نهى عن شيء، فقال: "ليته لم ينهَ عنه"؛ وأما الحكمة في قدره فما من شيء يقدره الله إلا وهو مشتمل على الحكمة إما عامة؛ وإما خاصة.. واعلم أن الحكمة تكون في نفس الشيء: فوقوعه على الوجه الذي حكم الله تعالى به في غاية الحكمة؛ وتكون في الغاية المقصودة منه: فأحكام الله الكونية، والشرعية كلها لغايات محمودة قد تكون معلومة لنا، وقد تكون مجهولة؛ والأمثلة على هذا كثيرة واضحة.. ولـ { الحكيم } معنًى آخر؛ وهو ذو الحكم، والسلطان التام؛ فلا معقب لحكمه؛ وحكمه تعالى نوعان: شرعي، وقدري؛ فأما الشرعي فوحيه الذي جاءت به رسله؛ ومنه قوله تعالى: { أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون } [المائدة: 50] ، وقوله تعالى في سورة الممتحنة: { ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم } [الممتحنة: 10] ؛ وأما حكمه القدري فهو ما قضى به قدراً على عباده من شدة، ورخاء، وحزن، وسرور، وغير ذلك؛ ومنه قوله تعالى عن أحد إخوة يوسف: { فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين } (يوسف: 80) والفرق بين الحكم الشرعي، والكوني: أن الشرعي لا يلزم وقوعه ممن حُكِم عليه به؛ ولهذا يكون العصاة من بني آدم، وغيرهم المخالفون لحكم الله الشرعي؛ وأما الحكم القدري فلا معارض له، ولا يخرج أحد عنه؛ بل هو نافذ في عباده على كل حال.. |


|
 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| سورة البقره كامله مكتوبه | لناالله | دراسات وأبحاث علم الرُقى والتمائم . الإدارة العلمية والبحوث Studies and science research spells and | 8 | 15 Jun 2012 01:59 PM |
| حلمي بعد قراءة سورة البقره | انا الورد | تعطير الأنام في تأويل الرؤى والأحلام - تفسير ابن الورد الحسني | 1 | 12 Dec 2010 08:41 PM |
| عاجل وضروري (اقرأ سورة البقره) | ام منار | تعطير الأنام في تأويل الرؤى والأحلام - تفسير ابن الورد الحسني | 1 | 25 Jul 2007 02:39 PM |
| فضل سورة البقره مع شرح للايتان (الاولى والثانيه) | ابرهيم الرفاعى | منهج السلف الصالح . The Salafi Curriculum | 0 | 21 Mar 2007 05:40 PM |
![]()