
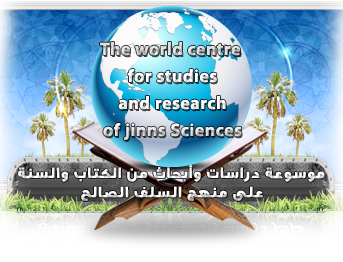

| المكتــــــبة العــــــــــــــامة ( Public Library ) للكتب والأبحاث العلمية |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |

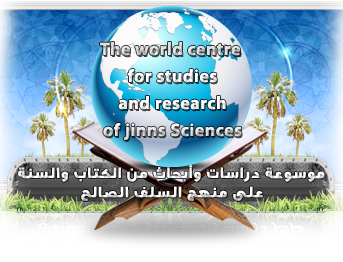

| المكتــــــبة العــــــــــــــامة ( Public Library ) للكتب والأبحاث العلمية |
 |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
#151 |
|
وسام الشرف
       |
29 - ومنها: ثبوت كرامات الأولياء؛ وهي كل أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد أحد أوليائه تكريماً له، وشهادةً بصدق الشريعة التي كان عليها؛ ولهذا قيل: كل كرامة لوليّ فهي آية للنبي الذي اتبعه؛ و«الولي» كل مؤمن تقي؛ لقوله تعالى: {ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون} [يونس: 62، 63] .
30 - ومنها: وجوب العلم بأن الله على كل شيء قدير. القرآن )وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) (البقرة:260) في { إبراهيم } قراءتان؛ { إبراهيم } بكسر الهاء، وياء بعدها؛ و {إبراهام} بفتح الهاء، وألف بعدها؛ وكذلك في { أرني } قراءتان: {أرِني} بكسر الراء؛ و {أرْني} بسكونها؛ وفي { فصرهن } قراءتان أيضاً: {فصُرهن} بضم الصاد؛ و {فصِرهن} بكسرها؛ وفي { جزءاً } قراءتان أيضاً: {جزْءاً} بسكون الزاي؛ و {جزُءاً} بضمها؛ وكل هذه القراءات سبعية. { 260 } قوله تعالى: { وإذ قال إبراهيم رب أرني } { إذ } : مفعول فعل محذوف؛ والتقدير: اذكر إذ قال؛ و{ أرني }: الرؤية هنا بصرية، فتنصب مفعولاً واحد؛ لكن لما دخلت عليها همزة التعدية صارت تنصب مفعولين؛ الأول: الياء؛ والثاني: جملة: { كيف تحيي الموتى }. قوله تعالى: { أو لم تؤمن } فيها إعرابان مشهوران؛ أحدهما: أن الهمزة دخلت على مقدر عُطف عليها قوله تعالى: { ولم تؤمن }؛ وهذا المقدر يكون بحسب السياق؛ وعلى هذا فالهمزة في محلها؛ الثاني: أن الواو حرف عطف على ما سبق؛ والهمزة للاستفهام؛ وأصل محلها بعد الواو؛ والتقدير: «وألم تؤمن»؛ والثاني أسهل، وأسلم؛ لأن الإنسان ربما يقدر فعلاً ليس هو المراد؛ وأسهل؛ لئلا يُتعب الإنسان نفسه في طلب فعل يكون مناسباً. قوله تعالى: { وإذ قال إبراهيم }؛ إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو الأب الثالث للأنبياء؛ فالأول: آدم؛ والثاني: نوح؛ والثالث: إبراهيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: {ملة أبيكم إبراهيم} [الحج: 78] ، وقال تعالى في نوح: {وجعلنا ذريته هم الباقين} [الصافات: 77] ؛ وآدم معلوم أنه أبو البشر: قال الله تعالى: {يا بني آدم} [الأعراف: 26] . قوله تعالى: { رب }: منادى منصوب بفتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة؛ وحرف النداء محذوف للعلم به. قوله تعالى: { أرني كيف تحيي الموتى } أي اجعلني أنظر، وأرى بعيني؛ والسؤال هنا عن الكيفية لا عن الإمكان؛ لأن إبراهيم لم يشك في القدرة؛ ولا عن معنى الإحياء؛ لأن معنى الإحياء عنده معلوم؛ لكن أراد أن يعلم الكيفية: كيف يحيي الله الموتى بعد أن أماتهم، وصاروا تراباً وعظاماً. وقوله تعالى: { الموتى }: هل مراد إبراهيم صلى الله عليه وسلم أيّ موتى يكونون؛ أو أن المراد به الموتى من بني آدم، فضرب الله له مثلاً بالطيور الأربعة؟ إذا نظرنا إلى لفظ { الموتى } وجدناه عاماً؛ يعني أيّ شيء يحييه الله أمامه فقد أراه؛ فيترجح الاحتمال الأول. قوله تعالى: { قال أو لم تؤمن }: هذا الاستفهام للتقرير؛ وليس للإنكار، ولا للنفي؛ فهو كقوله تعالى: {ألم نشرح لك صدرك} [الشرح: 1] ؛ يعني: قد شرحنا لك؛ فمعنى { أو لم تؤمن }: ألست قد آمنت؛ لتقرير إيمان إبراهيم (صلى الله عليه وسلم). وقد فسر كثير من الناس الإيمان في اللغة بـ«التصديق»؛ وهذا التفسير ليس بدقيق؛ لكنه تفسير بما يقارب؛ كتفسيرهم «الريب» بالشك؛ وتفسيرهم «الرهن» بالحبس؛ وتفسير قوله تعالى: {أن تبسل نفس} [الأنعام: 70] أي تحبس؛ وما أشبه ذلك مما يفسرونه بالمعنى المقارِب الذي يَقرُب للفهم؛ وإلا فإن بين الإيمان، والتصديق فرقاً؛ وقد سبق بيان ذلك. قوله تعالى: { بلى } حرف يجاب بها النفي المقرون بالاستفهام لإثباته؛ فإذا قلت: ألست حاضراً معنا في الدرس؟ فالجواب: «بلى» - إن كنت حاضراً؛ و«نعم» - إن لم تكن حاضراً. قوله تعالى: { ولكن ليطمئن قلبي } أي ليزداد طمأنينة؛ وإلا فقد كان مطمئناً؛ و«الطمأنينة» هي الاستقرار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اركع حتى تطمئن راكعاً... اسجد حتى تطمئن ساجداً»(139)، أي تستقر؛ فأراه الله سبحانه وتعالى الآية: قال تعالى: { فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً }. قوله تعالى: { فخذ أربعة من الطير }: لم يعينها الله عز وجل؛ ولهذا تعتبر محاولة تعيينهن لا فائدة منها؛ لأنه لا يهمنا أكانت هذه الطيور إوَزًّا، أم حماماً، أم غرباناً، أم أيَّ نوع من أنواع الطيور؛ لأن الله لم يبينها لنا؛ ولو كان في تبيينها فائدة لبيَّنها الله عز وجل. قوله تعالى: { فصرهن إليك } بكسر الصاد من صار يصير؛ وبضمها من صار يصور؛ أي أملهن إليك؛ و«الصُّور» الميل؛ ومنه الرجل الأصور - التي مالت عينه إلى جانب من جفنه؛ ويسمى «الأحول»؛ فمعنى { صرهن } أي أملهن، واضممهن إليك. قوله تعالى: { ثم اجعل على كل جبل }، أي من الجبال التي حولك { منهن جزءاً } أي من مجموعهن؛ والله أعلم بالحكمة من تعيين العدد، والجبال. قوله تعالى: { ثم ادعهن }؛ ففعل عليه الصلاة والسلام فجمع الأربعة، وذبحهن، وقطعهن أجزاءً، وجعل على كل جبل جزءاً؛ ثم دعاهن فأقبلن. قوله تعالى: { يأتينك سعياً } قيل: إنها جواب لفعل الأمر في قوله تعالى: { ادعهن }؛ وقيل: إنها جواب لفعل شرط مقدر؛ والتقدير: «إن تدعهن يأتينك»؛ فعلى القول الأول يكون جواباً لقوله: { ادعهن }؛ لأن من لازم أمر الله إياه بدعائهن أن يدعوَهن؛ فكأن الشرط معلوم من الأمر؛ وعلى القول الثاني لا إشكال إذا جعلت { يأتينك } جواباً لفعل شرط محذوف - يعني: إن تدعهن يأتينك؛ و{ يأتينك } مبنية على السكون في محل جزم؛ وإنما بنيت على السكون لاتصالها بنون النسوة. وقوله تعالى: { سعياً } مصدر؛ لكن هل هو مصدر عامله محذوف، والتقدير: يسعَين سعياً؛ أو هو مصدر في موضع الحال، فيكون بمعنى: ساعيات؟ يحتمل هذا، وهذا؛ والثاني أولى؛ لأنه لا يحتاج إلى تقدير؛ والقاعدة أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام محذوفاً منه، أو غير محذوف فهو غير محذوف منه. وقوله تعالى: { سعياً }؛ هل نفسر السعي في كل موضع بحسبه؛ أو نقول: سعياً على الأرجل؟ في هذا قولان للمفسرين؛ أحدهما أن السعي هنا بمعنى الطيران؛ فالمعنى: يأتينك طيراناً لا نقص فيهن؛ لأن سعي كل شيء بحسبه؛ وسعي الطيور هو الطيران؛ الثاني: أن المراد بالسعي المشي بسرعة على الأرجل؛ ولكن الأولى - فيما يظهر لنا - هو الطيران؛ لأن كونهن يمشين على الأرجل لا يدل على كمالهن؛ إذ إن الطائر إذا كُسر جناحه صار يمشي؛ لكن كونهن يطرن أبلغ؛ لأنه كأنهن أتين على أكمل الحياة، والوجوه. قوله تعالى: { واعلم أن الله عزيز حكيم }: الخطاب لإبراهيم صلى الله عليه وسلم؛ فإذا علمت ذلك علمت كمالَ قدرته عز وجل لكمال عزته، وكمالَ حكمته؛ لأنه حكيم؛ والله سبحانه وتعالى يقرن كثيراً بين هذين الاسمين: «العزيز» و «الحكيم» ؛ لأن العزيز من المخلوقين قد تفوته الحكمة لعزته: يرى نفسه عزيزاً غالباً، فيتهور في تصرفاته، ويتصرف بدون حكمة؛ والحكيم من المخلوقين قد لا يكون عزيزاً؛ فإذا اقترنت حكمته بعزة صار له سلطان وقوة، ولم تفته الأمور؛ فجمع الله لنفسه بين العزة، والحكمة؛ وسبق الكلام عليهما مفصلاً. الفوائد: 1 - من فوائد الآية: أن التوسل إلى الله بربوبيته من آداب الدعاء التي يتوسل بها الرسل؛ لقوله تعالى: {رب}؛ لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية؛ إذ إنه فعل؛ وكل ما يتعلق بأفعال الرب فهو من مقتضيات الربوبية؛ ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: «يقول: يا رب! يا رب!»(140)؛ ولو تأملت أكثر أدعية القرآن لوجدتها مصدرة بـ«الرب»؛ لأن إجابة الدعاء من مقتضيات الربوبية. 2 - ومنها: أنه لا حرج على الإنسان أن يطلب ما يزداد به يقينه، لقوله تعالى: { أرني كيف تحيي الموتى}؛ لأنه إذا رأى بعينه ازداد يقينه. 3 - ومنها: أن عين اليقين أقوى من خبر اليقين؛ لقوله تعالى: { أرني كيف تحيي الموتى }؛ لأن إبراهيم عليه السلام عنده خبر اليقين بأن الله قادر؛ لكن يريد عين اليقين؛ ولهذا جاء في الحديث: «ليس الخبر كالمعاينة»(141)؛ وقد ذكر العلماء أن اليقين ثلاث درجات: علم؛ وعين؛ وحق؛ كلها موجودة في القرآن؛ مثال «علم اليقين» قوله تعالى: {كلا لو تعلمون علم اليقين} [التكاثر: 5] ؛ ومثال «عين اليقين» قوله تعالى: {ثم لترونها عين اليقين} [التكاثر: 7] ؛ ومثال «حق اليقين» قوله تعالى: {إن هذا لهو حق اليقين} [الواقعة: 56] ؛ نضرب مثالاً يوضح الأمر: قلت: إن معي تفاحة حلوة - وأنا عندك ثقة؛ فهذا علم اليقين: فإنك علمت الآن أن معي تفاحة حلوة؛ فأخرجتُها من جيبي، وقلت: هذه التفاحة؛ فهذا عين اليقين؛ ثم أعطيتك إياها، وأكلتَها وإذا هي حلوة؛ هذا حق اليقين.
|


|
|
|
#152 |
|
وسام الشرف
       |
4 - ومن فوائد الآية: إثبات أفعال الله الاختيارية؛ بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له أفعال تتعلق بمشيئته؛ لقوله تعالى: { تحيي الموتى }.
5 - ومنها: تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بإحياء الموتى؛ وقد قرر الله ذلك في آيات كثيرة. 6 - ومنها: إثبات الكلام لله عز وجل؛ لقوله تعالى: { قال أو لم تؤمن }، وقوله تعالى: { قال فخذ أربعة }؛ والله سبحانه وتعالى؛ يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء؛ بما شاء: من القول؛ متى شاء: في الزمن؛ كيف شاء: في الكيفية. 7 - ومنها: أن كلام الله سبحانه وتعالى بحروف، وأصوات مسموعة؛ لوقوع التحاور بين الله عز وجل، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. 8 - ومنها: إثبات أن إبراهيم مؤمن بقدرة الله عز وجل على إحياء الموتى؛ لقوله تعالى: { قال أو لم تؤمن قال بلى }؛ فإن قلت: كيف تجمع بين هذا، وبين ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نحن أحق بالشك من إبراهيم»(142)؛ فأثبت شكاً فينا، وفي إبراهيم، وأننا أحق بالشك من إبراهيم؟ فالجواب أن الحديث لا يراد به هذا المعنى؛ لأن هذا معنًى يخالف الواقع؛ فليس عند الرسول صلى الله عليه وسلم شك في إحياء الموتى؛ وإنما المعنى أن إبراهيم لم يشك؛ فلو قدر أنه يشك فنحن أحق بالشك منه؛ وما دام الشك منتفياً في حقنا فهو في حقه أشد انتفاءً؛ فإذا عُلم أننا الآن نؤمن بأنه تعالى هو القادر، فإبراهيم أولى منا بالإيمان بذلك؛ هذا هو معنى الحديث، ولا يحتمل غيره؛ فإن قلت: لا زال هنا إشكال؛ وهو: هل إبراهيم أكمل إيماناً من محمد صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب: لا؛ ولكن قاله صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع؛ ولهذا قرن بينه وبين قوله (صلى الله عليه وسلم): «ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي»(143)؛ فيوسف بقي في السجن بضع سنين، وجاءه رسول الملك يدعوه؛ فقال له: لا أخرج، {ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن} [يوسف: 50] ؛ مع أن غيره لو حبس سبع سنين، وقالوا له: «اخرج»، فإنه يخرج؛ هذا مقتضى الطبيعة؛ لكن يوسف - عليه الصلاة والسلام - كان حليماً حازماً؛ قال: لا أخرج حتى تظهر براءتي كاملة؛ فتبين من هذا أنه لا يلزم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أن يكون إبراهيم أقوى إيماناً. 9 - ومن فوائد الآية: إثبات زيادة الإيمان في القلب؛ لقوله تعالى: { بلى ولكن ليطمئن قلبي }؛ ففيه رد على من قال: إن الإيمان لا يزيد، ولا ينقص؛ ولا ريب أن هذا القول ضعيف؛ لأن الواقع يكذبه؛ والنصوص تكذبه أيضاً: ففي القرآن قال الله تعالى: {ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم} [الفتح: 4] ، وقال تعالى: {فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون} [التوبة: 124] ؛ وفي السنة: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»(144)؛ فالإيمان يزيد كمية، وكيفية؛ فمثال زيادة الكمية: أن الذي يسبح عشراً أزيد إيماناً من الذي يسبح خمساً؛ والذي يصلي عشر ركعات أزيد إيماناً من الذي يصلي ستاً؛ وأما زيادة الكيفية فمثالها: رجل صلى ركعتين بطمأنينة، وخشوع، وتأمل فإيمانه أزيد ممن صلاهما بسرعة؛ كذلك يزداد الإيمان بحسب إقرار القلب: كلما كثرت الآيات لدى الإنسان فلا شك أن إيمانه يزداد قوة، ورسوخاً؛ اقرأ قوله تعالى: {ومن الناس من يعبد الله على حرف} [الحج: 11] أي على طرَف {فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة} [الحج: 11] : هذا إيمانه ضعيف مهزوز: إن لم تأته فتنة فهو مستقر؛ وإن أتته فتنة - شبهة، أو شهوة - انقلب على وجهه؛ فمثلاً نحن الآن في المملكة العربية السعودية ليس عندنا - ولله الحمد - أحد يعارضنا في العقيدة؛ فليس عندنا معتزلة، ولا جهمية، ولا جبرية...، فنحن ثابتون على الفطرة؛ ولكن لو يبتلى الإنسان، فيأتيه واحد من عفاريت الإنس جيد في المجادلة، والمحاجة من المعتزلة لأوشك أن يؤثر عليه، وينقله إذا لم يكن لديه رسوخ في العلم، والإيمان؛ كذلك لو أن إنساناً عنده إيمان لكن تعرضت له امرأة ذات منصب، وجمال، وأغرته حتى وقع في الفاحشة؛ وإنسان آخر تعرضت له هذه المرأة فقال: «إني أخاف الله» تجد الفرق بينهما؛ فالمهم أن القول الراجح الذي لا شك فيه، والذي تدل عليه الأدلة السمعية، والواقعية أن الإيمان يزيد، وينقص. 10 - ومن فوائد الآية: جواز الاقتصار في الجواب على الحرف الدال عليه؛ لقوله تعالى: { بلى }؛ وعليه فلو قيل للرجل: ألم تطلق زوجتك؟ فقال: «بلى»: طلقت؛ ولو قيل للرجل عند عقد النكاح: أقبلت النكاح، وقال: «نعم» انعقد النكاح؛ لأن حرف الجواب يغني عن ذكر الجملة. 11 - ومنها: امتنان الله على العبد بما يزداد به إيمانه، لقوله تعالى: { فخذ أربعة من الطير... } إلى قوله تعالى: { يأتينك سعياً }. 12 - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: «العزيز» و «الحكيم» ؛ وإثبات ما تضمناه من الصفة؛ وهي العزة، والحكمة؛ لأن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة ولا عكس؛ يعني: ليس كل صفة يؤخذ منها اسم؛ لكن كل اسم يؤخذ منه صفة؛ لأن أسماء الله عز وجل أعلام، وأوصاف؛ فكل اسم من أسمائه متضمن للصفة التي دل عليها اشتقاقه، أو لوازمها. القرآن )مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (البقرة:261) { 261 } قوله تعالى: { مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة }؛ يطلق المثل على الشبه؛ ويطلق على الصفة؛ فإن ذكر مماثل، فالمراد به الشبه؛ وإلا فالمراد به الصفة؛ ففي قوله تعالى: {مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن...} [محمد: 15] المراد بالمثل الصفة؛ لأنه لم يذكر المماثل؛ أما إذا قيل: «مثَل هذا كمثَل هذا» فهذا يعني الشبه، كقوله تعالى: {مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً...} [البقرة: 17]، وكما في هذه الآية: { مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة } فهذا المراد به الشبه؛ يعني شبه هؤلاء كشبه هذا الشيء؛ والذي يظهر من الآية أنه لا يوجد فيها مطابقة بين الممثل، والممثل به؛ لأن «الممثل» هو العامل؛ و«الممثل به» هو العمل؛ فالحبة ليست بإزاء المنفِق؛ لكنها بإزاء المنفَق؛ والذي يكون بإزاء المنفِق زارعَ الحبة؛ ولهذا قال بعض العلماء: إن الآية فيها تقدير: إما في المبتدأ؛ وإما في الخبر: فإما أن يقدر: مثل عمل الذين ينفقون أموالهم كمثل حبة؛ أو يقدر: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل زارع حبة أنبتت سبع سنابل؛ والحكمة من هذا الطيّ أن يكون المثل صالحاً للتمثيل بالعامل، والتمثيل بالعمل؛ وهذا من بلاغة القرآن؛ و «الإنفاق» معناه البذل؛ و «أموال» جمع مال؛ وهو كل ما يتموله الإنسان من أعيان، أو منافع؛ الأعيان كالدراهم، والدنانير، والسيارات، والدور، وما أشبه ذلك؛ والمنافع كمنافع العين المستأجرة؛ فإن المستأجر مالك للمنفعة. وقوله تعالى: { في سبيل الله }؛ «سبيل» بمعنى طريق؛ وسبيل الله سبحانه وتعالى هو شرعه؛ لأنه يهدي إليه، ويوصل إليه؛ قال الله تعالى: {وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله} [الأنعام: 153] ؛ وأضيف إلى الله لسببين؛ السبب الأول: أنه هو الذي وضعه لعباده، وشرعه لهم؛ والسبب الثاني: أنه موصل إليه؛ ويضاف «السبيل» أحياناً إلى سالك السبيل؛ فيقال: سبيل المؤمنين، كما قال الله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين} [النساء: 115] ؛ ولا تناقض بينهما؛ لأنه يضاف إلى المؤمنين باعتبار أنهم هم الذين سلكوه؛ وإلى الله باعتبار أنه الذي شرعه، وأنه موصل إليه. قوله تعالى: { كمثل حبة أنبتت سبع سنابل }؛ حبة بذرها إنسان، فأنبتت سبع سنابل { في كل سنبلة مائة حبة }؛ فتكون الجميع سبعمائة؛ فالحسنة إذاً في الإنفاق في سبيل الله تكون بسبعمائة؛ وهذا ليس حدّاً. قوله تعالى: { والله يضاعف لمن يشاء } أي يزيد ثواباً لمن يشاء حسب ما تقتضيه حكمته. قوله تعالى: { والله واسع } أي ذو سعة في جميع صفاته؛ فهو واسع العلم، والقدرة، والرحمة، والمغفرة، وغير ذلك من صفاته؛ فإنها صفات واسعة عظيمة عليا؛ و{ عليم } أي ذو علم - وهو واسع فيه - وعلمه شامل لكل شيء جملة، وتفصيلاً؛ حاضراً، ومستقبلاً، وماضياً. الفوائد: 1 - من فوائد الآية: ضرب الأمثال؛ وهو تشبيه المعقول بالمحسوس؛ لأن ذلك أقرب إلى الفهم. 2 - ومنها: أن القرآن على غاية ما يكون من البلاغة، والفصاحة، لأن الفصاحة هي الإفصاح بالمعنى، وبيانه؛ وضرب الأمثال من أشد ما يكون إفصاحاً، وبياناً: قال تعالى: { وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون} [العنكبوت: 43] . 3 - ومنها: فضيلة الإنفاق في سبيل الله؛ لأنه ينمو للمنفق حتى تكون الحبة سبعمائة حبة. 4 - ومنها: الإشارة إلى الإخلاص لله في العمل؛ لقوله تعالى: { في سبيل الله } بأن يقصدوا بذلك وجه الله عز وجل. 5 - ومنها: الإشارة إلى موافقة الشرع؛ لقوله تعالى: { في سبيل الله }؛ لأن { في } للظرفية؛ والسبيل بمعنى الطريق؛ وطريق الله: شرعه؛ والمعنى: أن هذا الإنفاق لا يخرج عن شريعة الله؛ والإنفاق الذي يكون موافقاً للشرع هو ما ذكره بقوله تعالى: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً} [الفرقان: 67]. ومعنى إنفاقهم في شرع الله أن يكون ذلك إخلاصاً لله، واتباعاً لشرعه؛ فمن نوى بإنفاقه غير الله فليس في سبيل الله؛ مثل «المرائي»: رجل أنفق في الجهاد، أو أنفق في الصدقة على المساكين؛ لكنه أنفق ليقال: إن فلاناً جواد؛ أو أنه كريم؛ هذا ليس في سبيل الله، لأنه مراء؛ لم يقصد وجه الله عز وجل؛ إذاً لم يرد السبيل الذي يوصل إلى الله؛ ولا يهمه أن يقبل الله منه، أو لا يقبل؛ المهم عنده أنه يقال عند الناس: إنه رجل كريم، أو جواد. وأما أن يكون على حسب شريعة الله: فإن أنفق في وجه لا يرضى به الله فليس في سبيل الله - وإن أخلص لله - كرجل ينفق على البدع يريد بذلك وجه الله - وهذا كثير: كبناء الربط للصوفية المنحرفة، وبناء البيوت للأعياد الميلادية، وبناء القصور للمآتم، وطبع الكتب المشتملة على بدع؛ هذا قد يريد الإنسان بذلك وجه الله لكنه خلاف شريعة الله؛ فلا يكون في سبيل الله. 6 - ومن فوائد الآية: إثبات الملكية للإنسان؛ لقوله تعالى: { أموالهم }؛ فإن الإضافة هنا تفيد الملكية. 7 - ومنها: وجه الشبه في قوله تعالى: { كمثل حبة أنبتت سبع سنابل }؛ فإن هذه الحبة أنبتت سبع سنابل؛ وشبهها الله بذلك؛ لأن السنابل غذاء للجسم، والبدن؛ كذلك الإنفاق في سبيل الله غذاء للقلب، والروح. 8 - ومنها: أن ثواب الله، وفضله أكثر من عمل العامل؛ لأنه لو عومل العامل بالعدل لكانت الحسنة بمثلها؛ لكن الله يعامله بالفضل، والزيادة؛ فتكون الحبة الواحدة سبعمائة حبة؛ بل أزيد؛ لقوله تعالى: { والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم }. 9 - ومنها: إثبات الصفات الفعلية - التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل؛ لقوله تعالى: { يضاعف }؛ و«المضاعفة» فعل. 10 - ومنها: إثبات مشيئة الله؛ لقوله تعالى: { لمن يشاء }؛ ولكن هل هذه المشيئة مشيئة مجردة؛ أي أن الترجيح يكون فيها بدون سبب؛ أو هي مشيئة مقيدة بما تقتضيه المصلحة، والحكمة؟ الجواب أنها مشيئة مقيدة بما تقتضيه المصلحة، والحكمة؛ وعليه فخذ هذا مقياساً: كل شيء علقه الله على المشيئة فإنه مقيد بالحكمة؛ ودليله قوله تعالى: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً} [الإنسان: 30] . 11 - ومنها: أن الله له السلطان المطلق في خلقه؛ ولا أحد يعترض عليه؛ لقوله تعالى: { يضاعف لمن يشاء}؛ ولهذا لما تناظر رجل من المعتزلة، وآخر من أهل السنة قال له المعتزلي: أرأيت إن منعني الهدى، وقضى علي بالردى أحسن إلي، أم أساء؟ - يريد أن يبين أن أفعال العباد لا تدخل في إرادة الله؛ لأنه إذا دخلت في إرادة الله فإن هذا الذي قضى عليه بالشقاء، ومنع الهدى يكون إساءة من الله إليه، فقال له السني: إن منعك ما هو لك فقد أساء؛ وإن منعك فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ فغُلب المعتزلي؛ لأنه ليس لك حق على الله واجب؛ والله سبحانه وتعالى يؤتي فضله من يشاء. 12 - ومن فوائد الآية: إثبات هذين الاسمين من أسماء الله: «الواسع» ، و «العليم» ؛ لقوله تعالى: { واسع عليم }؛ وإثبات ما تضمناه من صفة؛ وهما السعة، والعلم. 13 - ومنها: الحث، والترغيب في الإنفاق في سبيل الله؛ يؤخذ هذا من ذكر فضيلة الإنفاق في سبيل الله، فإن الله لم يذكر هذا إلا من أجل هذا الثواب؛ فلا بد أن يعمل له. القرآن )الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنّاً وَلا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) (البقرة:262) { 262 } قوله تعالى: { الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله } ذكره مرة أخرى ليبني عليها ما بعدها؛ وهي قوله تعالى: { ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى }. قوله تعالى: { ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا } أي لا يحصل منهم بعد الصدقة مَنٌّ بأن يظهر المنفِق مظهر المترفع على المنفَق عليه؛ { ولا أذى } أي أذى المنفَق عليه بأن يقول المنفِق: «لقد أنفقت على فلان كذا، وكذا» أمام الناس؛ فإن هذا يؤذي المنفق عليه. قوله تعالى: { لهم أجرهم }؛ «الأجر» ما يعطاه العامل في مقابلة عمله؛ ومنه أجرة الأجير؛ وسمى الله سبحانه وتعالى الثواب أجراً؛ لأنه عز وجل تكفل للعامل بأن يجزيه على هذا العمل؛ فصار كأجر الأجير. قوله تعالى: { عند ربهم }: أصل العندية تكون في المكان؛ وقد يراد بها ما يعم المكان، والالتزام، كما تقول: عندي لفلان كذا، وكذا؛ أي في عهدي، وفي ذمتي له كذا، وكذا - حتى وإن لم يكن ذلك عنده في مكانه - فالعندية قد يراد بها المكان؛ وقد يراد بها ما يلتزم به الإنسان في ذمته، وعهده؛ وهنا { عند ربهم } يحتمل المعنيين؛ يحتمل أنه عند الله سبحانه وتعالى ملتزم به، ولا بد أن يوفيه؛ ويحتمل معنى آخر - وكلاهما صحيح - أن الثواب هذا يكون في الجنة التي سقفها عرش الرحمن؛ وهذه عندية مكان - ولا ينافي ما سبق من عندية العهد، والالتزام بالوفاء؛ فتكون الآية شاملة للمعنيين. قوله تعالى: { ولا خوف عليهم } أي مما يستقبل { ولا هم يحزنون } أي على ما مضى - لكمال نعيمهم - لأن المنعَّم لو أصابه الحزن، أو الخوف لتنغص نعيمه. الفوائد: 1 - من فوائد الآية: الحث على الإنفاق في سبيل الله؛ لقوله تعالى: { لهم أجرهم عند ربهم }. 2 - ومنها: الإشارة إلى الإخلاص لله، ومتابعة الشرع؛ لقوله تعالى: { في سبيل الله }. 3 - ومنها: أن من أتبع نفقته منًّا، أو أذى، فإنه لا أجر له؛ لقوله تعالى: { ثم لا يتبعون ما أنفقوا منًّا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم }؛ فإذا أتبع منًّا، أو أذًى بطل أجره، كما هو صريح قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} [البقرة: 264] . 4 - ومنها: أن المن والأذى يبطل الصدقة؛ وعليه فيكون لقبول الصدقة شروط سابقة، ومبطلات لاحقة؛ أما الشروط السابقة فالإخلاص لله، والمتابعة؛ وأما المبطلات اللاحقة فالمن، والأذى. |


|
|
|
#153 |
|
وسام الشرف
       |
مـسألة:
هل مجرد إخبار المنفِق بأنه أعطى فلاناً دون منّ منه بذلك يعتبر من الأذى؟ الجواب: نعم؛ لأن المعطى تنزل قيمته عند من علم به؛ لكن لو أراد بالخبر أن يقتدي الناس به فيعطوه فليس في هذا أذًى؛ بل هو لمصلحة المعطى؛ أما إن ذكر أنه أعطى، ولم يعيِّن المعطى فهذا ليس فيه أذى؛ ولكن يخشى عليه الإعجاب، أو المراءاة. مـسألة أخرى: هل المنفق عليه إذا أحس بأن المنفق منّ عليه، أو ربما أذاه هل الأفضل أن يبقى قابلاً للإنفاق أو يرده؟ الجواب الأفضل أن يرده لئلا يكون لأحد عليه منة؛ ولكن إذا رده بعد القبض فهل يلزم المنفِق قبوله؟ الجواب: لا يلزمه قبوله؛ لأنه خرج عن ملكه إلى ملك المنفق عليه؛ فيكون رده إياه ابتداء عطية. 5 - ومن فوائد الآية: إثبات العندية لله عز وجل؛ لقوله تعالى: { عند ربهم }؛ والعندية تفيد القرب؛ فيكون الله عز وجل في مكان، وبعض الأشياء عنده، وبعض الأشياء بعيدة عنه؛ ولكن كلها قد أحاط الله بها؛ كلها بالنسبة إليه - إلى علمه، وقدرته، وسلطانه، وربوبيته - كلها سواء - لكن لا شك أن من كان حول العرش ليس كمن حول الفرش؛ ولكن يجب أن نعلم أن المكان ليس محيطاً به، كما قال تعالى: {وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه} [الزمر: 67] ؛ لأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء؛ لا يحيط به شيء من مخلوقاته. 6 - ومن فوائد الآية: أن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ويَسْلَمون من المحبطات لا ينالهم خوف في المستقبل، ولا حزن على الماضي؛ لقوله تعالى: { ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون }. القرآن )قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذىً وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ) (البقرة:263) { 263 } قوله تعالى: { قول } مبتدأ؛ و{ خير } خبره؛ وساغ الابتداء به هنا وهو نكرة؛ لأنه وصف؛ وإن شئت فقل: لأنه أفاد؛ وطريق إفادته الوصف؛ وإذا عللت بأنه أفاد صار أحسن؛ لأنه أعم. قوله تعالى: { قول معروف } أي ما نطق به اللسان معروفاً في الشرع، ومعروفاً في العرف. قوله تعالى: { ومغفرة } أي: مغفرة الإنسان لمن أساء إليه؛ قال تعالى: {ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور} [الشورى: 43] ؛ القول المعروف إحسان؛ والمغفرة إحسان؛ ولكن الفرق بينهما أن «القول المعروف» إسداء المعروف القولي إلى الغير؛ و «المغفرة» تسامح الإنسان عن حقه في جانب غيره. قوله تعالى: { خير من صدقة يتبعها أذى }؛ «الصدقة» بذل الإحسان المالي؛ الإنسان قد ينتفع بالمال أكثر مما ينتفع بالكلمة؛ وقد ينتفع بالكلمة أكثر مما ينتفع بالمال؛ لكن لا شك أن القول المعروف خير من الصدقة التي يتبعها أذى - وإن نفعت؛ لأنك لو تعطي هذا الرجل ما تعطيه من المال صدقة لله عز وجل، ثم تتبعها الأذى؛ فإن هذا الإحسان صار في الحقيقة إساءة - وإن كان هذا قد ينتفع به في حاجاته - لكن هو في الحقيقة إساءة له. قوله تعالى: { والله غني } أي عن غيره؛ فهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد؛ وكل من في السموات والأرض فإنه محتاج إلى الله تعالى؛ هو غني بذاته عن جميع مخلوقاته؛ فله الغنى المطلق من جميع الوجوه. قوله تعالى: { حليم }؛ «الحلم» تأخير العقوبة عن مستحقها؛ قال ابن القيم في النونية: (وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان) وجمع الله في هذه الآية بين «الغِنى» و «الحِلم» ؛ لأن الآية في سياق الصدقة، فبين عز وجل أن الصدقات لا تنفع الله؛ وإنما تنفع من يتصدق؛ والآية أيضاً في سياق من أتبع الصدقة أذى ومِنّة؛ وهذا حري بأن يعاجَل بالعقوبة، حيث آذى هذا الرجل الذي أعطاه المال لله؛ ولكن الله حليم يحلم على عبده لعله يتوب من المعصية. الفوائد: 1 - من فوائد الآية: فضيلة القول المعروف؛ لقوله تعالى: { قول معروف ومغفرة خير من صدقة... }؛ و «القول المعروف» كل ما عرفه الشرع، والعادة؛ مثال ذلك: أن يأتي رجل يسأل مالاً بحاله، أو قاله؛ فكلمه المسؤول، وقال: ليس عندي شيء، وسيرزق الله، وإذا جاء شيء فإننا نجعلك على البال، وما أشبه ذلك؛ فهذا قول معروف ليِّن، وهيِّن. 2 - ومنها: الحث على المغفرة لمن أساء إليك؛ لكن هذا الحث مقيد بما إذا كانت المغفرة إصلاحاً؛ لقوله تعالى: {فمن عفا وأصلح فأجره على الله} [الشورى: 40] ؛ أما إذا لم تكن المغفرة إصلاحاً، مثل أن أغفر لهذا الجاني، ثم يذهب، ويسيء إلى الآخرين، أو يكرر الإساءة إليَّ، فإن الغفر هنا غير مطلوب. 3 - ومنها: أن الأعمال الصالحة تتفاضل، ويلزم من تفاضلها تفاضل العامل، وزيادة الإيمان، أو نقصانه. 4 - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما «الغني» و «الحليم» ؛ وإثبات ما دلا عليه من الصفات. 5 - ومنها: المناسبة في ختم هذه الآية الكريمة بهذين الاسمين؛ لأن في الآية إنفاقاً؛ وإذا كان الله عز وجل هو الذي يخلِف هذا الإنفاق فإنه لكمال غناه؛ كذلك المغفرة عمن أساء إليك: فإن المغفرة تتضمن الحلم، وزيادة؛ فختم الله الآية بالحلم؛ وقد يقال: إن فيه مناسبة أخرى؛ وهي أن المن بالصدقة كبيرة من كبائر الذنوب؛ والله سبحانه وتعالى حليم على أهل الكبائر؛ إذ لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، والله أعلم. القرآن )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ) (البقرة:264) { 264 } قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا }: تصدير الخطاب بالنداء يدل على الاهتمام به؛ لأن النداء يحصل به تنبيه المخاطب؛ فيدل على العناية بموضوع الخطاب؛ ولهذا قال ابن مسعود: «إذا سمعت الله يقول: { يا أيها الذين آمنوا } فأرعها سمعك: فإنه خير تأمر به؛ أو شر ينهى عنه»(145)؛ وصدق رضي الله عنه. ثم في توجيه النداء للمؤمنين بوصف الإيمان فيه فوائد؛ الفائدة الأولى: الحث على قبول ما يلقى إليهم، وامتثاله؛ وجه ذلك: أنه إذا علق الحكم بوصف كان ذلك الوصف علة للتأثر به؛ كأنه يقول: يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم افعلوا كذا، وكذا؛ أو لا تفعلوا كذا؛ الفائدة الثانية: أن ما ذكر يكون من مكملات الإيمان، ومقتضياته؛ الفائدة الثالثة: أن مخالفة ما ذكر نقص في الإيمان. قوله تعالى: { لا تبطلوا صدقاتكم }: الإبطال للشيء يكون بعد وجوده؛ فالبطلان لا يكون غالباً إلا فيما تم؛ و «الصدقات» جمع صدقة؛ وهي ما يبذله الإنسان تقرباً إلى الله. قوله تعالى: { بالمن والأذى }؛ الباء للسببية؛ و «المن» إظهار أنك مانّ عليه، وأنك فوقه بإعطائك إياه؛ و «الأذى» أن تذكر ما تصدقت به عند الناس فيتأذى به. قوله تعالى: { كالذي ينفق ماله رئاء الناس }؛ الكاف هنا للتشبيه؛ وهي خبر مبتدأ محذوف؛ والتقدير: مثلكم كالذي ينفق ماله رئاء الناس؛ و{ رئاء } مفعول لأجله؛ وهي مصدر راءى يرائي رئاءً ومراءاة، كـقاتل يقاتل قتالاً ومقاتلة؛ وجاهد يجاهد جهاداً ومجاهدة؛ و«الرياء» فِعل العبادة ليراه الناس، فيمدحوه عليها. قوله تعالى: { ولا يؤمن بالله وباليوم الآخر } معطوف على قوله تعالى: { ينفق }؛ وسبق معنى الإيمان بالله، واليوم الآخر؛ وهذا الوصف ينطبق على المنافق؛ فالمنافق - والعياذ بالله - لا يؤمن بالله، ولا باليوم الآخر؛ ولا ينفق إلا مراءاةً للناس؛ ومع ذلك لا ينفق إلا وهو كاره، كما قال تعالى: {وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس} [النساء: 142] ، وقال في سورة «التوبة»: {ولا ينفقون إلا وهم كارهون} [التوبة: 54] ؛ هؤلاء لا ينفقون إلا وهم كارهون؛ لأنهم لا يرجون من هذا الإنفاق ثواباً؛ إذ إنه لا إيمان عندهم، و{ اليوم الآخر } هو يوم القيامة؛ وسمي «اليوم الآخر» ؛ لأنه لا يوم بعده؛ كل يذهب إلى مستقره: أهل الجنة إلى مستقرهم؛ وأهل نار إلى مستقرهم؛ فهو يوم آخر لا يوم بعده؛ ولذلك فهو مؤبد: إما في جنة؛ وإما في نار. قوله تعالى { كمثل صفوان } أي كشِبْه صفوان؛ وهو الحجر الأملس { عليه تراب }؛ والتراب معروف؛ { فأصابه وابل } أي مطر شديد الوقع سريع التتابع؛ فإذا أصاب المطر تراباً على صفوان فسوف يزول التراب؛ ولهذا يقول تعالى: { فتركه صلداً } أي ترك الوابلُ هذا الصفوانَ أملس ليس عليه تراب؛ وجه الشبه بين المرائي والصفوان الذي عليه تراب، أن من رأى المنافق في ظاهر حاله ظن أن عمله نافع له؛ وكذلك من رأى الصفوان الذي عليه تراب ظنه أرضاً خصبة طينية تنبت العشب؛ فإذا أصابها الوابل الذي ينبت العشب سحق التراب الذي عليه، فزال الأمل في نبات العشب عليه من الوابل؛ ولهذا قال تعالى: { لا يقدرون على شيء مما كسبوا }؛ وصح عود واو الجماعة في { يقدرون } على { الذي } في قوله تعالى: { كالذي ينفق ماله }؛ لأن { الذي } اسم موصول يفيد العموم؛ فهو بصيغته اللفظية مفرد، وبدلالته المعنوية جمع؛ لأنه عام؛ وسمى الله عز وجل ما أنفقوا كسباً باعتبار ظنهم أنهم سينتفعون به. قوله تعالى: { والله لا يهدي القوم الكافرين } أي لا يهدي سبحانه الكافرين هداية توفيق؛ أما هداية الدلالة فإنه سبحانه لم يَدَع أمة إلا بعث فيها نبياً؛ لكن الكافر لا يوفقه الله لقبول الحق؛ و{ الكافرين } أي الذين حقت عليهم كلمة الله، كما قال تعالى: {إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم} [يونس: 96، 97] . الفوائد: 1 - من فوائد الآية: تحريم المن، والأذى في الصدقة؛ لقوله تعالى: { لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى }. 2 - ومنها: بلاغة القرآن، حيث جاء النهي عن المنّ، والأذى بالصدقة بهذه الصيغة التي توجب النفور؛ وهي: { لا تبطلوا صدقاتكم }؛ فإنها أشد وقعاً من «لا تَمُنّوا، ولا تؤذوا بالصدقة». 3 - ومنها: أن المن والأذى بالصدقة يبطل ثوابها؛ لقوله تعالى: { لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى }. 4 - ومنها: أن المن والأذى بالصدقة كبيرة من كبائر الذنوب؛ وجه ذلك: ترتيب العقوبة على الذنب يجعله من كبائر الذنوب؛ وقد قال شيخ الإسلام في حد الكبيرة: «كل ذنب رُتب عليه عقوبة خاصة، كالبراءة منه، ونفي الإيمان، واللعنة، والغضب، والحد، وما أشبه ذلك»؛ وهذا فيه عقوبة خاصة؛ وهي إبطال العمل؛ ويؤيد ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»(146). 5 - ومنها: أن المنّ والأذى بالصدقة مناف لكمال الإيمان؛ لقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى }؛ كأنه يقول: «إن مقتضى إيمانكم ألا تفعلوا ذلك؛ وإذا فعلتموه صار منافياً لهذا الوصف، ومنافياً لكماله». 6 - ومنها: تشبيه المعقول بالمحسوس ليقربه إلى الذهن؛ لقوله تعالى: { فمثله كمثل صفوان... } إلخ. 7 - ومنها: تحريم مراءاة الناس بالعمل الصالح؛ لقوله تعالى: { كالذي ينفق ماله رئاء الناس }؛ والتسميع كالمراءاة؛ والفرق بينهما أن المراءاة فيما يُرى - كالأفعال - والتسميع بما يقال. 8 - ومنها: أن من راءى الناس بإنفاقه ففي إيمانه بالله، وباليوم الآخر نقص؛ لقوله تعالى: { ولا يؤمن بالله وباليوم الآخر }؛ لأن الذي يرائي لو كان مؤمناً بالله حق الإيمان لجعل عمله لله خالصاً لله؛ ولو كان يؤمن باليوم الآخر حق الإيمان لم يجعل عمل الآخرة للدنيا؛ لأن مراءاة الناس قد يكسب بها الإنسان جاهاً في الدنيا فقط؛ مع أنه لا بد أن يتبين أمره؛ وإذا تبين أنه مراءٍ نزلت قيمته في أعين الناس؛ يقول الشاعر: (ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا اكتسيت به فإنك عاري) أنت لا تظن أنك إذا راءيت الناس أنك ستبقى مخادعاً لهم؛ بل إن الله سبحانه وتعالى سيظهر ذلك؛ ما أسر إنسان سريرة إلا أظهرها الله سبحانه على صفحات وجهه، وفلتات لسانه. 9 - ومن فوائد الآية: إثبات اليوم الآخر؛ وهو يوم القيامة. 10 - ومنها: بلاغة القرآن في التشبيه؛ لأنك إذا طابقت بين المشبه، والمشبه به، وجدت بينهما مطابقة تامة. 11 - ومنها: إثبات كون القياس دليلاً صحيحاً؛ وجه ذلك: التمثيل، والتشبيه؛ فكل تمثيل في القرآن فإنه دليل على القياس؛ لأن المقصود به نقل حكم هذا المشبه به إلى المشبه. |


|
|
|
#154 |
|
وسام الشرف
       |
12 - ومنها: أن الرياء مبطل للعمل؛ وهو نوع من الشرك؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملًا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»(147)؛ فإن قصد بعمله إذا رآه الناس أن يتأسى الناس به، ويسارعوا فيه فهي نية حسنة لا تنافي الإخلاص؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، وقال: «إنما صنعت هذا لتأتموا بي، ولتعلَّموا صلاتي»(148)؛ وفي الحج كان صلى الله عليه وسلم يقول: «لتأخذوا مناسككم»(149)؛ وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة»(150).
13 - ومن فوائد الآية: الإشارة إلى تحسر هؤلاء عند احتياجهم إلى العمل، وعجزهم عنه؛ لقوله تعالى: { لا يقدرون على شيء مما كسبوا }؛ وعجز الإنسان عن الشيء بعد محاولة القدرة عليه أشد حسرة من عدمه بالكلية؛ ألم تر إلى قوله تعالى: {أفرأيتم ما تحرثون * أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون * لو نشاء لجعلناه حطاماً} [الواقعة: 63 - 65] ؛ وكونه حطاماً ينظرون إليه أشد حسرة من كونه لم ينبت أصلاً؛ وقوله تعالى: {أفرأيتم الماء الذي تشربون * أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون * لو نشاء جعلناه أجاجاً} [الواقعة: 68 - 70] ؛ وكونه بين أيديهم أجاجاً لا يستسيغون شربه أشد مما لو لم يوجد أصلاً؛ والإنسان العاقل يجعل العمل لله: لله؛ والعمل للناس: للناس؛ أنا قد أحب أن أخرج للناس في ثوب جميل: لا بأس أن أتجمل ليراني الناس على هذه الحال؛ لكن أصلي ليراني الناس أصلي: لا يصح؛ لأن العمل لله يجب أن يكون لله لا يشاركه فيه أحد. 14 - ومن فوائد الآية: أن من قضى الله عليه بالكفر لا تمكن هدايته؛ لقوله تعالى: { والله لا يهدي القوم الكافرين }؛ فإن قلت: كيف تجمع بين هذا وبين الواقع من أن الله سبحانه وتعالى هدى قوماً كافرين كثيرين؟ فالجواب أن من هدى الله لم تكن حقت عليهم كلمة الله؛ فأما من حقت عليه كلمة الله فلن يُهْدى، كما قال تعالى: {إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم} [يونس: 96، 97] . 15 - ومنها: أن المنافق كافر؛ لقوله تعالى: { والله لا يهدي القوم الكافرين } بعد أن ذكر ما يتعلق بصفة المنافق؛ وهو الذي ينفق ماله رئاء الناس، ولا يؤمن بالله، واليوم الآخر؛ وهذا ينطبق تماماً على المنافقين؛ ولا ريب أن المنافقين كفار - وإن تظاهروا بالإسلام - ولكن هل نعاملهم معاملة الكفار؟ الجواب: لا نعاملهم معاملة الكفار؛ لأن أحكام الدنيا تجري على الظاهر؛ وأحكام الآخرة تجري على الباطن والسرائر، كما قال تعالى: {أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور * وحصِّل ما في الصدور} [العاديات: 9، 10] ، وقال تعالى: {يوم تبلى السرائر} [الطارق: 9] ؛ ولأنه لو عومل الناس في الدنيا على السرائر لكان في ذلك تكليف ما لا يطاق من وجه؛ وكان في ذلك الفوضى التي لا نهاية لها من وجه آخر؛ أما تكليف ما لا يطاق فلأننا لا نعلم ما في صدور الناس؛ فلا يمكن أن نحكم عليه؛ وأما الفوضى فلأنه يستطيع كل ظالم له ولاية أن يعاقب هذا الرجل، أو يعدم هذا الرجل بحجة أنه مبطن للكفر؛ ولما استؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتل المنافقين قال: «لا أقتلهم؛ لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه»(151). القرآن )وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (البقرة:265) { 265 } قوله تعالى: { مثل }: مبتدأ؛ وخبره قوله تعالى: { كمثل جنة }؛ وقوله تعالى: { ينفقون } أي يبذلون؛ وقوله تعالى: { ابتغاء مرضات الله } أي طلب رضوان الله. قوله تعالى: { وتثبيتاً } معطوفة على { ابتغاء }؛ وقوله تعالى: { من أنفسهم }؛ { من } ابتدائية؛ يعني: تثبيتاً كائناً في أنفسهم لم يحملهم عليه أحد؛ ومعنى يثبتونها: يجعلونها تثبت، وتطمئن؛ أي لا تتردد في الإنفاق، ولا تشك في الثواب؛ وهذا يدل على أنهم ينفقون طيبة نفوسهم بالنفقة. قوله تعالى: { كمثل جنة بربوة }؛ «الجنة» البستان الكثير الأشجار؛ وسميت بذلك؛ لأنها تجن من فيها، وفي قوله تعالى: { بربوة } بفتح الراء قراءة أخرى بضم الراء؛ و«الربوة» المكان المرتفع؛ من ربا الشيء إذا زاد، وارتفع، كما في قوله تعالى: {فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت} [الحج: 5] . قوله تعالى: { أصابها وابل } أي نزل عليها وابل؛ و «الوابل» المطر الشديد. هذه جنة بربوة مرتفعة للهواء بائنة ظاهرة للشمس؛ أصابها وابل؛ ماذا تكون هذه الجنة! ستثمر ثمراً عظيماً؛ ولهذا قال تعالى: { فآتت أكلها ضعفين }؛ «الأكل» بمعنى الثمر الذي يؤكل: قال الله تعالى: {أكلها دائم وظلها} [الرعد: 35] يعني ثمرها الذي يؤكل؛ و{ ضعفين } أي مضاعفاً، وزائداً. قوله تعالى: { فإن لم يصبها وابل فطل }: الجملة شرطية؛ الشرط: «إن»؛ وفعل الشرط: { لم يصبها}؛ و{ طل } أي فهو طل - والجملة جواب الشرط؛ والمعنى: فإن لم يصبها المطر الشديد أصابها طل - وهو المطر الخفيف، ويكفيها عن المطر الكثير؛ لأنها في أرض خصبة مرتفعة بينة للشمس، والهواء؛ والمثل منطبق: فقد شبه هذا الذي ينفق ماله ابتغاء مرضات الله، وتثبيتاً من نفسه بهذه الجنة. وهل المشبه نفس الرجل أو النفقة؟ الجواب: المشبه هو النفقة؛ ولهذا قال بعضهم: إن التقدير: «مَثَل إنفاق الذين ينفقون أموالهم كمثل جنة»؛ ويحتمل أن التقدير: «كمثل صاحب جنة»؛ فيكون المشبه «المنفِق» لا «الإنفاق»؛ وقال بعضهم: لا حاجة إلى التقدير للعلم به من السياق، وأن هذا من بلاغة القرآن، حيث طوى ذكر الشيء لدلالة السياق عليه. قوله تعالى: { والله بما تعملون بصير }: قدم الجار والمجرور - وهو متعلق بـ{ بصير } - لإفادة الحصر، ومراعاة الفواصل؛ والحصر هنا إضافي للتهديد؛ لأن الله بصير بما نعمل، وبغيره. وهل { بصير } هنا من البصر بالعين؛ أو من العلم؟ الجواب: كونه من العلم أحسن ليشمل ما نعمله من الأقوال؛ فإن الأقوال تسمع، ولا تُرى؛ وليشمل ما في قلوبنا؛ فإن ما في قلوبنا لا يُسمع، ولا يُرى؛ وإنما يعلم عند الله عز وجل، كما قال تعالى: {ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه} [ق~: 16] . الفوائد: 1 - من فوائد الآية: أنه لا إنفاق نافع إلا ما كان مملوكاً للإنسان؛ لقوله تعالى: { أموالهم }؛ فلو أنفق مال غيره لم يقبل منه إلا أن يكون بإذن من الشارع، أو المالك. فإن قال قائل: عندي مال محرم لكسبه، وأريد أن أتصدق به فهل ينفعني ذلك؟ فالجواب: إن أنفقه للتقرب إلى الله به: لم ينفعه، ولم يسلم من وزر الكسب الخبيث؛ والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً»(152)؛ وإن أراد بالصدقة به التخلص منه، والبراءة من إثمه: نفعه بالسلامة من إثمه، وصار له أجر التوبة منه - لا أجر الصدقة. ولو قال قائل: عندي مال اكتسبته من ربا فهل يصح أن أبني به مسجداً، وتصح الصلاة فيه؟ فالجواب: بالنسبة لصحة الصلاة في هذا المسجد هي صحيحة بكل حال؛ وبالنسبة لثواب بناء المسجد: إن قصد التقرب إلى الله بذلك لم يقبل منه، ولم يسلم من إثمه؛ وإن قصد التخلص سلم من الإثم، وأثيب - لا ثواب باني المسجد - ولكن ثواب التائب. 2 - ومن فوائد الآية: بيان ما للنية من تأثير في قبول الأعمال؛ لقوله تعالى: { ابتغاء مرضات الله }. 3 - ومنها: اشتراط الإخلاص لقبول الأعمال؛ لقوله تعالى: { ابتغاء مرضات الله }. 4 - ومنها: أن الإنفاق لا يفيد إلا إذا كان على وفق الشريعة؛ لقوله تعالى: { ابتغاء مرضات الله }؛ وجه ذلك أن من ابتغى شيئاً فإنه لا بد أن يسلك الطريق الموصل إليه؛ ولا طريق يوصل إلى مرضات الله إلا ما كان على وفق شريعته في الكم، والنوع، والصفة؛ كما قال تعالى في الكم: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً} [الفرقان: 67] ؛ وقال تعالى في النوع: {ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام} [الحج: 34] ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله إلا الطيب»(153)؛ وفي الصفة قال الله تعالى: { كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر... } إلخ [البقرة: 264] . 5 - ومن فوائد الآية: إثبات رضا الله؛ لقوله تعالى: { مرضات الله }؛ وهو من الصفات الفعلية. 6 - ومنها: بيان أن تثبيت الإنسان لعمله، واطمئنانه به من أسباب قبوله؛ لقوله تعالى: { وتثبيتاً من أنفسهم}؛ لأن الإنسان الذي لا يعمل إلا كارهاً فيه خصلة من خصال المنافقين؛ كما قال تعالى: {ولا ينفقون إلا وهم كارهون} [التوبة: 54] . 7 - ومنها: فضل الإنفاق على وجه التثبيت من النفس؛ لأنه يندفع بدافع نفسي؛ لا بتوصية من غيره، أو نصيحة. 8 - ومنها: إثبات القياس؛ لقوله تعالى: {مثل... كمثل...} ؛ وقد ذكرنا قاعدة فيما سبق أن كل مثال في القرآن سواء كان تمثيلياً، أو إفرادياً، فهو دليل على ثبوت القياس. 9 - ومنها: أنه يحسن في التعليم أن يبين المعقول بالمحسوس؛ لقوله تعالى: { كمثل جنة بربوة }؛ وهذا من البلاغة؛ لأنه يقرب المعقول إلى أذهان الناس. 10 - ومنها: اختيار المكان الأنفع لمن أراد أن ينشئ بستاناً؛ لقوله تعالى: { كمثل جنة بربوة }. 11 - ومنها: بركة آثار المطر؛ لقوله تعالى: { فآتت أكلها ضعفين }؛ ولهذا وصف الله المطر بأنه مبارك في قوله تعالى: {ونزلنا من السماء ماءً مباركاً فأنبتنا به جنات وحب الحصيد} [ق~: 9] الآيتين. 12 - ومنها: أنه إذا كان مكان البستان طيباً فإنه يكفي فيه الماء القليل؛ لقوله تعالى: { فإن لم يصبها وابل فطل }. 13 - ومنها: إثبات علم الله، وعمومه؛ لقوله تعالى: { بما تعملون بصير }. 14 - ومنها: التحذير من مخالفة الله عز وجل؛ لكونه عالماً بما نعمل. القرآن )أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآياتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ) (البقرة:266) { 266 } قوله تعالى: { أيود أحدكم } الاستفهام هنا بمعنى النفي، كما سيتبين من آخر الآية؛ و «يود» أي يحب؛ و «الود» خالص المحبة. قوله تعالى: { أن تكون له جنة } أي بستان { من نخيل وأعناب }؛ وهذه من أفضل المأكولات؛ فالتمر حلوى، وقوت، وفاكهة؛ والعنب كذلك: حلوى، وقوت، وفاكهة؛ وظاهر كلمة «أنهار» أن الماء عذب؛ وجمع { الأنهار } باعتبار تفرقها في الجنة، وانتشارها في نواحيها؛ إذاً يعتبر هذا البستان كاملاً من كل النواحي: نخيل، وأعناب، ومياه، وثمرات؛ وهو أيضاً جنة كثيرة الأشجار، والأغصان، والزروع، وغير ذلك - هذا هو المشهد الأول من الآية. والمشهد الثاني قوله تعالى: { وأصابه الكبر } أي أصاب صاحب الجنة الكِبَر، فعجز عن تصريفها، والقيام عليها؛ { وله ذرية ضعفاء } يعني صغاراً، أو عاجزين؛ فالأب كبير؛ والذرية ضعفاء - إما لصغرهم، أو عجزهم. قوله تعالى: { فأصابها } أي أصاب هذه الجنة { إعصار } أي ريح شديدة؛ وقيل: ريح منطوية التي ينطوي بعضها على بعض؛ وهذا الإعصار { فيه نار } أي حرارة شديدة؛ مر الإعصار على هذه الجنة { فاحترقت } حتى تساقطت أوراقها، وثمراتها، ويبست أغصانها، وعروقها؛ فماذا يكون حال هذا الرجل؟! يكون في غاية ما يكون من البؤس؛ لأنه فقد هذه الجنة في حال الكبر، والذرية الضعفاء؛ فهو في نفسه لا يكتسب، وذريته لا يكتسبون له ولا لأنفسهم؛ فتكون عليه الدنيا أضيق ما يكون، ويتحسر على هذه الجنة أشد ما يكون من التحسر. هذا الأمر الذي بينه الله هنا ضربه الله مثلاً للمنفق المانّ بنفقته؛ انظر كيف يبدئ الله ويعيد في القرآن العظيم للتنفير من المن بالصدقة؛ والذي يشبه الإعصار نفس المنّ؛ فهذا الرجل تصدق بألف درهم، فهذه الصدقة تنمو له: الألف يكون بسبعمائة ألف إلى أضعاف كثيرة؛ لكنه - والعياذ بالله - منّ بهذه الصدقة، فصار هذا المنّ بمنزلة الإعصار الذي أصاب تلك الجنة الفيحاء؛ ولا يمكن أن تنزل هذه الصورة على المرائي؛ لأن المرائي لم يغرس شيئاً أصلاً. قوله تعالى: { كذلك يبين الله لكم الآيات } أي مِثل ذلك البيان؛ وهذا التعبير يرد كثيراً في القرآن، وتقديره كما سبق؛ وإذا كان هذا التقدير فإننا نقول: الكاف اسم بمعنى مثل؛ وهي منصوبة على أنها مفعول مطلق؛ وعاملها { يبين }؛ و{ الآيات } يشمل الآيات الكونية، والشرعية - يبينها الله، ويوضحها. قوله تعالى: { لعلكم تتفكرون }: «لعل» هنا للتعليل؛ و «التفكر» إعمال الفكر فيما يراد. الفوائد: 1 - من فوائد الآية: بيان تثبيت المعاني المعقولة بالأمور المحسوسة؛ لأنه أقرب إلى الفهم؛ وجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلاً للمانّ بالصدقة بصاحب هذه الجنة؛ ووجه الشبه سبقت الإشارة إليه. 2 - ومنها: جواز ضرب المثل بالقول؛ فهل يجوز ضرب المثل بالفعل - وهو ما يسمى بالتمثيل؟ الجواب: نعم، يجوز لكن بشرط ألا يشتمل على شيء محرم؛ ولنضرب لذلك أمثلة للأشياء المحرمة في التمثيل: أولاً: أن يكون فيه قيام رجل بدور امرأة، أو قيام امرأة بدور رجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال(154). ثانياً: أن يتضمن ازدراء ذوي الفضل من الصحابة، وأئمة المسلمين؛ لأن ازدراءهم واحتقارهم محرم؛ والقيام بتمثيلهم يحط من قدرهم - لا سيما إذا عُلم من حال الممثِّل أنه فاسق؛ لأن الغالب إذا كان فاسقاً وقد تقمص شخصية هذا الرجل التَّقي الذي له قدره، وفضله في الأمة، فإن هذا قد يحط من قدره بهذا الذي قام بدور في التمثيلية. ثالثاً: أن يكون فيه تقليد لأصوات الحيوانات، مثل أن يقوم بدور تمثيل الكلب، أو الحمار؛ لأن الله لم يذكر التشبيه بالحيوانات إلا في مقام الذم، كقوله تعالى: {مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار} [الجمعة: 5] ، وقوله: {واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين * ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث...} [الأعراف: 175، 176] الآيتين؛ وكذلك السنة لم تأت بالتشبيه بالحيوان إلا في مقام الذم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفاراً»(155)، وقوله: «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه»(156). رابعاً: أن يتضمن تمثيل دَور الكافر، أو الفاسق؛ بمعنى أن يكون أحد القائمين بأدوار هذه التمثيلية يمثل دَور الكافر، أو دَور الفاسق؛ لأنه يخشى أن يؤثر ذلك على قلبه: أن يتذكر يوماً من الدهر أنه قام بدور الكافر، فيؤثر على قلبه، ويدخل عليه الشيطان من هذه الناحية؛ لكن لو فعل هل يكون كافراً؟ الجواب: لا يكون كافراً؛ لأن هذا الرجل لا ينسب الكفر إلى نفسه؛ بل صور نفسه صورة من ينسبه إلى نفسه، كمن قام بتمثيل رجل طلق زوجته؛ فإن زوجة الممثل لا تطلق؛ لأنه لم ينسب الطلاق إلى نفسه؛ بل إلى غيره. وقد ظن بعض الناس أنه إذا قام بدور الكافر فإنه يكفر، ويخرج من الإسلام، ويجب عليه أن يجدد إسلامه، واستدل بالقرآن، وكلام أهل العلم؛ أما القرآن فاستدل بقوله تعالى: {ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم} [التوبة: 65، 66]: وهؤلاء القوم يدعون أنهم يخوضون، ويلعبون؛ يعني: على سبيل التسلية ليقطعوا بها عناء الطريق؛ ويقول أهل العلم: إن من أتى بكلمة الكفر - ولو مازحاً - فإنه يكفر؛ قالوا: وهذا الرجل مازح ليس جادّاً؛ فالجواب أن نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث جِدّهن جِدّ وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة»(157): فلو قال الرجل لزوجته: أنت طالق يمزح عليها فإنها تطلق؛ فهل تقولون: إذا قام الممثل بدور رجل طلق امرأته فإنها تطلق امرأته؟ سيقولون: لا؛ وكلنا يقول: لا؛ والفرق ظاهر؛ لأن المازح يضيف الفعل إلى نفسه، والممثل يضيفه إلى غيره؛ ولهذا لا تطلق زوجته لو قام بدور تمثيل المطلِّق؛ ولا يكفر لو قام بدوره تمثيل الكافر؛ لكن أرى أنه لا يجوز من ناحية أخرى؛ وهي أنه لعله يتأثر قلبه في المستقبل، حيث يتذكر أنه كان يوماً من الدهر يمثل دور الكافر؛ ثم إنه ربما يعَيَّر به فيقال مثلاً: أين أبو جهل؟! إذا قام بدوره. ويمكن أن نأتي بدليل على جواز التمثيل؛ وذلك في قصة الثلاثة من بني إسرائيل: الأقرع، والأعمى، والأبرص؛ فالملك أتى الأبرص، والأقرع، والأعمى، وسألهم ماذا يريدون؛ كل ذكر أمنيته؛ فأعطاه الله سبحانه وتعالى أمنيته؛ ثم عاد إليهم المَلَك مرة أخرى؛ عاد إلى الأبرص بصورته، وهيئته - يعني أبرص فقيراً - وقال له: «إني رجل فقير، وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري؛ فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك»(158)؛ فالملَك يمثل دور رجل فقير - وهو ليس بفقير - وأبرص - وليس بأبرص - وكذلك بالنسبة للأقرع، والأعمى؛ فبعض العلماء استدل بهذا الحديث على جواز التمثيل. فعليه نقول إذا كان التمثيل لا يشتمل على شيء محرم من الأمثلة التي ذكرناها، أو غيرها، فإنه لا بأس به، وليس من الكذب في شيء؛ لأن الكذب يضيف الإنسان الأمر إلى نفسه، فيأتي إليك يقرع الباب؛ تقول: مَن؟ يقول: أنا زيد - وليس هو بزيد؛ فهذا كاذب؛ لكن يأتي إنسان يقول: أنا أمثل دور فلان، ويعرف الناس أنه ليس فلاناً؛ فليس بكذب؛ لكنه إذا نسب القول إلى شخص معيَّن فهذا يحتاج إلى ثبوت هذا القول عن هذا الشخص المعين؛ أما إذا حكى قصة رجل بوصفه - لا بعينه - فليس بكذب. 3 - ومن فوائد الآية: أن الله سبحانه وتعالى يبين لعباده الآيات الشرعية، والكونية؛ كلها مبينة في كتابه سبحانه وتعالى أتم بيان. 4 - ومنها: الحث على التفكر، وأنه غاية مقصودة؛ لقوله تعالى: { لعلكم تتفكرون }؛ فالإنسان مأمور بالتفكر في الآيات الكونية، والشرعية؛ لأن التفكر يؤدي إلى نتائج طيبة؛ لكن هذا فيما يمكن الوصول إليه بالتفكر فيه؛ أما ما لا يمكن الوصول إليه بالتفكر فيه فإن التفكر فيه ضياع وقت، وربما يوصل إلى محظور، مثل التفكر في كيفية صفات الله عز وجل: هذا لا يجوز؛ لأنك لن تصل إلى نتيجة؛ ولهذا جاء في الأثر: «تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله»(159)؛ لأن هذا أمر لا يمكن الوصول إليه؛ وغاية لا تمكن الإحاطة بها، كما قال تعالى: {لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار} [الأنعام: 103] ؛ فلا يجوز لأحد أن يتفكر في كيفية استواء الله عز وجل على العرش؛ بل يجب الكف عنه؛ لأنه سيؤدي إلى نتيجة سيئة؛ إما إلى التكييف، أو التمثيل، أو التعطيل - ولا بد؛ وأما التفكر في معاني أسماء الله فمطلوب؛ لأن المعنى كما قال الإمام مالك - رحمه الله - لما سئل: {الرحمن على العرش استوى} [طه: 5] : كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة . |


|
|
|
#155 |
|
وسام الشرف
       |
القرآن )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلاَّ أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) (البقرة:267) { 267 } قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا }: سبق مراراً وتكراراً أن تصدير الخطاب بالنداء يدل على أهميته، والعناية به؛ لأن النداء يتضمن التنبيه؛ والتنبيه على الشيء دليل على الاهتمام به، وأن تصديره بـ{ يا أيها الذين آمنوا } يفيد عدة فوائد: أولاً: الإغراء؛ و«الإغراء» معناه الحث على قبول ما تخاطَب به؛ ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إذا قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا} فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به، أو شر ينهى عنه»(160)؛ ولهذا لو ناديتك بوصفك، وقلت: يا رجل، يا ذكي، يا كريم. معناه: يا من توصف بهذا اجعل آثار هذا الشيء بادياً عليك. ثانياً: أن امتثال ما جاء في هذا الخطاب من مقتضيات الإيمان؛ كأنه تعالى قال: { يا أيها الذين آمنوا } إن إيمانكم يدعوكم إلى كذا وكذا. ثالثاً: أن مخالفته نقص في الإيمان؛ لأنه لو حقق هذا الوصف لامتثل ما جاء في الخطاب. قوله تعالى: { أنفقوا من طيبات ما كسبتم }: بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى فيما سبق فضيلة الإنفاق ابتغاء وجهه، وسوء العاقبة لمن منَّ بصدقته، أو أنفق رياءً، حثَّ على الإنفاق؛ لكن الفرق بين ما هنا، وما سبق: أن ما هنا بيان للذي ينفَق منه؛ وهناك بيان للذي ينَفق عليه. وقوله تعالى: { من طيبات ما كسبتم } أي مما كسبتموه بطريق حلال؛ و{ كسبتم } أي ما حصلتموه بالكسب، كالذي يحصل بالبيع والشراء، والتأجير، وغيرها؛ وكل شيء حصل بعمل منك فهو من كسبك. قوله تعالى: { ومما أخرجنا لكم من الأرض }: قال بعضهم: إنه معطوف على { ما } في قوله تعالى: { ما كسبتم }؛ يعني: «ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض»؛ ولكن الصحيح الذي يظهر أنه معطوف على قوله تعالى: { طيبات }؛ يعني: «أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وأنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض»؛ لأن ما أخرج الله لنا من الأرض كله طيب ملك لنا، كما قال تعالى: { هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً } [البقرة: 29] . وقوله: { مما }: لو قلنا: إن «مِن» للتبعيض يكون المعنى: أنفقوا بعض طيبات ما كسبتم، وبعض ما أخرجنا لكم من الأرض؛ وهناك احتمال أن «مِن» لبيان الجنس؛ فيشمل ما لو أنفق الإنسان كل ماله؛ وهذا عندي أحسن؛ لأن التي للجنس تعم القليل والكثير. قوله تعالى: { أخرجنا لكم من الأرض } يشمل ما أخرج من ثمرات النخيل، والأعناب، والزروع، والفاكهة، والمعادن، وغير ذلك مما يجب أن ننفق منه. قوله تعالى: { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } أي لا تقصدوا الخبيث منه فتنفقونه؛ لأن «التيمم» في اللغة: القصد؛ ومنه قوله تعالى: {فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} [المائدة: 6] ؛ والمراد بـ{ الخبيث } هنا الرديء؛ يعني: لا تقصدوا الرديء تخرجونه، وتبقون لأنفسكم الطيب؛ فإن هذا ليس من العدل؛ ولهذا قال تعالى: { ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه }. وقوله تعالى: { منه تنفقون } يحتمل في { منه } وجهان؛ أحدهما: أنها متعلقة بـ{ الخبيث } على أنها حال؛ أي الخبيث حال كونه مما أخرجنا لكم من الأرض؛ وعلى هذا يكون في { تنفقون } ضمير محذوف؛ والتقدير: تنفقونه؛ الوجه الثاني: أنها متعلقة بقوله تعالى: { تنفقون }؛ يعني: ولا تقصدوا الخبيث تنفقون منه؛ وقدمت على عاملها للحصر؛ والوجهان من حيث المعنى لا يختلفان؛ فإن معناها أن الله ينهانا أن نقصد الخبيث - وهو الرديء - لننفق منه. قوله تعالى: { ولستم بآخذيه }: أي لستم بآخذي الرديء عن الجيد لو كان الحق لكم { إلا أن تغمضوا فيه } أي تأخذوه عن إغماض؛ و «الإغماض» أخذ الشيء على كراهيته - كأنه أغمض عينيه كراهية أن يراه. قوله تعالى: { واعلموا أن الله غني حميد }؛ فهو لم يطلب منكم الإنفاق لفقره واحتياجه؛ { حميد }: يحتمل أن تكون بمعنى حامد؛ وبمعنى محمود؛ وكلاهما صحيح؛ لأن «فعيلاً» تأتي بمعنى فاعل؛ وبمعنى مفعول؛ إتيانها بمعنى فاعل مثل: «رحيم» بمعنى راحم؛ و«سميع» بمعنى سامع؛ وإتيانها بمعنى مفعول مثل: «قتيل»، و«جريح»، و«ذبيح»، وما أشبه ذلك؛ وهنا { حميد } تصح أن تكون بمعنى حامد، وبمعنى محمود؛ أما كون الله محموداً فظاهر؛ وأما كونه حامداً فلأنه سبحانه وتعالى يَحمَد من يستحق الحمد من عباده؛ ولهذا أثنى على أنبيائه، ورسله، والصالحين من عباده؛ وهذا يدل على أنه عز وجل حامد لمن يستحق الحمد. ووجه المناسبة في ذكر «الحميد» بعد «الغني» أن غناه عز وجل غِنًى يحمد عليه؛ بخلاف غنى المخلوق؛ فقد يحمد عليه، وقد لا يحمد؛ فلا يحمد المخلوق على غناه إذا كان بخيلاً؛ وإنما يحمد إذا بذله؛ والله عز وجل غني حميد؛ فهو لم يسألكم هذا لحاجته إليه؛ ولكن لمصلحتكم أنتم. الفوائد: 1 - من فوائد الآية: فضيلة الإيمان؛ لقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا }؛ فإن هذا وصف يقتضي امتثال أمر الله؛ وهذا يدل على فضيلة الإيمان. 2 - ومنها: أن من مقتضى الإيمان امتثال أمر الله، واجتناب نهيه؛ ووجهه أن الله تعالى قال: { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا }؛ فلولا أن للإيمان تأثيراً لكان تصدير الأمر بهذا الوصف لغواً لا فائدة منه. 3 - ومنها: وجوب الإنفاق من طيبات ما كسبنا؛ لقوله تعالى: { أنفقوا }؛ والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل صارف عن الوجوب. 4 - ومنها: وجوب الزكاة في عروض التجارة؛ لقوله تعالى: { ما كسبتم }؛ ولا شك أن عروض التجارة كسب؛ فإنها كسب بالمعاملة. 5 - ومنها: أن المال الحرام لا يؤمر بالإنفاق منه؛ لأنه خبيث؛ والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. فإذا قال قائل: ماذا أصنع به إذا تبت؟ فالجواب أنه يرده على صاحبه إن أخذه بغير اختياره؛ فإن كان قد مات رده على ورثته؛ فإن لم يكن له ورثة فعلى بيت المال؛ فإن تعذر ذلك تصدق به عمن هو له؛ أما إذا أخذه باختيار صاحبه كالربا، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، فإنه لا يرده عليه؛ ولكن يتصدق به(161)؛ هذا إذا كان حين اكتسابه إياه عالماً بالتحريم؛ أما إن كان جاهلاً فإنه لا يجب عليه أن يتصدق به؛ لقوله تعالى: {فله ما سلف وأمره إلى الله} [البقرة: 275] . 6 - ومن فوائد الآية: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: { أنفقوا من طيبات ما كسبتم }؛ ووجه الدلالة: أنه لو كان الإنسان مجبراً على عمله لم يصح أن يوجه إليه الأمر بالإنفاق؛ لأنه لا يقدر على زعم هؤلاء الجبرية؛ ولأن الله أضاف الكسب إلى المخاطَب في قوله تعالى: { ما كسبتم }؛ ولو كان مجبراً عليه لم يصح أن يكون من كسبه؛ وليعلم أن مثل هذا الدليل في الرد على الجبرية كثير في القرآن، وإنما نذكره عند كل آية لينتفع بذلك من يريد إحصاء الأدلة على هؤلاء؛ وإلا فالدليل الواحد كافٍ لمن أراد الحق . 7 - ومنها: وجوب الزكاة في الخارج من الأرض؛ لقوله تعالى: { ومما أخرجنا لكم من الأرض }؛ وظاهر الآية وجوب الزكاة في الخارج من الأرض مطلقاً سواء كان قليلاً، أم كثيراً؛ وسواء كان مما يوسَّق، ويكال، أم لا؛ وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم؛ وهو أن الزكاة تجب في الخارج من الأرض مطلقاً لعموم الآية؛ ولكن الصواب ما دلت عليه السنة من أن الزكاة لا تجب إلا في شيء معين جنساً، وقدراً؛ فلا تجب الزكاة في القليل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»(162)؛ و «الوسق» هو الحِمل؛ ومقدار خمسة أوسق: ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي. ولا تجب الزكاة إلا فيما يكال؛ وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسة أوسق» ؛ و «الوسق» كما ذكرت هو الحمل؛ وهو ستون صاعاً؛ وعليه فلا تجب الزكاة في الخضراوات مثل: التفاح، والبرتقال، والأترج، وشبهها، لأن السنة بينت أنه لا بد من أن يكون ذلك الشيء مما يوسق. تــنــبــيــه: لم يبين في الآية مقدار الواجب إنفاقه من الكسب، والخارج من الأرض؛ ولكن السنة بينت أن مقدار الواجب فيما حصل من الكسب ربع العشر؛ ومقدار الواجب في الخارج من الأرض العشر فيما يسقى بلا مؤونة؛ ونصفه فيما يسقى بمؤونة. 8 - ومن فوائد الآية: ما يتبين من اختلاف التعبير في قوله تعالى: { من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض }؛ فلماذا عبر في الأول تعبيراً يدل على أن ذلك من فعل العبد؛ وفي الثاني عبر تعبيراً يدل على أنه ليس من فعل العبد؟ الأمر في ذلك واضح؛ لأن نمو التجارة بالكسب، وغالبه من فعل العبد: يبيع، ويشتري، ويكسب؛ أما ما خرج من الأرض فليس من فعل العبد في الواقع، كما قال تعالى: {أفرأيتم ما تحرثون * أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون} [الواقعة: 63، 64] . 9 - من فوائد الآية: وجوب الزكاة في المعادن؛ لدخولها في عموم قوله تعالى: { ومما أخرجنا لكم من الأرض } لكن العلماء يقولون: إن كان المعدن ذهباً أو فضة وجبت فيه الزكاة بكل حال؛ وإن كان غير ذهب، ولا فضة، كالنحاس، والرصاص، وما أشبههما ففيه الزكاة إن أعده للتجارة؛ لأن هذه المعادن لا تجب الزكاة فيها بعينها؛ إنما تجب الزكاة فيها إذا نواها للتجارة. وهل يستفاد من الآية وجوب الزكاة في الركاز - والركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية - أي مدفون الجاهلية؛ يعني ما وجد من النقود القديمة، أو غيرها التي تنسب إلى زمن بعيد بحيث يغلب على الظن أنه ليس لها أهل وقتَ وجودها؟ لا يستفاد؛ لكن السنة دلت على أن الواجب فيه الخمس(163)؛ ثم اختلف العلماء ما المراد بالخمس: هل هو الجزء المشاع - وهو واحد من خمسة؛ أو هو الخمس الذي مصرفه الفيء؟ على قولين؛ وبسط ذلك مذكور في كتب الفقه. 10 - ومن فوائد الآية: تحريم قصد الرديء في إخراج الزكاة؛ لقوله تعالى: { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}. 11 - ومنها: إذا ضمت هذه الآية إلى حديث ابن عباس حين بعث النبي معاذاً إلى اليمن، وقال: «إياك وكرائم أموالهم»(164)، تبين لك العدل في الشريعة الإسلامية؛ لأن العامل على الزكاة لو قصد الكرائم من الأموال صار في هذا إجحاف على أهل الأموال؛ ولو قصد الرديء صار فيه إجحاف على أهل الزكاة؛ فصار الواجب وسطاً؛ لا نلزم صاحب المال بإخراج الأجود؛ ولا نمكنه من إخراج الأردأ؛ بل يخرج الوسط. 12 - ومنها: الإشارة إلى قاعدة إيمانية عامة؛ وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»(165)؛ ووجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى قال: { ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه }؛ فالإنسان لا يرضى بهذا لنفسه فلماذا يرضاه لغيره؟!! فإذا كنت أنت لو أُعطيت الرديء من مال مشترك بينك وبين غيرك ما أخذته إلا على إغماض، وإغضاء عن بعض الشيء؛ فلماذا تختاره لغيرك، ولا تختاره لنفسك؟!! وهذا ينبغي للإنسان أن يتخذه قاعدة فيما يعامل به غيره؛ وهو أن يعامله بما يحب أن يعامله به؛ ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر؛ وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه»(166)، هذه قاعدة في المعاملة مع الناس؛ ومع الأسف الشديد أن كثيراً من الناس اليوم لا يتعاملون فيما بينهم على هذا الوجه؛ كثير من الناس يرى أن المكر غنيمة، وأن الكذب غنيمة. 13 - ومن فوائد الآية: إثبات القياس؛ وذلك لقوله تعالى: { ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه }؛ يعني إذا كنت لا ترضاه لنفسك فلا ترضاه لغيرك؛ أي قس هذا بهذا. 14 - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله، وما تضمناه من صفة؛ وهما «غني» و «حميد» . القرآن )الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) (البقرة:268) { 268 } قوله تعالى: { الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء }؛ { الشيطان } مبتدأ؛ وخبره جملة: { يعدكم}؛ و{ يأمركم } فيها قراءتان: الضم، والسكون؛ فأما الضم فواضح؛ لأنه فعل مضارع لم يدخل عليه ناصب، ولا جازم؛ وأما السكون فللتخفيف سماعاً لا قياساً. قوله تعالى: { والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً }: هذه الجملة مقابلة لما سبقها: الفضل ضد الفقر؛ والمغفرة ضد الفحشاء؛ لأن الفحشاء تُكسب الذنوب؛ والمغفرة تمحو الذنوب؛ ففرق بين هذا، وهذا؛ والجملة مكونة من مبتدأ، وخبر؛ المبتدأ: لفظ الجلالة: { الله }؛ والخبر: جملة: { يعدكم }. قوله تعالى: { والله واسع عليم } جملة خبرية مكونة من مبتدأ، وخبر؛ المبتدأ: لفظ الجلالة: { الله }؛ والخبر: { واسع }؛ و{ عليم } خبر ثانٍ. قوله تعالى: { الشيطان } اسم من أسماء إبليس؛ قيل: إنه مشتق من «شطن» إذا بعُد - وعلى هذا فالنون أصلية؛ وقيل: إنه مشتق من «شاط» إذا تغيظ، وغضب؛ لأن صفته هو التغيظ، والغضب، والحمق، والجهل؛ ولكن الأول أقرب: أنه من «شطن» إذا بعد؛ بدليل أنه مصروف؛ و «أل» فيه للجنس؛ فليس خاصاً بشيطان واحد. قوله تعالى: { يعدكم الفقر } أي يهددكم الفقر إذا تصدقتم؛ وقوله تعالى: { بالفحشاء } أي البخل؛ وإنما فُسِّر بالبخل؛ لأن فحش كل شيء بحسب القرينة، والسياق؛ فقد يراد به الزنى، كقوله تعالى: { ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة } [الإسراء: 32] ؛ وقد يراد به اللواط، كما في قوله تعالى عن لوط إذا قال لقومه: {أتأتون الفاحشة} [الأعراف: 80] ؛ وقد يراد به ما يستفحش من الذنوب عموماً، كقوله تعالى: {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش} [الشورى: 37] . قوله تعالى: { والله يعدكم مغفرة } أي لذنوبكم إن تصدقتم؛ { وفضلًا } أي زيادة؛ فالصدقة تزيد المال؛ لقوله تعالى: { وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون } [الروم: 39] ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «ما نقصت صدقة من مال»(167). الفوائد: 1 - من فوائد الآية: إثبات إغواء الشياطين لبني آدم؛ لقوله تعالى: { الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء}. 2 - ومنها: أن للشيطان تأثيراً على بني آدم إقداماً، أو إحجاماً؛ أما الإقدام: فيأمره بالزنى مثلاً، ويزين له حتى يُقْدم عليه؛ وأما الإحجام: فيأمره بالبخل، ويعده الفقر لو أنفق؛ وحينئذٍ يحجم عن الإنفاق. 3 - ومنها: أن أبواب التشاؤم لا يفتحها إلا الشياطين؛ لقوله تعالى: { يعدكم الفقر }؛ فالشيطان هو الذي يفتح لك باب التشاؤم يقول: «إذا أنفقت اليوم أصبحت غداً فقيراً؛ لا تنفق»؛ والإنسان بشر: ربما لا ينفق؛ ربما ينسى قول الله تعالى: {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين} [سبأ: 39] ، وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: «ما نقصت صدقة من مال» . 4 - ومنها: بيان عداوة الشيطان للإنسان؛ لأنه في الواقع عدو له في الخبر، وعدو له في الطلب؛ في الخبر: يعده الفقر؛ في الطلب: يأمره بالفحشاء؛ فهو عدو مخبراً، وطالباً - والعياذ بالله. 5 - ومنها: أن البخل من الفواحش؛ لأن المقام مقام إنفاق؛ فيكون المراد بالفاحشة: البخل، وعدم الإنفاق. 6 - ومنها: أن من أمر شخصاً بالإمساك عن الإنفاق المشروع؛ فهو شبيه بالشيطان؛ وكذلك من أمر غيره بالإسراف فالظاهر أنه شيطان؛ لقوله تعالى: {إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً} [الإسراء: 27] . 7 - ومنها: البشرى لمن أنفق بالمغفرة، والزيادة؛ لقوله تعالى: { والله يعدكم مغفرة منه وفضلًا } ؛ شتان ما بين الوعدين: { الشيطان يعدكم الفقر }؛ { والله يعدكم مغفرة منه وفضلًا }؛ فالله يعدنا بشيئين: المغفرة، والفضل؛ المغفرة للذنوب؛ والفضل لزيادة المال في بركته، ونمائه. فإن قال قائل: كيف يزيد الله تعالى المنفِق فضلاً ونحن نشاهد أن الإنفاق ينقص المال حساً؛ فإذا أنفق الإنسان من العشرة درهماً صارت تسعة؛ فما وجه الزيادة؟ فالجواب: أما بالنسبة لزيادة الأجر في الآخرة فالأمر ظاهر؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ ومن تصدق بما يعادل تمرة من طيب - ولا يقبل الله إلا الطيب - فإن الله يربيها له حتى تكون مثل الجبل؛ وأما بالنسبة للزيادة الحسية في الدنيا فمن عدة أوجه: الوجه الأول: أن الله قد يفتح للإنسان باب رزق لم يخطر له على بال؛ فيزداد ماله. الوجه الثاني: أن هذا المال ربما يقيه الله سبحانه وتعالى آفات لولا الصدقة لوقعت فيه؛ وهذا مشاهد؛ فالإنفاق يقي المال الآفات. الوجه الثالث: البركة في الإنفاق بحيث ينفق القليل، وتكون ثمرته أكثر من الكثير؛ وإذا نُزعت البركة من الإنفاق فقد ينفق الإنسان شيئاً كثيراً في أمور لا تنفعه؛ أو تضره؛ وهذا شيء مشاهد. 8 - ومنها: أن هذه المغفرة التي يعدنا الله بها مغفرة عظيمة؛ لقوله تعالى: { منه }؛ لأن عظم العطاء من عظم المعطي؛ ولهذا جاء في الحديث الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر: «فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني»(168). 9 - ومنها: أنه ينبغي للمنفق أن يتفاءل بما وعد الله؛ لقوله تعالى: { والله يعدكم مغفرة منه وفضلًا }؛ فإذا أنفق الإنسان وهو يحسن الظن بالله عز وجل أن الله يغفر له الذنوب، ويزيده من فضله كان هذا من خير ما تنطوي عليه السريرة. 10 - ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما: { واسع }، و{ عليم }؛ وما تضمناه من صفة؛ ويستفاد من الاسمين، والصفتين إثبات صفة ثالثة باجتماعهما؛ لأن الاسم من أسماء الله إذا قرن بغيره تضمن معنًى زائداً على ما إذا كان منفرداً مثل قوله تعالى: {فإن الله كان عفواً قديراً} [النساء: 149] ؛ فالجمع بين العفْوِ والقدرة لها ميزة: أن عفوه غير مشوب بعجز إطلاقاً؛ لأن بعض الناس قد يعفو لعجز؛ فقوله تعالى: { واسع عليم }: فالصفة الثالثة التي تحصل باجتماعهما: أن علمه واسع. وكل صفاته واسعة؛ وهذا مأخوذ من اسمه «الواسع»؛ فعلمه، وسمعه، وبصره، وقدرته، وكل صفاته واسعة |


|
|
|
#156 |
|
وسام الشرف
       |
القرآن
)يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الْأَلْبَابِ) (البقرة:269) التفسير: { 269 } قوله تعالى: { يؤتي الحكمة من يشاء }؛ { يؤتي } بمعنى يعطي؛ وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ، والخبر؛ فالمفعول الأول هنا: { الحكمة }؛ والمفعول الثاني: { مَن } في قوله تعالى: { من يشاء }؛ والمعنى: أن الله يعطي الحكمة من يشاء؛ و{ الحكمة } مِن أحكم بمعنى أتقن؛ وهي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها، وتستلزم علماً، ورشداً، فالجاهل لا تأتي منه الحكمة إلا مصادفة؛ والسفيه لا تأتي منه الحكمة إلا مصادفة. قوله تعالى: { ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً }، أي من يعطه الله سبحانه وتعالى الحكمة فقد أعطاه خيراً كثيراً. فإن قال قائل: ما وجه اختلاف التعبير بين قوله تعالى: { يؤتي الحكمة من يشاء }، وقوله تعالى: { ومن يؤت الحكمة }؟ فالجواب: - والله أعلم - أن الحكمة قد تكون غريزة؛ وقد تكون مكتسبة؛ بمعنى أن الإنسان قد يحصل له مع المران ومخالطة الناس من الحكمة وحسن التصرف ما لا يحصل له لو كان منعزلاً عن الناس؛ ولهذا أتى بالفعل المضارع المبني للمفعول ليعم كل طرق الحكمة التي تأتي - سواء أوتي الحكمة من قبل الله عز وجل، أو من قِبل الممارسة والتجارب؛ على أن ما يحصل من الحكمة بالممارسة والتجارب فهو من الله عز وجل؛ هو الذي قيض لك من يفتح لك أبواب الحكمة، وأبواب الخير. قوله تعالى: { وما يذكر إلا أولو الألباب }، أي ما يتعظ بآيات الله إلا أصحاب العقول الذين يتصرفون تصرفاً رشيداً. 1 - من فوائد الآية: إثبات أفعال الله المتعلقة بمشيئته؛ لقوله تعالى: { يؤتي الحكمة }؛ وهذه من الصفات الفعلية. 2 - ومنها: أن ما في الإنسان من العلم والرشد فهو فضل من الله عز وجل؛ لقوله تعالى: { يؤتي الحكمة من يشاء }؛ فإذا منّ الله سبحانه وتعالى على العبد بعلم، ورشد، وقوة، وقدرة، وسمع، وبصر فلا يترفع؛ لأن هذه الصفات من الله عز وجل؛ ولو شاء الله لحرمه إياها، أو لسلبه إياها بعد أن أعطاه إياها؛ فقد يسلب الله العلم من الإنسان بعد أن أعطاه إياه؛ وربما يسلب منه الحكمة؛ فتكون كل تصرفاته طيشاً، وضلالاً، وهدراً. 3 - ومنها: إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى؛ لقوله تعالى: { من يشاء }؛ واعلم أن كل شيء علقه الله سبحانه وتعالى بمشيئته فإنه تابع لحكمته البالغة؛ وليس لمجرد المشيئة؛ لكن قد نعلم الحكمة؛ وقد لا نعلمها؛ قال الله تعالى: {وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليماً حكيماً} [الإنسان: 30] . 4 - ومنها: إثبات الحكمة لله عز وجل؛ لأن الحكمة كمال؛ ومعطي الكمال أولى به؛ فنأخذ من الآية إثبات الحكمة لله بهذا الطريق. 5 - ومنها: الفخر العظيم لمن آتاه الله الحكمة؛ لقوله تعالى: { ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً }. 6 - ومنها: وجوب الشكر على من آتاه الله الحكمة؛ لأن هذا الخير الكثير يستوجب الشكر. 7 - ومنها: أن بلوغ الحكمة متعدد الطرق؛ فقد يكون غريزياً جبل الله العبد عليه؛ وقد يكون كسبياً يحصل بالمران، ومصاحبة الحكماء. 8 - ومنها: منّة الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده بإيتائه الحكمة؛ لقوله تعالى: { ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً }. 9 - ومنها: فضيلة العقل؛ لقوله تعالى: { وما يذكر إلا أولو الألباب }؛ لأن التذكر بلا شك يحمد عليه الإنسان؛ فإذا كان لا يقع إلا من صاحب العقل دل ذلك على فضيلة العقل؛ والعقل ليس هو الذكاء لأن العقل نتيجته حسن التصرف - وإن لم يكن الإنسان ذكياً؛ والذكاء؛ قوة الفطنة - وإن لم يكن الإنسان عاقلاً؛ ولهذا نقول: ليس كل ذكي عاقلاً، ولا كل عاقل ذكياً؛ لكن قد يجتمعان؛ وقد يرتفعان؛ وهناك عقل يسمى عقل إدراك؛ وهو الذي يتعلق به التكليف، وهذا لا يلحقه مدح، ولا ذم؛ لأنه ليس من كسب الإنسان. 10 - ومن فوائد الآية: أن عدم التذكر نقص في العقل - أي عقل الرشد؛ لقوله تعالى: { وما يذَّكر إلا أولو الألباب }؛ فإن الحكم إذا علق بوصف ازداد قوة بقوة ذلك الوصف، ونقص بنقص ذلك الوصف. 11 - ومنها: أنه لا يتعظ بالمواعظ الكونية أو الشرعية إلا أصحاب العقول الذين يتدبرون ما حصل من الآيات سابقاً، ولاحقاً؛ فيعتبرون بها؛ وأما الغافل فلا تنفعه. القرآن )وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ) (البقرة:270) { 270 } قوله تعالى: { وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر }؛ { ما } هنا شرطية؛ والدليل على أنها شرطية أنها مركبة من شرط، وجواب؛ والشرط هو: { أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر }؛ والجواب: { فإن الله يعلمه}؛ و{ مِن } زائدة زائدة؛ أي زائدة إعراباً زائدة معنًى؛ لأنها تفيد النص على العموم؛ وهي حرف جر زائد من حيث الإعراب؛ ولهذا نعرب: { نفقةٍ } على أنها مفعول به - أي: ما أنفقتم نفقةً أو نذرتم نذراً فإن الله يعلمه؛ ويجوز أن تكون بياناً لاسم الشرط { ما } في قوله تعالى: { ما أنفقتم }؛ لأن «ما» الشرطية مبهمة؛ والمبهم يحتاج إلى بيان. قوله تعالى: { فإن الله يعلمه } هذه جملة جواب الشرط؛ والفاء هنا واقعة في جواب الشرط وجوباً؛ لأنه جملة اسمية؛ وإذا وقع جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء؛ وفي ذلك يقول الناظم فيما يجب اقترانه بالفاء: (اسمية طلبية وبجامدٍ وبما وقد وبلن وبالتنفيس) قوله تعالى: { وما للظالمين من أنصار } جملة منفية؛ والمبتدأ فيها قوله تعالى: { من أنصار }؛ و{ من } فيها زائدة إعراباً زائدة معنًى؛ يعنى تزيد المعنى - وهو النص على العموم - وإن كانت في الإعراب زائدة؛ ولهذا نعرب { أنصار } على أنها مبتدأ مؤخر مرفوع بالابتداء؛ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. وقوله تعالى: { وما أنفقتم من نفقة }، أي أيّ شيء تنفقونه من قليل أو كثير فإن الله يعلمه. وقوله تعالى: { أو نذرتم من نذر }، أي أوجبتم على أنفسكم من طاعة، مثل أن يقول القائل: «لله عليّ نذر أن أتصدق بكذا»؛ أو «أن أصوم كذا»؛ { فإن الله يعلمه }؛ وذِكر العلم يستلزم أن الله يجازيهم، فلا يضيع عند الله عز وجل. قوله تعالى: { وما للظالمين } أي للمانعين ما يجب إنفاقه، أو الوفاء به من النذور { من أنصار } أي مانعين للعذاب عنهم. الفوائد: 1 - من فوائد الآية: أن الإنفاق قليله وكثيره يثاب عليه المرء؛ وذلك لقوله تعالى: { وما أنفقتم من نفقة }، وكلمة { نفقة } نكرة في سياق الشرط؛ فهي تعم؛ وعلى ذلك تشمل القليل، والكثير؛ لكن الثواب عليها مشروط بأمرين: الإخلاص لله؛ وأن تكون على وفق الشرع. 2 - ومنها: أنه ينبغي للإنسان إذا أنفق نفقة أن يحتسب الأجر على الله؛ لقوله تعالى: { فإن الله يعلمه }؛ لأنك إذا أنفقت وأنت تشعر أن الله يعلم هذا الإنفاق فسوف تحتسب الأجر على الله. 3 - ومنها: أن ما نذره الإنسان من طاعة فهو معلوم عند الله. 4 - هل تدل الآية على جواز النذر؟ الجواب: الآية لا تدل على الجواز، كما لو قال قائل مثلاً: «إن سرَقتَ فإن الله يعلم سرقتك»؛ فإن هذا لا يعني أن السرقة جائزة؛ وعلى هذا فالآية لا تعارض نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر(169)؛ لأن النهي عن النذر يعني إنشاءه ابتداءً؛ فأما الوفاء به فواجب إذا كان طاعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه»(170). 5 - ومنها: عموم علم الله بكل ما ينفقه الإنسان، أو ينذره من قليل، أو كثير. 6 - ومنها: الرد على القدرية الذين يقولون: إن الإنسان مستقل بعمله، وليس لله فيه تدخل إطلاقاً؛ وجه ذلك: أنه إذا كان الله يعلمه فلا بد أن يقع على حسب علمه؛ وإلا لزم أن يكون الله غير عالم؛ ولهذا قال بعض السلف: جادلوهم بالعلم؛ فإن أقروا به خُصِموا؛ وإن أنكروه كفروا. 7 - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى لا ينصر الظالم؛ لقوله تعالى: { وما للظالمين من أنصار }؛ ولا يرد على هذا ما وقع في أُحد من انتصار الكافرين لوجهين: الوجه الأول: أنه نوع عقوبة، حيث حصل من بعض المسلمين عصيانهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: {حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون} [آل عمران: 152]. الوجه الثاني: أن هذا الانتصار من أجل أن يمحق الله الكافرين؛ لأن انتصارهم يغريهم بمقاتلة المسلمين؛ حتى تكون العاقبة للمسلمين، كما قال تعالى: { وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين } [آل عمران: 141] . 8 - ومن فوائد الآية: أن من دعا على أخيه وهو ظالم له فإن الله لا يجيب دعاءه؛ لأنه لو أجيب لكان نصراً له؛ وقد قال تعالى: {إنه لا يفلح الظالمون} [الأنعام: 21] . 9 - ومنها: الثواب على القليل، والكثير؛ وفي القرآن ما يشهد لذلك، مثل قوله تعالى: {ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وادياً إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون} [التوبة: 121] ، وقوله تعالى في آخر سورة الزلزلة: {فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره} [الزلزلة: 7، 8] . القرآن )إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (البقرة:271) { 271 } قوله تعالى: { إن تبدوا الصدقات } أي تظهروها { فنعمَّا هي }: جملة إنشائية للمدح؛ وقُرنت بالفاء وهي جواب الشرط لكونها فعلاً جامداً { وإن تخفوها } أي تصدَّقوا سراً { وتؤتوها الفقراء } أي تعطوها المعدمين؛ وذكر { الفقراء } هنا على سبيل المثال؛ { فهو خير لكم } أي من إظهارها؛ والجملة: جواب الشرط؛ وقرنت بالفاء لكونها اسمية. قوله تعالى: { ويكفر عنكم من سيئاتكم } الجملة استئنافية؛ ولذلك كان الفعل مرفوعاً؛ و «التكفير» بمعنى السَّتر؛ { سيئاتكم } جمع سيئة؛ وهي ما يسوء المرء عمله، أو ثوابه. قوله تعالى: { والله بما تعملون خبير }، أي عليم ببواطن الأمور كظواهرها. الفوائد: 1 - من فوائد الآية: الحث على الصدقة، والترغيب فيها سواء أبداها، أو أخفاها. 2 - ومنها: أن إخفاء الصدقة أفضل من إبدائها؛ لأنه أقرب إلى الإخلاص؛ وأستر للمتصدق عليه؛ لكن إذا كان في إبدائها مصلحة ترجح على إخفائها - مثل أن يكون إبداؤها سبباً لاقتداء الناس بعضهم ببعض، أو يكون في إبدائها دفع ملامة عن المتصدق، أو غير ذلك من المصالح - فإبداؤها أفضل. 3 - ومنها: أن الصدقة لا تعتبر حتى يوصلها إلى الفقير؛ لقوله تعالى: { وتؤتوها الفقراء }. ويتفرع على هذا فرعان: أحدهما: أن مؤونة إيصالها على المتصدق. الثاني: أنه لو نوى أن يتصدق بماله، ثم بدا له ألا يتصدق فله ذلك؛ لأنه لم يصل إلى الفقير. 4 - ومنها: تفاضل الأعمال - أي أن بعض الأعمال أفضل من بعض؛ لقوله تعالى: { فهو خير لكم }؛ وتفاضل الأعمال يكون بأسباب: أ - منها التفاضل في الجنس ، كالصلاة - مثلاً - أفضل من الزكاة، وما دونها. ب - ومنها التفاضل في النوع ؛ فالواجب من الجنس أفضل من التطوع؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه»(171). ج - ومنها التفاضل باعتبار العامل لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه»(172). د - ومنها التفاضل باعتبار الزمان ، كقوله صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من ذي الحجة: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر»(173)، وكقوله تعالى: {ليلة القدر خير من ألف شهر} [القدر: 3]. هـ - ومنها التفاضل بحسب المكان ، كفضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره. و - ومنها التفاضل بحسب جودة العمل وإتقانه ، كقوله صلى الله عليه وسلم: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة؛ والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»(174). ز - ومنها التفاضل بحسب الكيفية ، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله...»، وذكر منهم: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه»(175). وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل؛ لأن الإنسان يشرف، ويفضل بعمله؛ وتفاضل الأعمال يستلزم زيادة الإيمان؛ لأن الإيمان قول، وعمل؛ فإذا تفاضلت الأعمال تفاضل الإيمان - أعني زيادة الإيمان، ونقصانه - وهو مذهب أهل السنة، والجماعة. 5 - ومن فوائد الآية: أن الصدقة سبب لتكفير السيئات؛ لقوله تعالى: { ويكفر عنكم من سيئاتكم }؛ ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل» ، ثم تلا صلى الله عليه وسلم: {تتجافى جنوبهم عن المضاجع...}(176) [السجدة: 16] . 6 - ومنها: إثبات أفعال الله الاختيارية - كما هو مذهب أهل السنة، والجماعة؛ لقوله تعالى: {ويكفر عنكم من سيئاتكم} ؛ فإن تكفير السيئات حاصل بعد العمل الذي يحصل به التكفير. 7 - ومنها: بيان آثار الذنوب، وأنها تسوء العبد؛ لقوله تعالى: { من سيئاتكم }. 8 - ومنها: إثبات اسم الله عز وجل «الخبير» ؛ وإثبات ما دل عليه من صفة. 9 - ومنها: تحذير العبد من المخالفة؛ لقوله تعالى: { والله بما تعملون خبير }؛ فإن إخباره إيانا بذلك يستلزم أن نخشى من خبرته عز وجل فلا يفقدنا حيث أمرنا، ولا يرانا حيث نهانا. القرآن )لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ) (البقرة:272) { 272 } قوله تعالى: { ليس عليك هداهم }؛ الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم؛ و{ هداهم }: الضمير يعود على بني آدم؛ والهدى المنفي هنا هدى التوفيق؛ وأما هدى البيان فهو على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك} [المائدة: 67] ؛ ولقوله تعالى: {إن عليك إلا البلاغ} [الشورى: 48] ، وقوله تعالى: {فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمسيطر} [الغاشية: 21، 22] ، وقوله تعالى: {فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب} [الرعد: 40] ... إلى آيات كثيرة تدل أن على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهدي الناس هداية الدلالة، والإرشاد؛ أما هداية التوفيق فليست على الرسول، ولا إلى الرسول؛ لا يجب عليه أن يهديهم؛ وليس بقدرته ولا استطاعته أن يهديهم؛ ولو كان بقدرته أن يهديهم لهدى عمه أبا طالب؛ ولكنه لا يستطيع ذلك؛ لأن هذا إلى الله سبحانه وتعالى وحده. قوله تعالى: { ولكن الله يهدي من يشاء }؛ وهذا كالاستدراك لما سبق؛ أي لمّا نفى كون هدايتهم على الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك إلى الله عز وجل وحده؛ فيهدي من يشاء ممن اقتضت حكمته هدايته. قوله تعالى: { وما تنفقوا من خير فلأنفسكم } أي: وليس لله عز وجل؛ فالله سبحانه وتعالى لا ينتفع به؛ بل لأنفسكم تقدمونه؛ وما لا تنفقونه فقد حرمتم أنفسكم؛ و{ ما } هذه شرطية بدليل اقتران الجواب بالفاء في قوله تعالى: { فلأنفسكم }؛ وقوله تعالى: { من خير } بيان لـ{ ما } الشرطية؛ لأن { ما } الشرطية مبهمة تحتاج إلى بيان؛ يعني: أيَّ خير تنفقونه فلأنفسكم؛ والمراد بـ «الخير» كل ما بذل لوجه الله عز وجل من عين، أو منفعة؛ وأغلب ما يكون في الأعيان. وقوله تعالى: { فلأنفسكم }: الفاء رابطة للجواب؛ والجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف؛ والتقدير: فهو لأنفسكم؛ يعني: وليس لغيركم. قوله تعالى: { وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله } يعني: لا تنفقون إنفاقاً ينفعكم إلا ما ابتغيتم به وجه الله؛ فأما ما ابتغي به سوى الله فلا ينفع صاحبه؛ بل هو خسارة عليه. وقوله تعالى: { إلا ابتغاء } أي إلا طلب؛ و{ وجه الله }: المراد به الوجه الحقيقي؛ لأن من دخل الجنة نظر إلى وجه الله. قوله تعالى: { وما تنفقوا من خير يوف إليكم }؛ { ما } هذه أيضاً شرطية بدليل جزم الجواب: { يوف }؛ فإنه مجزوم بحذف حرف العلة؛ وهو الألف؛ يعني: أيَّ خير تنفقونه من الأعيان، والمنافع قليلاً كان أو كثيراً يوف إليكم؛ أي: تعطَونه وافياً من غير نقص؛ بل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. قوله تعالى: { وأنتم لا تظلمون }، أي: لا تنقصون شيئاً منه. الفوائد: 1 - من فوائد الآية: أن هداية الخلق لا تلزم الرسل؛ ونعنى بذلك هداية التوفيق؛ أما هداية الدلالة فهي لازمة عليهم؛ لقوله تعالى: {يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته} [المائدة: 67]. 2 - ومنها: أن الإنسان إذا بلغ شريعة الله برئت ذمته؛ لقوله تعالى: { ليس عليك هداهم }؛ ولو كانت ذمته لا تبرأ لكان ملزماً بأن يهتدوا. 3 - ومنها: إثبات أن جميع الأمور دقيقها، وجليلها بيد الله؛ لقوله تعالى: { ولكن الله يهدي من يشاء }. 4 - ومنها: الرد على القدرية؛ لقوله تعالى: { ولكن الله يهدي من يشاء }؛ لأنهم يقولون: «إن العبد مستقل بعمله، ولا تعلق لمشيئة الله سبحانه وتعالى فيه». 5 - ومنها: إثبات المشيئة لله تعالى؛ لقوله تعالى: { من يشاء }. 6 - ومنها: أن هداية الخلق بمشيئة الله؛ ولكن هذه المشيئة تابعة للحكمة؛ فمن كان أهلاً لها هداه الله؛ لقوله تعالى: {الله أعلم حيث يجعل رسالته} [الأنعام: 124] ؛ ومن لم يكن أهلاً للهداية لم يهده؛ لقوله تعالى: {فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم} [الصف: 5] ، ولقوله تعالى: {إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم} [يونس: 96، 97] . |


|
|
|
#157 |
|
وسام الشرف
       |
7 - ومنها: أن أعمال الإنسان لا تنصرف إلى غيره؛ لقوله تعالى: { وما تنفقوا من خير فلأنفسكم }؛ وليس في الآية دليل على منع أن يتصدق الإنسان بعمله على غيره؛ ولكنها تبين أن ما عمله الإنسان فهو حق له؛ ولهذا جاءت السنة صريحة بجواز الصدقة عن الميت، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي قال: «يا رسول الله، إن أمي أفتلتت نفسها وأُراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم تصدق عنها»(177)؛ وكذلك حديث سعد بن عبادة حين تصدق ببستانه لأمه(178)؛ إذاً فالآية لا تدل على منع الصدقة عن الغير؛ وإنما تدل على أن ما عمله الإنسان لا يصرف إلى غيره.
8 - ومن فوائد الآية: أن الإنفاق الذي لا يُبتغى به وجه الله لا ينفع العبد؛ لقوله تعالى: { وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله }. 9 - ومنها: التنبيه على الإخلاص: أن يكون الإنسان مخلصاً لله عز وجل في كل عمله؛ حتى في الإنفاق وبذل المال ينبغي له أن يكون مخلصاً فيه؛ لقوله تعالى: { وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله }؛ فالإنفاق قد يحمل عليه محبة الظهور، ومحبة الثناء، وأن يقال: فلان كريم، وأن تتجه الأنظار إليه؛ ولكن كل هذا لا ينفع؛ إنما ينفع ما ابتغي به وجه الله. 10 - ومنها: إثبات وجه الله عز وجل؛ لقوله تعالى: { إلا ابتغاء وجه الله }؛ وأهل السنة والجماعة يقولون: إن لله سبحانه وتعالى وجهاً حقيقياً موصوفاً بالجلال والإكرام لا يماثل أوجه المخلوقين؛ وأنه من الصفات الذاتية الخبرية؛ و«الصفات الذاتية الخبرية» هي التي لم يزل، ولا يزال متصفاً بها، ونظير مسماها أبعاض وأجزاء لنا. وأهل التعطيل ينكرون أن يكون لله وجه حقيقي، ويقولون: المراد بـ «الوجه» الثواب، أو الجهة، أو نحو ذلك؛ وهذا تحريف مخالف لظاهر اللفظ، ولإجماع السلف؛ ولأن الثواب لا يوصف بالجلال والإكرام؛ والله سبحانه وتعالى وصف وجهه بالجلال والإكرام، فقال تعالى: {ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام} [الرحمن: 27] . 11 - ومنها: الإشارة إلى نظر وجه الله؛ لقوله تعالى: { إلا ابتغاء وجه الله }؛ وهذا - أعني النظر إلى وجه الله - ثابت بالكتاب، والسنة، وإجماع السلف؛ لقوله تعالى: {وجوه يومئذ ناضرة * إلى ربها ناظرة} [القيامة: 22، 23] ، وقوله تعالى: {للذين أحسنوا الحسنى وزيادة} [يونس: 26] ؛ فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم «الزيادة» بأنها النظر إلى وجه الله(179) ... إلى آيات أخرى؛ وأما السنة فقد تواترت بذلك؛ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته»(180)؛ وأما إجماع السلف فقد نقله غير واحد من أهل العلم. 12 - ومن فوائد الآية: أن الإنسان لا يُنْقص من عمله شيئاً؛ لقوله تعالى: { وما تنفقوا من خير يوف إليكم }. 13 - ومنها: الإشارة إلى أن الإنفاق من الحرام لا يقبل؛ وذلك لقوله تعالى: { من خير }؛ ووجهه: أن الحرام ليس بخير؛ بل هو شر. 14 - ومنها: نفي الظلم في جزاء الله عز وجل؛ لقوله تعالى: { وأنتم لا تظلمون }؛ وهذا يستلزم كمال عدله؛ فإن الله عز وجل كلما نفى عن نفسه شيئاً من الصفات فإنه مستلزم لكمال ضده. القرآن )لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لا يَسْأَلونَ النَّاسَ إِلْحَافاً وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ) (البقرة:273) { 273 } في هذه الآية بيان لمصرف الإنفاق؛ كأن سائلاً يسأل: إلى أين نصرف هذا الخير؟ فقال تعالى: { للفقراء... }؛ وعلى هذا فتكون { للفقراء } إما متعلقة بقوله تعالى: { تنفقوا }؛ أو بمحذوف تقديره: الإنفاق، أو الصدقات للفقراء؛ و{ الفقراء } جمع فقير؛ و «الفقير» هو المعدم؛ لأن أصل هذه الكلمة مأخوذة من «الفقر» الموافق لـ«القفر» في الاشتقاق الأكبر - الذي يتماثل فيه الحروف دون الترتيب؛ و«القفر» الأرض الخالية، كما قال الشاعر: (وقبرُ حربٍ بمكانٍ قفر وليس قربَ قبرِ حرب قبر) فـ «الفقير» معناه الخالي ذات اليد؛ ويقرن بـ«المسكين» أحياناً؛ فإذا قرن بـ«المسكين» صار لكل منهما معنى؛ وصار «الفقير» من كان خالي ذات اليد؛ أو من لا يجد من النفقة إلا أقل من النصف؛ والمسكين أحسن حالاً منه، لكن لا يجد جميع الكفاية؛ أما إذا انفرد أحدهما عن الآخر صار معناهما واحداً؛ فهو من الكلمات التي إذا اجتمعت افترقت؛ وإذا افترقت اجتمعت. قوله تعالى: { الذين أحصروا في سبيل الله } أي منعوا من الخروج من ديارهم { في سبيل الله } أي في شريعته { لا يستطيعون ضرباً في الأرض } أي لا يقدرون على السفر لقلة ذات اليد؛ أو لعجزهم عن السفر لما أصابهم من الجراح، أو الكسور، أو نحو ذلك. قوله تعالى: { يحسبهم الجاهل أغنياء } أي يظنهم الجاهل بأحوالهم أغنياء؛ وفي { يحسبهم } قراءتان: فتح السين، وكسرها؛ و{ من التعفف } أي بسبب تعففهم عن السؤال، وإظهار المسكنة؛ لأنك إذا رأيتهم ظننتهم أغنياء مع أنهم فقراء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة، واللقمتان والتمرة، والتمرتان؛ ولكن المسكين الذي لا يجد غِنًى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس»(181). قوله تعالى: { تعرفهم بسيماهم } أي تعرف أحوالهم بعلامتهم؛ والعلامة التي فيهم هي أن الإنسان إذا رآهم ظنهم أغنياء؛ وإذا دقق في حالهم تبين له أنهم فقراء؛ لكنهم متعففون؛ وكم من إنسان يأتيك بمظهر الفقير المدقع: ثياب ممزقة، وشعر منفوش، ووجه كالح، وأنين، وطنين؛ وإذا أمعنت النظر فيه عرفت أنه غني؛ وكم إنسان يأتيك بزي الغني، وبهيئة الإنسان المنتصر على نفسه الذي لا يحتاج إلى أحد؛ لكن إذا دققت في حاله علمت أنه فقير؛ وهذا يعرفه من منّ الله عليه بالفراسة؛ وكثير من الناس يعطيهم الله سبحانه وتعالى علماً بالفراسة يعلمون أحوال الإنسان بملامح وجهه، ونظراته، وكذلك بعض عباراته، كما قال الله عز وجل: {ولتعرفنهم في لحن القول} [محمد: 30] . قوله تعالى: { لا يسألون الناس إلحافاً }؛ هل النفي للقيد؛ أو للقيد والمقيد؟ إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ فإن النفي للقيد؛ أي أنهم لا يلحون في المسألة؛ ولكن يسألون؛ وإن نظرنا إلى مقتضى السياق ترجح أنهم لا يسألون الناس مطلقاً؛ فيكون النفي نفياً للقيد - وهو الإلحاف، والمقيد - وهو السؤال؛ والمعنى أنهم لا يسألون مطلقاً؛ ولو كانوا يسألون ما حسبهم الجاهل أغنياء؛ بل لظنهم فقراء بسبب سؤالهم؛ ولكنه ذكر أعلى أنواع السؤال المذموم - وهو الإلحاح؛ ولهذا تجد الإنسان إذا ألح - وإن كان فقيراً - يثقل عليك، وتمل مسألته؛ حتى ربما تأخذك العزة بالإثم ولا تعطيه؛ فتحرمه، أو تنهره مع علمك باستحقاقه؛ وتجد الإنسان الذي يظهر بمظهر الغني المتعفف ترق له، وتعطيه أكثر مما تعطي السائل. إذاً في قول الله تعالى: { الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافاً } خمس صفات؛ والسادسة أنهم فقراء؛ فهؤلاء هم المستحقون حقاً للصدقة، والإنفاق؛ وإذا تخلفت صفة من الصفات فالاستحقاق باقٍ؛ لكن ليست كما إذا تمت هذه الصفات الست. قوله تعالى: { وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم }: هذه الجملة شرطية ذيلت بها الآية المبينة لأهل الاستحقاق حثاً على الإنفاق؛ لأنه إذا كان الله عليماً بأيّ خير ننفقه فسيجازينا عليه الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. الفوائد: 1 - من فوائد الآية: أنه لا يجوز أن نعطي من يستطيع التكسب؛ لقوله تعالى: { لا يستطيعون ضرباً في الأرض }؛ لأنه عُلم منه أنهم لو كانوا يستطيعون ضرباً في الأرض، والتكسب فإنهم لا يعطون؛ ولهذا لما جاء رجلان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة صعَّد فيهما النظر وصوَّبه، ثم قال: «إن شئتما أعطيتكما؛ ولا حظ فيها لغني، ولا لقوي مكتسب»(182)؛ فإذا كان الإنسان يستطيع الضرب في الأرض والتجارة والتكسب، فإنه لا يعطى؛ لأنه وإن كان فقيراً بماله؛ لكنه ليس فقيراً بعمله. 2 - ومن فوائد الآية: فضيلة التعفف؛ لقوله تعالى: { يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف }. 3 - ومنها: التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون فطناً ذا حزم، ودقة نظر؛ لأن الله وصف هذا الذي لا يعلم عن حال هؤلاء بأنه جاهل؛ فقال تعالى: { يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف }؛ فينبغي للإنسان أن يكون ذا فطنة، وحزم، ونظر في الأمور. 4 - ومنها: إثبات الأسباب؛ لقوله تعالى: { من التعفف }؛ فإن { من } هنا سببية؛ أي بسبب تعففهم يظن الجاهل بحالهم أنهم أغنياء. 5 - ومنها: الإشارة إلى الفراسة، والفطنة؛ لقوله تعالى: { تعرفهم بسيماهم }؛ فإن السيما هي العلامة التي لا يطلع عليها إلا ذوو الفراسة؛ وكم من إنسان سليم القلب ليس عنده فراسة، ولا بُعد نظر يخدع بأدنى سبب؛ وكم من إنسان عنده قوة فراسة، وحزم، ونظر في العواقب يحميه الله سبحانه وتعالى بفراسته عن أشياء كثيرة. 6 - ومنها: الثناء على من لا يسأل الناس؛ لقوله تعالى: { لا يسألون الناس إلحافاً }؛ وقد كان من جملة ما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: ألا يسألوا الناس شيئاً؛ حتى إن الرجل ليسقط سوطه من على بعيره، فينزل، فيأخذه ولا يقول لأخيه: أعطني إياه(183)؛ كل هذا بعداً عن سؤال الناس. والسؤال - أي سؤال المال - لغير ضرورة محرم إلا إذا علمنا أن المسؤول يفرح بذلك ويُسَر؛ فإنه لا بأس به؛ بل قد يكون السائل مثاباً مأجوراً لإدخاله السرور على أخيه؛ كما لو سأل إنسان صديقاً له يعرف أنه يكون ممتناً بهذا السؤال؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي على البرمة: «هو على بريرة صدقة؛ ولنا هدية»(184). 7 - ومن فوائد الآية: بيان عموم علم الله؛ لقوله تعالى: { وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم }؛ فأيّ خير يفعله العبد فإن الله به عليم. القرآن )الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) (البقرة:274) { 274 } قوله تعالى: { الذين } مبتدأ؛ وجملة: { فلهم أجرهم } خبر المبتدأ؛ واقترنت بالفاء لمشابهة المبتدأ بالشرط في العموم؛ لأن المبتدأ هنا اسم موصول؛ واسم الموصول يشبه الشرط في العموم. قوله تعالى: { الذين ينفقون أموالهم } يحتمل أن يراد بـ «الأموال» هنا كل الأموال؛ ويحتمل أن يراد الجنس فيشمل الكل، والبعض. قوله تعالى: { بالليل والنهار }؛ الباء هنا للظرفية، وفيه عموم الزمن؛ وقوله تعالى: { سراً وعلانية } فيه عموم الأحوال؛ أي على كل حال، وفي كل زمان؛ و{ سراً } أي خفاءً؛ وهو مفعول مطلق لـ{ ينفقون }؛ يعني إنفاقاً سراً، و{ علانية } أي جهراً. قوله تعالى: { فلهم أجرهم عند ربهم } أي ثوابهم عند الله؛ وسمي أجراً؛ لأنه يشبه عقد الإجارة التي يعوَّض فيه العامل على عمله؛ وهذا الأجر قد بُين فيما سبق بأن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله: {كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء} [البقرة: 261] . قوله تعالى: { ولا خوف عليهم } أي فيما يستقبل؛ { ولا هم يحزنون } أي فيما مضى؛ فهم لا يحزنون على ما سبق؛ ولا يخافون من المستقبل؛ لأنهم يرجون ثواب الله عز وجل؛ ولا يحزنون على ما مضى؛ لأنهم أنفقوه عن طيب نفس. الفوائد: 1 - من فوائد الآية: الثناء على الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله سواء كان ليلاً، أو نهاراً، أو سراً، أو جهاراً. 2 - ومنها: كثرة ثوابهم؛ لأنه سبحانه وتعالى أضاف أجرهم إلى نفسه، فقال تعالى: { فلهم أجرهم عند ربهم}؛ والثواب عند العظيم يكون عظيماً. 3 - ومنها: أن الإنفاق يكون سبباً لشرح الصدر، وطرد الهم، والغم؛ لقوله تعالى: { لا خوف عليهم ولا هم يحزنون }؛ وهذا أمر مجرب مشاهد أن الإنسان إذا أنفق يبتغي بها وجه الله انشرح صدره، وسرت نفسه، واطمأن قلبه؛ وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد أن ذلك من أسباب انشراح الصدر. 4 - ومنها: كرم الله عز وجل حيث جعل هذا الثواب الذي سببه منه وإليه، أجراً لفاعله؛ كالأجير إذا استأجرته فإن أجره ثابت لازم. 5 - ومنها: كمال الأمن لمن أنفق في سبيل الله؛ وذلك لانتفاء الخوف، والحزن عنهم. القرآن التفسير: { 275 } قوله تعالى: { الذين } مبتدأ؛ و{ لا يقومون } خبره؛ و{ الذين يأكلون الربا } أي الذين يأخذون الربا فينتفعون به بأكل، أو شرب، أو لباس، أو سكن، أو غير ذلك؛ لكنه ذكر الأكل؛ لأنه أعم وجوه الانتفاع، وأكثرها إلحاحاً؛ و{ الربا } في اللغة: الزيادة؛ ومنه قوله تعالى: {فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت} [الحج: 5] أي زادت؛ وفي الشرع: زيادة في شيئين منع الشارع من التفاضل بينهما. قوله تعالى: { لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس }؛ اختلف المفسرون في هذا القيام، ومتى يكون؛ فقال بعضهم - وهم الأكثر: إنهم لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس؛ يعني: كالمصروع الذي يتخبطه الشيطان؛ و «التخبط» هو الضرب العشوائي؛ فالشيطان يتسلّط على ابن آدم تسلطاً عشوائياً، فيصرعه؛ فيقوم هؤلاء من قبورهم يوم القيامة كقيام المصروعين - والعياذ بالله - يشهدهم الناس كلهم؛ وهذا القول هو قول جمهور المفسرين؛ وهو مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. القول الثاني: إنهم لا يقومون عند التعامل بالربا إلا كما يقوم المصروع؛ لأنهم - والعياذ بالله - لشدة شغفهم بالربا كأنما يتصرفون تصرف المتخبط الذي لا يشعر؛ لأنهم سكارى بمحبة الربا، وسكارى بما يربحونه - وهم الخاسرون؛ فيكون القيام هنا في الدنيا؛ شبَّه تصرفاتهم العشوائية الجنونية المبنية على الربا العظيم - الذي يتضخم المال من أجل الربا - بالإنسان المصروع الذي لا يعرف كيف يتصرف؛ وهذا قول كثير من المتأخرين؛ وقالوا: إن يوم القيامة هنا ليس له ذكر؛ ولكن الله شبَّه حالهم حين طلبهم الربا بحال المصروع من سوء التصرف؛ وكلما كان الإنسان أشد فقراً كانوا له أشد ظلماً؛ فيكثرون عليه الظلم لفقره؛ بينما حاله تقتضي الرأفة، والتخفيف؛ لكن هؤلاء ظلمة ليس همهم إلا أكل أموال الناس. فاختلف المفسرون في معنى «القيام» ، ومتى يكون؛ لكنهم لم يختلفوا في قوله تعالى: { يتخبطه الشيطان من المس }؛ يعني متفقين على أن الشيطان يتخبط الإنسان؛ و{ من المس } أي بالمس بالجنون؛ وهذا أمر مشاهد: أن الشيطان يصرع بني آدم؛ وربما يقتله - نسأل الله العافية -؛ يصرعه، ويبدأ يتخبط، ويتكلم، والإنسان نفسه لا يتكلم - يتكلم الشيطان الذي صرعه. |


|
|
|
#158 |
|
وسام الشرف
       |
قوله تعالى: { ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا }: المشار إليه قيامهم كقيام المصروع؛ { بأنهم قالوا... } إلخ: الباء للسببية؛ يعني أنهم عُمّي عليهم الفرق بين البيع، والربا؛ أو أنهم كابروا فألحقوا الربا بالبيع؛ ولذلك عكسوا التشبيه، فقالوا: إنما البيع مثل الربا، ولم يقولوا: «إنما الربا مثل البيع»، كما هو مقتضى الحال.
قوله تعالى: { وأحل الله البيع وحرم الربا } أي أباح البيع، ومنع الربا؛ وهذا رد لقولهم: { إنما البيع مثل الربا}؛ فأبطل الله هذه الشبهة بما ذكر. قوله تعالى: { فمن جاءه موعظة من ربه } أي من بلغه حكم الربا بعد أن تعامل به { فانتهى } أي كف عن الربا بالتوبة منه { فله ما سلف }، أي ما أخذه من الربا قبل العلم بالحكم. قوله تعالى: { وأمره إلى الله } أي شأنه إلى الله - تبارك وتعالى - في الآخرة؛ { ومن عاد } أي ومن رجع إلى الربا بعد أن أتته الموعظة { فأولئك }: أتى باسم الإشارة الدال على البعد؛ وذلك لسفوله - أي هوى بعيداً؛ { أصحاب النار } أي أهلها الملازمون لها؛ وأكد ذلك بقوله تعالى: { هم فيها خالدون }. الفوائد: 1 - من فوائد الآية: التحذير من الربا، حيث شبه آكله بمن يتخبطه الشيطان من المس. 2 - ومنها: أن من تعامل بالربا فإنه يصاب بالنهمة العظيمة في طلبه. 3 - ومنها: أن الشيطان يتخبط بني آدم فيصرعه؛ ولا عبرة بقول من أنكر ذلك من المعتزلة، وغيرهم؛ وقد جاءت السنة بإثبات ذلك؛ والواقع شاهد به؛ وقد قسم ابن القيم - رحمه الله - في زاد المعاد الصرع إلى قسمين: صرع بتشنج الأعصاب؛ وهذا يدركه الأطباء، ويقرونه، ويعالجونه بما عندهم من الأدوية، والثاني: صرع من الشيطان؛ وذلك لا علم للأطباء به؛ ولا يعالج إلا بالأدوية الشرعية كقراءة القرآن، والأدعية النبوية الواردة في ذلك. 4 - ومن فوائد الآية: بيان علة قيام المرابين كقيام الذي يتخبطه الشيطان من المس؛ وهي: { أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا } يعني: فإذا كان مثله فلا حرج علينا في طلبه. 5 - ومنها: مبالغة أهل الباطل في ترويج باطلهم؛ لأنهم جعلوا المقيس هو المقيس عليه؛ لقولهم: { إنما البيع مثل الربا }؛ وكان مقتضى الحال أن يقولوا: إنما الربا مثل البيع. 6 - ومنها: أن الحكم لله - تبارك وتعالى - وحده؛ فما أحله فهو حلال؛ وما حرمه فهو حرام سواء علمنا الحكمة في ذلك، أم لم نعلم؛ لأنه تعالى رد قولهم: { إنما البيع مثل الربا } بقوله تعالى: { وأحل الله البيع وحرم الربا }؛ فكأنه قال: ليس الأمر إليكم؛ وإنما هو إلى الله. 7 - ومنها: أن بين الربا والبيع فرقاً أوجب اختلافهما في الحكم؛ فإنا نعلم أن الله تعالى لا يفرق بين شيئين في الحكم إلا وبينهما فرق في العلة، والسبب المقتضي لاختلافهما؛ لقوله تعالى: {أليس الله بأحكم الحاكمين} [التين: 8] ، وقوله تعالى: {ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون} [المائدة: 50] . 8 - ومنها: أن ما أخذه الإنسان من الربا قبل العلم فهو حلال له بشرط أن يتوب، وينتهي؛ لقوله تعالى: { فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف }. 9 - ومنها: أنه لو تاب من الربا قبل أن يقبضه فإنه يجب إسقاطه؛ لقوله تعالى: { فانتهى }؛ ومن أخذه بعد العلم فإنه لم ينته؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة في حجة الوداع: «ألا وإن ربا الجاهلية موضوع؛ وأول رباً أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله»(185)؛ فبين صلى الله عليه وسلم أن ما لم يؤخذ من الربا فإنه موضوع. 10 - ومنها: رأفة الله تعالى بمن شاء من عباده؛ لقوله تعالى: { فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى }؛ وهذه ربوبية خاصة تستلزم توفيق العبد للتوبة حتى ينتهي عما حرم الله عليه. 11 - ومنها: التحذير من الرجوع إلى الربا بعد الموعظة؛ لقوله تعالى: { ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون }. 12 - ومنها: التخويف من التفاؤل البعيد لمن تاب من الربا؛ لأنه تعالى قال: { فله ما سلف وأمره إلى الله }؛ يعني أن الإنسان يتفاءل، ويؤمل؛ لأن الأمر قد لا يكون على حسب تفاؤله. 13 - ومنها: بيان عظم الربا؛ لقوله تعالى: { ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون }. القرآن )يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) (البقرة:276) { 276 } قوله تعالى: { يمحق الله الربا }؛ «المحق» بمعنى الإزالة؛ أي يزيل الربا؛ والإزالة يحتمل أن تكون إزالة حسية، أو إزالة معنوية، فالإزالة الحسية: أن يسلط الله على مال المرابي ما يتلفه؛ والمعنوية : أن يَنزع منه البركة. قوله تعالى: { ويربي الصدقات } أي يزيدها: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. قوله تعالى: { والله لا يحب كل كفار أثيم }؛ إذا نفى الله تعالى المحبة فالمراد إثبات ضدها - وهي الكراهة؛ و «الكَفّار» كثير الكفر، أو عظيم الكفر؛ و «الأثيم» بمعنى الآثم، كالسميع بمعنى السامع، والبصير بمعنى الباصر، وما أشبه ذلك. الفوائد: 1 - من فوائد الآية: محق الربا: إما حساً، وإما معنًى، كما سبق. 2 - ومنها: التحذير من الربا، وسد أبواب الطمع أمام المرابين. 3 - ومنها: أن الله يرْبي الصدقات - أي يزيدها؛ والزيادة إما أن تكون حسية؛ وإما أن تكون معنوية؛ فإن كانت حسية فبالكمية، مثل أن ينفق عشرة، فيخلف الله عليه عشرين؛ وأما المعنوية فأن يُنْزل الله البركة في ماله. 4 - ومنها: مقابلة الضد بالضد؛ فكما أن الربا يُمحَق، ويزال؛ فالصدقة تزيد المال، وتنميه؛ لأن الربا ظلم، والصدقة إحسان. 5 - ومنها: إثبات المحبة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: { والله لا يحب كل كفار أثيم }؛ ووجه الدلالة أن نفي المحبة عن الموصوف بالكفر، والإثم يدل على إثباتها لمن لم يتصف بذلك - أي لمن كان مؤمناً مطيعاً؛ ولولا ذلك لكان نفي المحبة عن «الكفار الأثيم» لغواً من القول لا فائدة منه؛ ولهذا استدل الشافعي - رحمه الله -بقوله تعالى: {كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون} [المطففين: 15] على أن الأبرار يرون الله عز وجل؛ لأنه لما حجب الفجار عن رؤيته في حال الغضب دل على ثبوتها للأبرار في حال الرضا؛ وهذا استدلال خفي جيد؛ والمحبة الثابتة لله عز وجل هي محبة حقيقية تليق بجلاله، وعظمته؛ وليست - كما قال أهل التعطيل - إرادة الثواب، أو الثواب؛ لأن إرادة الثواب ناشئة عن المحبة؛ وليست هي المحبة؛ وهذه القاعدة - أعني إجراء النصوص على ظاهرها في باب صفات الله - اتفق عليها علماء السلف، وأهل السنة والجماعة؛ لأن ما يتحدث الله به عن نفسه أمور غيبية يجب علينا الاقتصار فيها على ما ورد. القرآن )إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) (البقرة:277) { 277 } قوله تعالى: { إن الذين آمنوا } أي آمنوا بقلوبهم بما يجب الإيمان به؛ { وعملوا الصالحات } أي عملوا الأعمال الصالحات؛ وهي المبنية على الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ { وأقاموا الصلاة } أي أتوا بها قويمة بشروطها، وأركانها، وواجباتها، ومكملاتها؛ وعطْفها على العمل الصالح من باب عطف الخاص على العام؛ لأن إقامة الصلاة من الأعمال الصالحة، ونُص عليها لأهميتها؛ { وآتوا الزكاة } أي أعطوا الزكاة مستحقها؛ وعلى هذا فتكون { الزكاة } مفعولاً أولاً بـ{ آتوا }؛ والمفعول الثاني محذوف - أي آتوا الزكاة مستحقها؛ و «الزكاة» هي النصيب الذي أوجبه الله عز وجل في الأموال الزكوية؛ وهو معروف في كتب الفقه. قوله تعالى: { لهم أجرهم عند ربهم } أي لهم ثوابهم عند الله؛ والجملة هذه خبر { إن } في قوله تعالى: { إن الذين آمنوا... }. قوله تعالى: { ولا خوف عليهم } أي فيما يستقبل من أمرهم؛ { ولا هم يحزنون } أي فيما مضى من أمرهم. الفوائد: 1 - من فوائد الآية: الحث على الإيمان، والعمل الصالح؛ لأن ذكر الثواب يستلزم التشجيع، والحث، والإغراء. 2 - ومنها: أنه لابد مع الإيمان من العمل الصالح؛ فمجرد الإيمان لا ينفع العبد حتى يقوم بواجبه - أي واجب الإيمان: وهو العمل الصالح. 3 - ومنها: أن العمل لا يفيد حتى يكون صالحاً؛ والصلاح أن ينبني العمل على أمرين: الإخلاص لله عز وجل - وضده الشرك؛ والمتابعة - وضدها البدعة؛ فمن أخلص لله في شيء، ولكنه أتى بعمل مبتدع لم يقبل منه؛ ومن أتى بعمل مشروع لكن خلطه بالشرك لم يقبل منه؛ وأدلة هذا معروفة. 4 - ومنها: بيان أهمية إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة. 5 - ومنها: أن هذين الركنين - أعني إقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة - أعلى أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ للنص عليهما من بين سائر الأعمال الصالحة. 6 - ومنها: أن الله سبحانه وتعالى ضمن الأجر لمن آمن، وعمل صالحاً، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة؛ لقوله تعالى: { لهم أجرهم عند ربهم }. 7 - ومنها: الإشارة إلى عظمة هذا الثواب؛ لأنه أضافه إلى نفسه - تبارك وتعالى - والمضاف إلى العظيم يكون عظيماً. 8 - ومنها: أن هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات الأربع - الإيمان، والعمل الصالح، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة - ليس عليهم خوف من مستقبل أمرهم؛ ولا حزن فيما مضى من أمرهم؛ لأنهم فعلوا ما به الأمن التام، كما قال الله تعالى: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون} [الأنعام: 82] . القرآن )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) (البقرة:278) { 278 } قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا }: الجملة ندائية؛ فائدتها: تنبيه المخاطب. قوله تعالى: { اتقوا الله } أي اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره، واجتناب نواهيه. قوله تعالى: { وذروا ما بقي من الربا } أي اتركوا ما بقي من الربا. قوله تعالى: { إن كنتم مؤمنين }: هذا من باب الإغراء، والحث على الامتثال؛ يعني: إن كنتم مؤمنين حقاً فدعوا ما بقي من الربا؛ وهذه الجملة يقصد بها الإغراء، والإثارة - أعني إثارة الهمة. فإن قلت: كيف يوجِّه الخطاب للمؤمنين، ويقول: { إن كنتم مؤمنين }؛ أفلا يكون في هذا تناقض؟ فالجواب: ليس هنا تناقض؛ لأن معنى الثانية التحدي؛ أي إن كنتم صادقين في إيمانكم فاتقوا الله، وذروا ما بقي من الربا. الفوائد: 1 - من فوائد الآية: بلوغ القرآن أكمل البلاغة؛ لأن الكلام في القرآن يأتي دائماً مطابقاً لمقتضى الحال؛ فإذا كان الشيء مهماً أحاطه بالكلمات التي تجعل النفوس قابلة له؛ وهذا أكمل ما يكون من البلاغة. 2 - ومنها: أنه إذا كان الشيء هاماً فإنه ينبغي أن يصَدَّر بما يفيد التنبيه من نداء، أو غيره. 3 - ومنها: وجوب تقوى الله، لقوله تعالى: { اتقوا الله }؛ و «التقوى» وصية الله لعباده الأولين، والآخرين؛ قال الله تعالى: {ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله} [النساء: 131] . 4 - ومنها: وجوب ترك الربا - وإن كان قد تم العقد عليه؛ لقوله تعالى: { وذروا ما بقي من الربا }؛ وهذا في عقد استوفي بعضه، وبقي بعضه. 5 - ومنها: أنه لا يجوز تنفيذ العقود المحرمة في الإسلام - وإن عقدت في حال الشرك؛ لعموم قوله تعالى: { وذروا ما بقي من الربا }، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في عرفة عام حجة الوداع: «وربا الجاهلية موضوع؛ وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله»(186)؛ ولكن يجب أن نعلم أن العقود التي مضت في الكفر على وجه باطل، وزال سبب البطلان قبل الإسلام فإنها تبقى على ما كانت عليه؛ مثال ذلك: لو تبايع رجلان حال كفرهما بيعاً محرماً في الإسلام، ثم أسلما فالعقد يبقى بحاله؛ ومثال آخر: لو تزوج الكافر امرأة في عدتها، ثم أسلما بعد انقضاء عدتها فالنكاح باق؛ ولهذا أمثلة كثيرة. 6 - ومن فوائد الآية: تحريم أخذ ما يسمى بالفوائد من البنوك؛ لقوله تعالى: { وذروا ما بقي من الربا }؛ وزعم بعض الناس أن الفوائد من البنوك تؤخذ لئلا يستعين بها على الربا؛ وإذا كان البنك بنك كفار فلئلا يستعين بها على الكفر؛ فنقول: أأنتم أعلم أم الله!!! وقد قال الله تعالى: { ذروا ما بقي من الربا }؛ والاستحسان في مقابلة النص باطل. فإن قال قائل: إذا كان البنك بنكاً غير إسلامي، ولو تركناه لهم صرفوه إلى الكنائس، وإلى السلاح الذي يقاتَل به المسلمون، أو أبقوه عندهم، ونما به رباهم؛ فنقول: إننا مخاطبون بشيء، فالواجب علينا أن نقوم بما خوطبنا به؛ والنتائج ليست إلينا؛ ثم إننا نقول: هذه الفائدة التي يسمونها فائدة هل هي قد دخلت في أموالنا حتى نقول: إننا أخرجنا من أموالنا ما يستعين به أعداؤنا على كفرهم، أو قتالنا؟ والجواب: أن الأمر ليس كذلك؛ فإن هذه الزيادة التي يسمونها فائدة ليست نماءَ أموالنا؛ فلم تدخل في ملكنا؛ ثم إننا نقول له: إذا أخذته فأين تصرفه؟ قال: أصرفه في صدقة؛ في إصلاح طرق؛ في بناء مساجد تخلصاً منه، أو تقرباً به؛ نقول له: إن فعلت ذلك تقرباً لم يقبل منك، ولم تسلم من إثمه؛ لأنك صرفته في هذه الحال على أنه ملكك؛ وإذا صرفته على أنه ملكك لم يقبل منك؛ لأنه صدقة من مال خبيث؛ ومن اكتسب مالاً خبيثاً فتصدق به لم يقبل منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً»(187)؛ وإن أخرجته تخلصاً منه فأي فائدة من أن تلطخ مالك بالخبيث، ثم تحاول التخلص منه؛ ثم نقول أيضاً: هل كل إنسان يضمن من نفسه أن يخرج هذا تخلصاً منه؟! فربما إذا رأى الزيادة الكبيرة تغلبه نفسه، ولا يخرجها؛ أيضاً إذا أخذت الربا، وقال الناس: إن فلاناً أخذ هذه الأموال التي يسمونها الفائدة؛ أفلا تخشى أن يقتدي الناس بك؟! لأنه ليس كل إنسان يعلم أنك سوف تخرج هذا المال، وتتخلص منه. ولهذا أرى أنه لا يجوز أخذ شيء من الربا مطلقاً؛ لقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا }؛ ولم يوجه العباد إلى شيء آخر |


|
|
|
#159 |
|
وسام الشرف
       |
8 - ومن فوائد الآية: أن ممارسة الربا تنافي الإيمان؛ لقوله تعالى: { إن كنتم مؤمنين }؛ ولكن هل يُخرج الإنسانَ من الإيمان إلى الكفر؟ مذهب الخوارج أنه يخرجه من الإيمان إلى الكفر؛ فهو عند الخوارج كافر، كفرعون، وهامان، وقارون؛ لأنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب؛ ومذهب أهل السنة والجماعة أنه مؤمن ناقص الإيمان؛ لكنه يُخشى عليه من الكفر لا سيما آكل الربا؛ لأنه غذي بحرام؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام: «فأنى يستجاب لذلك»(188) - نسأل الله العافية.
9 - ومن فوائد الآية: رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث حرم عليهم ما يتضمن الظلم؛ وأكد هذا التحريم، وأنزل القرآن فيه بلفظ يحمل على ترك هذا المحرم؛ لقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا }، وقوله تعالى: { اتقوا الله }، وقوله تعالى: { إن كنتم مؤمنين }؛ والحكم: { ذروا ما بقي من الربا }. القرآن )فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) (البقرة:279) { 279 } قوله تعالى: { فإن لم تفعلوا } يعني: فإن لم تتركوا ما بقي من ربا؛ { فأذنوا } بالقصر وفتح الذال، بمعنى أعلنوا؛ وفي قراءة { فآذنوا } بالمد، وكسر الذال؛ والمعنى: أن من لم ينته عن الربا فقد أعلن الحرب على الله ورسوله. قوله تعالى: { وإن تبتم } أي رجعتم إلى الله سبحانه وتعالى من معصيته إلى طاعته؛ وذلك هنا بترك الربا؛ والتوبة من الربا، كالتوبة من غيره - لابد فيها من توافر الشروط الخمسة المعروفة. قوله تعالى: { فلكم رؤوس أموالكم }؛ { رؤوس } جمع رأس؛ و «الرأس» هنا بمعنى الأصل؛ أي لكم أصول الأموال؛ وأما الربا فليس لكم، ثم علل الله عز وجل هذا الحكم بقوله تعالى: { لا تظلمون }؛ لأنكم لم تأخذوا الزيادة؛ { ولا تُظلمون }؛ لأنها لم تنقص رؤوس أموالكم. الفوائد: 1 - من فوائد الآية: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: { فإن لم تفعلوا }؛ لأن الجبرية يقولون: إن الإنسان لا يستطيع الفعل، ولا الترك؛ لأنه مجبر؛ وحقيقة قولهم تعطيل الأمر والنهي؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن يفعل ما أمر به، ولا ترك ما نهي عنه. 2 - ومنها: أن المصِرّ على الربا معلن الحرب على الله ورسوله؛ لقوله تعالى: { فأذنوا بحرب من الله ورسوله }. ويتفرع على هذه الفائدة أنه إذا كان معلناً الحرب على الله، ورسوله فهو معلن الحرب على أولياء الله، ورسوله - وهم المؤمنون؛ وذلك بدلالة الالتزام؛ لأن كل مؤمن يجب أن ينتصر لله، ورسوله؛ فالمؤمنون هم حزب الله عز وجل ورسوله. 3 - ومن فوائد الآية: عظم الربا لعظم عقوبته؛ وإنما كان بهذه المثابة ردعاً لمتعاطيه عن الاستمرار فيه؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه جاء في الوعيد على الربا ما لم يأت على ذنب دون الشرك؛ ولهذا جاء في الحديث الذي طرقه متعددة: «إن الربا ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن يأتي الرجل أمه»(189)؛ وهذا كلٌّ يستبشعه؛ فالربا ليس بالأمر الهين؛ والمؤمن ترتعد فرائصه إذا سمع مثل هذه الآية. 4 - ومنها: أنه يجب على كل من تاب إلى الله عز وجل من الربا ألا يأخذ شيئاً مما استفاده من الربا؛ لقوله تعالى: { وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم }. 5 - ومنها: أنه لا يجوز أخذ ما زاد على رأس المال من الربا لأيّ غرض كان؛ سواء أخذه ليتصدق به، أو ليصرفه في وجوه البر تخلصاً منه، أو لغير ذلك؛ لأن الله أمر بتركه؛ ولو كان هنا طريق يمكن صرفه فيه لبينه الله عز وجل. 6 - ومنها: الإشارة إلى الحكمة من تحريم الربا - وهي الظلم؛ لقوله تعالى: { لا تظلمون ولا تظلمون }. فإن قال قائل: إن بعض صور الربا ليس فيه ظلم، مثل أن يشتري صاعاً من البر الجيد بصاعين من الرديء يساويانه في القيمة؛ فإنه لا ظلم في هذه الصورة؛ قلنا: إن العلة إذا كانت منتشرة لا يمكن ضبطها فإن الحكم لا ينتقض بفقدها؛ ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي إليه بتمر جيد فسأل: «من أين هذا؟ فقال بلال: تمر كان عندنا رديّ فبعت منه صاعين بصاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوَّه أوَّه! عين الربا عين الربا لا تفعل»(190)؛ ثم أرشدهم إلى أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم؛ ويشتروا بالدراهم تمراً جيداً؛ فدل هذا على أن تخلف الظلم في بعض صور الربا لا يخرجه عن الحكم العام للربا؛ لأن هذه العلة منتشرة لا يمكن ضبطها؛ ولهذا أمثلة كثيرة؛ ودائماً نجد في كلام أهل العلم أن العلة إذا كانت منتشرة غير منضبطة فإن الحكم يعم، ولا ينظر للعلة. 7 - ومن فوائد الآية: إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى: { ورسوله }. 8 - ومنها: رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، حيث أرسل إليهم الرسل؛ لأن العقول لا يمكن أن تستقل بمعرفة ما ينفعها، ويضرها على وجه التفصيل لقصورها؛ إنما تعرفه على سبيل الجملة؛ لقوله تعالى: {وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً} [الإسراء: 85] ؛ فمن أجل ذلك أرسل الله الرسل؛ فكان في هذا رحمة عظيمة للخلق. 9 - ومنها: مراعاة العدل في معاملة الناس بعضهم مع بعض؛ لقوله تعالى: { فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون }. القرآن )وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة:280) { 280 } قوله تعالى: { وإن كان ذو عسرة } { كان } تامة تكتفي بمرفوعها؛ و{ ذو } فاعل رفعت بالواو؛ لأنها من الأسماء الستة؛ والجملة شرطية؛ والجواب: جملة: { فنظرة إلى ميسرة }. قوله تعالى: { إن كنتم تعلمون } جملة شرطية نقول في إعرابها ما سبق في قوله تعالى: { إن كنتم مؤمنين }. أما القراءات في هذه الآية: قوله تعالى: { ميسرة } فيها قراءتان: { ميسَرة } بفتح السين؛ و{ ميسُرة } بضمها؛ و{ تصدقوا } فيها قراءتان: { تصَدَّقوا } بتخفيف الصاد؛ و{ تَصَّدَّقوا } بتشديدها؛ أي تتصدقوا؛ لكن أدغمت التاء في الصاد. قوله تعالى: { وإن كان ذو عسرة } أي إن وجِد ذو عسرة؛ أي صاحب إعسار لا يستطيع الوفاء؛ والجملة شرطية؛ وجواب الشرط قوله تعالى: { فنظرة إلى ميسرة }؛ ويجوز في «نظرة» في إعرابها وجهان؛ أحدهما: أن تكون مبتدأ، والخبر محذوف؛ والتقدير: فعليكم نظرة؛ أو فله نظرة؛ وأما أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف؛ والتقدير: فالواجب عليه نظرة؛ أي إنظار إلى ميسرة؛ أي: إيسار. قوله تعالى: { وأن تصدقوا خير لكم } أي تُبرءوا المعسر في دينه؛ و{ أن } وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ خبره قوله تعالى: { خير لكم } أي من إنظاره. قوله تعالى: { إن كنتم تعلمون } هذه الجملة الشرطية مستقلة يراد بها الحث على العلم؛ «مستقلة» أي أنها لا توصل بما قبلها؛ لأنها لو وصلت بما قبلها لأوهم معنًى فاسداً: أوهم أن التصدق خير لنا إن كنا نعلم؛ فإن لم نكن نعلم فليس خيراً لنا؛ ولا شك أن هذا معنًى فاسد لا يراد بالآية؛ لكن المعنى: إن كنتم من ذوي العلم فافعلوا - أي تصدقوا. الفوائد: 1 - من فوائد الآية: ثبوت رحمة الله عز وجل؛ وجه ذلك أنه أوجب على الدائن إنظار المدين؛ وهذا رحمة بالمعسر. 2 - ومنها: حكمة الله عز وجل بانقسام الناس إلى موسر، ومعسر؛ الموسر في الآية: الدائن؛ والمعسر: المدين؛ وحكمة الله عز وجل هذه لا يمكن أن تستقيم أمور العباد إلا بها، ولذلك بدأ الشيوعيون - الذين يريدون أن يساووا بين الناس - يتراجعون الآن؛ لأنهم عرفوا أنه لا يمكن أن يصلح العباد إلا هذا الخلاف؛ قال عز وجل: {أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً} [الزخرف: 32] ؛ ولولا هذا الاختلاف لم يمكن أن يسخر لنا أحد ليعمل ما نريد؛ لأن كل واحد ندّ للآخر؛ فلا يمكن إصلاح الخلق إلا بما تقتضيه حكمة الله عز وجل، وشرعه من التفاوت بينهم: فهذا موسر؛ وهذا فقير؛ حتى يتبين بذلك حكمة الله عز وجل، وتقوم أحوال العباد. 3 - ومن فوائد الآية: وجوب إنظار المعسر - أي إمهاله حتى يوسر؛ لقوله تعالى: { فنظرة إلى ميسرة }؛ فلا تجوز مطالبته بالدَّين؛ ولا طلب الدَّين منه. 4 - ومنها: أن الحكم يدور مع علته وجوداً، وعدماً؛ لأنه لما كان وجوب الإنظار معللًا بالإعسار صار مستمراً إلى أن تزول العلة - وهي العسرة - حتى تجوز مطالبته. ولو أن الناس مشوا على تقوى الله عز وجل في هذا الباب لسلمت أحوال الناس من المشاكل؛ لكن نجد الغني يماطل: يأتيه صاحب الحق يقول: اقضني حقي؛ فيقول: غداً؛ ويأتيه غداً فيقول: بعد غد؛ وهكذا؛ وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مطل الغني ظلم»(191)؛ ونجد أولئك القوم الأشحاء ذوي الطمع لا يُنظرون المعسر، ولا يرحمونه؛ يقول له: أعطني؛ وإلا فالحبس؛ ويحبس فعلاً - وإن كان لا يجوز حبسه إذا تيقنا أنه معسر، ولا مطالبته، ولا طلب الدين؛ بل يعزر الدائن إذا ألح عليه في الطلب وهو معسر؛ لأن طلبه مع الإعسار معصية؛ والتعزير عند أهل العلم واجب في كل معصية لا حدّ فيها، ولا كفارة. 5 - ومن فوائد الآية: فضيلة الإبراء من الدَّين، وأنه صدقة؛ لقوله تعالى: { وأن تصدقوا خير لكم }؛ والإبراء سنة؛ والإنظار واجب؛ وهنا السنة أفضل من الواجب بنص القرآن؛ لقوله تعالى: { وأن تصدقوا خير لكم }؛ ووجه ذلك أن الواجب ينتظم في السنة؛ لأن إبراء المعسر من الدَّين إنظار، وزيادة؛ وعلى هذا فيبطل إلغاز من ألغز بهذه المسألة، وقال: «لنا سنة أفضل من الواجب»، ومثل ذلك قول بعضهم في الوضوء ثلاثاً: «إنه أفضل من الوضوء واحدة مع أن الواحدة واجب، والثلاث سنة»؛ فيُلغِز بذلك، ويقول: «هنا سنة أفضل من واجب»؛ فيقال له: هذا إلغاز باطل؛ لأن هذه السنة مشتملة على الواجب؛ فهي واجب، وزيادة؛ وصدق الله، حيث قال في الحديث القدسي: «ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضت عليه»(192)؛ وهذا الحديث يبطل مثل هذه الألغاز التافهة. 6 - ومن فوائد الآية: تفاضل الأعمال؛ لقوله تعالى: { وأن تصدقوا خير لكم }؛ وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العامل، وأن العاملين بعضهم أفضل من بعض؛ وهذا أمر معلوم بالضرورة الشرعية والعقلية أن العمال يختلفون، كما قال تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم} [النساء: 95] ، وكما قال تعالى: {لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلًا وعد الله الحسنى} [الحديد: 10] . ويتفرع على تفاضل العمال بتفاضل الأعمال: تفاضل الإيمان، لأن الأعمال من الإيمان عند أهل السنة، والجماعة؛ فإذا تفاضلت لزم من ذلك تفاضل الإيمان؛ ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. 7 - ومن فوائد الآية: فضيلة العلم، وأن العلم يهدي صاحبه إلى الخير؛ لقوله تعالى: { إن كنتم تعلمون }. 8 - وهل يستفاد من الآية الكريمة: أن إبراء الغريم يجزئ من الزكاة: فلو أن إنساناً أبرأ فقيراً، ثم قال: أبرأته عن زكاتي؛ لأن الله سمى الزكاة صدقة؛ فقال تعالى: { إنما الصدقات للفقراء والمساكين... }؟ فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجزئ؛ لأن الله عز وجل قال: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه} [البقرة: 267] ؛ وجعْل الدَّين زكاة للعين هذا من تيمم الخبيث لإخراجه عن الطيب؛ والمراد بالخبيث هنا الرديء - وليس الحرام؛ لأن العين مُلك قائم بيد المالك يتصرف فيه كيف يشاء؛ والدَّين الذي على معسر مال تالف؛ لأن الأصل بقاء الإعسار؛ وحينئذٍ يكون هذا الدَّين بمنزلة المال التالف؛ فلا يصح أن يجعل هذا المال التالف زكاة عن العين؛ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن إبراء الغريم المعسر لا يجزئ من الزكاة بلا نزاع؛ ولو قلنا: يجزئ لكان كل إنسان له غرماء لا يستطيعون الوفاء يقول: أبرأتكم ونويتها من الزكاة؛ فتبقى الأموال عنده، والديون التالفة الهالكة التي لا يرجى حصولها تكون هي الزكاة؛ وهذا لا يجوز؛ ولهذا لو خيرت شخصاً، وقلت له: أنا أعطيك عشرة ريالات نقداً، أو أحولك على إنسان فقير معسر عنده العشرة فإنه يختار العشرة نقداً؛ ولا يتردد؛ بل لو خيرته بين عشرة نقداً، وعشرين في ذمة معسر لاختار العشرة؛ فصارت العشرة المنقودة بالنسبة للدَّين من باب الطيب؛ وذاك من باب الرديء؛ وبهذا يتبين أنه لا يجزئ إبراء المدين المعسر عن زكاة مال بيد مالكه؛ لأنه من باب تيمم الخبيث؛ إذاً نقول: لا يجوز إبراء الفقير، واحتساب ذلك من الزكاة؛ نعم لو فرض أنه سيجعلها زكاة عن الدَّين الذي في ذمة المعسر - إذا قلنا بوجوب الزكاة في الدَّين - لكان ذلك مجزئاً؛ لأن هذا صار من جنس المال الذي أديت الزكاة عنه. |


|
|
|
#160 |
|
وسام الشرف
       |
الخلاصة:
تبين مما ذكر من الآيتين أن المعاملة بالدَّين ثلاثة أقسام: الأول: أن يأخذ به رباً؛ وهذا محرم؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا إن كنتم مؤمنين} [البقرة: 278] . الثاني: أن يكون المدين معسراً؛ فلا تجوز مطالبته، ولا طلب الدّين منه حتى يوسر؛ لقوله تعالى: { وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة }. الثالث: أن يبرئ المعسر من دينه؛ وهذا أعلى الأقسام؛ لقوله تعالى: { وأن تصدقوا خير لكم }. تتمة: في هذه الآية وجوب الإنظار إلى ميسرة؛ ومن المعلوم أن حصول الميسرة مجهول؛ وهذا لا يضر؛ لأنه ليس من باب المعاوضة؛ ولكن لو اشترى فقير من شخص، وجعل الوفاء مقيداً بالميسرة فهل يجوز ذلك؟ فيه قولان؛ فأكثر العلماء على عدم الجواز لأن الأجل مجهول؛ فيكون من باب الغرر المنهي عنه؛ والقول الثاني: أن ذلك جائز لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: «قدم لفلان اليهودي بزّ من الشأم لو أرسلت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة؛ فأرسل إليه فامتنع»(193)؛ ولأن هذا مقتضى العقد إذا علم البائع بإعسار المشتري؛ إذ لا يحلّ له حينئذٍ أن يطلب منه الثمن حتى يوسر؛ وهذا القول هو الراجح. القرآن )وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) (البقرة:281) { 281 } قوله تعالى: { واتقوا يوماً } أي اتقوا عذاب يوم؛ أي احذروه؛ والمراد به يوم القيامة؛ لقوله تعالى: { ترجعون فيه إلى الله }؛ وعلى هذا تكون { يوماً } منصوبة على المفعولية؛ لأن الفعل وقع عليها - لا فيها. قوله تعالى: { ترجعون } صفة لـ { يوماً }؛ لأنه نكرة؛ والجمل بعد النكرات صفات؛ وهي بضم التاء، وفتح الجيم على أنه مبني لما لم يسم فاعله؛ وفي قراءة بفتح التاء، وكسر الجيم على أنه مبني للفاعل. قوله تعالى: { ثم توفى كل نفس } أي تعطى؛ والتوفية بمعنى الاستيفاء؛ وهو أخذ الحق ممن هو عليه؛ فـ { توفى كل نفس } أي تعطى ثوابها، وأجرها المكتوب لها - إن كان عملها صالحاً؛ أو تعطى العقاب على عملها - إن كان عملها سيئاً. قوله تعالى: { ما كسبت } أي ما حصلت عليه من ثواب الحسنات، وعقوبة السيئات. قوله تعالى: { وهم لا يظلمون } جملة استئنافية؛ ويحتمل أن تكون جملة حالية؛ لكن الأول أظهر؛ والمعنى: لا ينقصون شيئاً من ثواب الحسنات،ولا يزاد عليهم شيئاً من عقوبة السيئات. الفوائد: 1 - من فوائد الآية: وجوب اتقاء هذا اليوم الذي هو يوم القيامة؛ لقوله تعالى: { واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله }؛ واتقاؤه يكون بفعل أوامر الله، واجتناب نواهيه. 2 - ومنها: أن التقوى قد تضاف لغير الله - لكن إذا لم تكن على وجه العبادة؛ فيقال: اتق فلاناً، أو: اتق كذا؛ وهذا في القرآن والسنة كثير؛ قال الله سبحانه وتعالى: {واتقوا الله لعلكم تفلحون * واتقوا النار التي أعدت للكافرين} [آل عمران: 130، 131] ؛ لكن فرق بين التقويين؛ التقوى الأولى تقوى عبادة، وتذلل، وخضوع؛ والثانية تقوى وقاية فقط: يأخذ ما يتقي به عذاب هذا اليوم، أو عذاب النار؛ وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اتق دعوة المظلوم»(194)؛ فأضاف «التقوى» هنا إلى «دعوة المظلوم» ؛ واشتهر بين الناس: اتق شر من أحسنت إليه؛ لكن هذه التقوى المضافة إلى المخلوق ليست تقوى العبادة الخاصة بالله عز وجل؛ بل هي بمعنى الحذر. 3 - ومن فوائد الآية: إثبات البعث؛ لقوله تعالى: {ترجعون فيه إلى الله} . 4 - ومنها: أن مرجع الخلائق كلها إلى الله حكماً، وتقديراً، وجزاءً؛ فالمرجع كله إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: {وأن إلى ربك المنتهى} [النجم: 42] ، وقال تعالى: {إن إلى ربك الرجعى} [العلق: 8] ، أي في كل شيء. 5 - ومنها: إثبات قدرة الله عز وجل؛ وذلك بالبعث؛ فإن الله سبحانه وتعالى يبعث الخلائق بعد أن كانوا رميماً، وتراباً. 6 - ومنها: الرد على الجبرية؛ لقوله تعالى: { واتقوا يوماً }؛ لأن توجيه الأمر إلى العبد إذا كان مجبراً من تكليف ما لا يطاق. 7 - ومنها: أن الإنسان لا يوفى يوم القيامة إلا عمله؛ لقوله تعالى: { ثم توفى كل نفس ما كسبت }؛ واستدل بعض العلماء على أنه لا يجوز إهداء القرب من الإنسان إلى غيره؛ أي أنك لو عملت عملاً صالحاً لشخص معين؛ فإن ذلك لا ينفعه، ولا يستفيد منه؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: { توفى كل نفس ما كسبت }؛ لا ما كسب غيرها؛ فما كسبه غيره فهو له؛ واستثني من ذلك ما دلت السنة على الانتفاع به من الغير كالصوم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»(195)؛ والحج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي استفتته أن تحج عن أبيها وكان شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة قالت: أفأحج عنه قال: «نعم»(196)؛ وكذلك المرأة التي استفتته أن تحج عن أمها التي نذرت أن تحج، ولم تحج حتى ماتت قالت: أفأحج عنها قال صلى الله عليه وسلم: «نعم»(197)؛ وكذلك الصدقة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن استفتاه أن يتصدق عن أمه: «نعم»(198)؛ وأذن لسعد بن عبادة أن يتصدق بمخرافه عن أمه(199)؛ وأما الدعاء للغير إذا كان المدعو له مسلماً فإنه ينتفع به بالنص، والإجماع؛ أما النص ففي الكتاب، والسنة؛ أما الكتاب ففي قوله تعالى: {والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} [الحشر: 10] ؛ وأما السنة ففي قوله صلى الله عليه وسلم: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه»(200)، وكان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، وقال: «استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يُسأل»(201)؛ وأما الإجماع: فإن المسلمين كلهم يصلون على الأموات، ويقولون في الصلاة: «اللهم اغفر له، وارحمه»؛ فهم مجمعون على أنه ينتفع بذلك. والخلاف في انتفاع الميت بالعمل الصالح من غيره فيما عدا ما جاءت به السنة معروف؛ وقد ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن أيّ قربة فعلها، وجعل ثوابها لميت مسلم قريب، أو بعيد نفعه ذلك؛ ومع هذا فالدعاء للميت أفضل من إهداء القرب إليه؛ لأنه الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»(202)؛ ولم يذكر العمل مع أن الحديث في سياق العمل. وأما ما استدل به المانعون من إهداء القرب من مثل قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 3] فإنه لا يدل على المنع؛ بل على أن سعي الإنسان ثابت له؛ وليس له من سعي غيره شيء إلا أن يجعل ذلك له؛ ونظير هذا أن تقول: «ليس لك إلا مالك»، فإنه لا يمنع أن يقبل ما تبرع به غيره من المال. وأما الاقتصار على ما ورد فيقال: إن ما وردت قضايا أعيان؛ لو كانت أقوالاً من الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا: نعم، نتقيد بها؛ لكنها قضايا أعيان: جاءوا يسألون قالوا: فعلت كذا، قال: نعم، يجزئ؛ وهذا مما يدل على أن العمل الصالح من الغير يصل إلى من أُهدي له؛ لأننا لا ندري لو جاء رجل وقال: يا رسول الله، صليت ركعتين لأمي، أو لأبي، أو لأخي أفيجزئ ذلك عنه، أو يصل إليه ثوابه لا ندري ماذا يكون الجواب؛ ونتوقع أن يكون الجواب: «نعم»؛ أما لو كانت هذه أقوال بأن قال: «من تصدق لأمه أو لأبيه فإنه ينفعه»، أو ما أشبه ذلك لقلنا: إن هذا قول، ونقتصر عليه. 8 - ومن فوائد الآية: أن الصغير يكتب له الثواب؛ وذلك لعموم قوله تعالى: { ثم توفى كل نفس }. فإن قال قائل: وهل يعاقب على السيئات. فالجواب: «لا»؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة...» ، وذكر منها: «الصغير حتى يحتلم»(203)؛ ولأنه ليس له قصد تام لعدم رشده؛ فيشبه البالغ إذا أخطأ، أو نسي. القرآن )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةَ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (البقرة:282) هذه الآية الكريمة أطول آية في كتاب الله؛ وهي في المعاملات بين الخلق؛ وأقصر آية في كتاب الله قوله تعالى: {ثم نظر} [المدثر: 21] ؛ لأنها خمسة أحرف؛ وأجمع آية للحروف الهجائية كلها آيتان في القرآن فقط؛ إحداهما: قوله تعالى: {ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً} [آل عمران: 154] الآية؛ والثانية قوله تعالى: {محمد رسول الله والذين معه...} [الفتح: 29] الآية؛ فقد اشتملت كل واحدة منهما على جميع الحروف الهجائية. { 282 } قوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا }؛ سبق الكلام على مثل هذه العبارة. قوله تعالى: { إذا تداينتم بدين } أي إذا داين بعضكم بعضاً؛ و «الدين» كل ما ثبت في الذمة من ثمن بيع، أو أجرة، أو صداق، أو قرض، أو غير ذلك. قوله تعالى: { إلى أجل مسمى } أي إلى مدة محدودة { فاكتبوه } أي اكتبوا الدين المؤجل إلى أجله؛ والفاء هنا رابطة لجواب الشرط في { إذا }. قوله تعالى: { وليكتب } أللام للأمر؛ وسكنت لوقوعها بعد الواو؛ وهي تسكن إذا وقعت بعد الواو، كما هنا؛ وبعد «ثم». والفاء، كما في قوله تعالى: {ثم ليقطع فلينظر} [الحج: 15] بخلاف لام التعليل؛ فإنها مكسورة بكل حال؛ و{ بينكم } أي في قضيتكم؛ و{ كاتب } نكرة يشمل أيّ كاتب؛ { بالعدل } أي بالاستقامة - وهو ضد الجور؛ والمراد به ما طابق الشرع؛ وهو متعلق بقوله تعالى: { ليكتب }. |


|
 |
| مواقع النشر (المفضلة) |
|
|
 المواضيع المتشابهه
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| سورة البقره كامله مكتوبه | لناالله | دراسات وأبحاث علم الرُقى والتمائم . الإدارة العلمية والبحوث Studies and science research spells and | 8 | 15 Jun 2012 01:59 PM |
| حلمي بعد قراءة سورة البقره | انا الورد | تعطير الأنام في تأويل الرؤى والأحلام - تفسير ابن الورد الحسني | 1 | 12 Dec 2010 08:41 PM |
| عاجل وضروري (اقرأ سورة البقره) | ام منار | تعطير الأنام في تأويل الرؤى والأحلام - تفسير ابن الورد الحسني | 1 | 25 Jul 2007 02:39 PM |
| فضل سورة البقره مع شرح للايتان (الاولى والثانيه) | ابرهيم الرفاعى | منهج السلف الصالح . The Salafi Curriculum | 0 | 21 Mar 2007 05:40 PM |
![]()